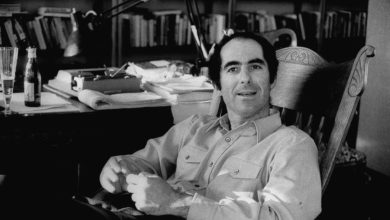الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي: المغرب استضاف والدي المضطهد وفتح لعائلتي المتشردة أبوابه واسعة
دوستويفسكي العظيم أثر في حياتي بصفة بالغة العمق، مصيغا في جزء كبير نظرتي للإنسان والسياسة والدين والمجتمع.
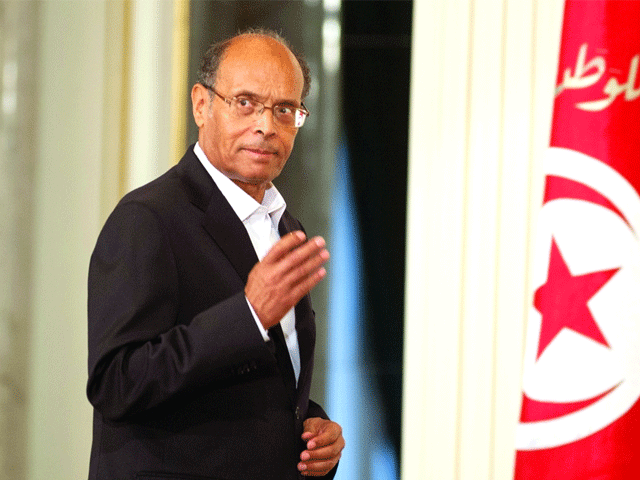
لوسات أنفو
حاوره: حمزة الضيفي
- كيف أسست في مدرسة الصادقية حركة سياسية وأنت لا زلت طفلا؟
أسست أول حركة سياسية تناضل ضد البورقيبية التي أصبحت مقاومتها مسألة ثأر شخصي. كان حزبي يتألف مني أنا الزعيم الأوحد، ومن طفلين في الثالثة عشر من العمر مثلي هما يوسف الصديق وعبد الحق شريط، ولم يكن من الغريب أن يكونا من الجنوب ومن أفقر التلاميذ بحكم قانون: إن الطيور على أشباهها تقع وكانت حركتي هذه متطرفة، منتصرة لروسيا ضد أمريكا، تنادي بالوحدة العربية التامة والشاملة والفورية وترفض باشمئزاز شديد فكرة الأمة التونسية، ولا تقبل بفكرة الوحدة المغاربية إلا كخطوة أولى نحو الوحدة الكاملة وتخطط لغزو إسرائيل ومحوها بالقنابل الذرية وتتبادل كل يوم أخبار صوت العرب من القاهرة، وتدرس ظروف التسلل للجزائر للمشاركة في الحرب وقهر الاستعمار والإمبريالية، و تسمي بورقيبة باسمه وبأسماء قبيحة، أما لقب سيادة الرئيس، فكان يعني آليا بطل العروبة جمال عبد الناصر لا غير (وقد بقيت وطنيته ونظافته تغفران إلى اليوم أخطاءه دون أن تبررها خاصة حكم المخابرات والتعذيب الوحشي في السجون المصرية) .
وللأسف الشديد فإن هذه الحركة الواعدة لم تلبث أن دخلت في انقسامات وصراعات داخلية عصفت بها حيث انقسمت لا على الأفكار والمبادئ وإنما كما هو الأمر عادة على موضوع الزعامة. وآثر يوسف الصديق الانسحاب من المعركة ليتفرغ للتفكير الفلسفي الذي لم يغادره منذ ذلك اليوم. وبقيت المعركة على أشدها بيني وبين عبد الحق شريط الذي انهزم سريعا –ثم دخل بعدها الحزب الدستوري – وهكذا بقيت زعيما بدون منافس في حزب بدون أتباع وأنصار. وفي السادسة عشر من عمري انتهت فترة الصادقية.
- في هذه الفترة قرر والدك أن تلتحق به إلى المغرب، كيف كان شعورك وأنت تغادر تونس؟
خلال عام 1961 اقتنع الوالد بأنه لن يتمكن من العودة مجددا إلى تونس، لأن بورقيبة صفى جميع خصومه اليوسفيين بعد اغتيال الزعيم صالح بين يوسف، وبالتالي طلب من العائلة القدوم إلى المغرب، ومن تم الاستقرار فيه بشكل نهائي.
هكذا غادرنا تونس بفرح وفي القلب لوعة لا تتحمل مواساة. كان الفرح ناجما عن خلاصنا من وضع أصبح غير قابل للتحمل. فقد كانت دارنا تعرف بدار الخائن وكان والدي الذي قدم كل شبابه لاستقلال الوطن منعوتا بالأصابع في أحاديث الناس. وكان الفقر المدقع الذي كنا نعيش فيه جزءا من كابوس دام سنوات. أما اللوعة فكانت تتعلق بكل ما كنا نفقده بالهجرة: الأحباب والعائلة وخاصة بالنسبة لي المدرسة الحبيبة التي لم تكن تفرق بين أبناء ”الخونة” مثلي وأبناء الوطنيين الذين كان لبعضهم باعا طويلا في العمل مع الاستعمار ثم أصبحوا من أعيان البلاد غداة الاستقلال.
- هل تأقلمت العائلة في المغرب؟
بين 1961 و1964 عشت مع العائلة المهاجرة في مدينة طنجة في جو جديد علينا من اليسر المادي والأمان النفسي وطيلة هذه السنوات تعلمت حب المغرب والمغاربة. فقد استضاف البلد أبي المضطهد وفتح لعائلتي المشردة أبوابه واسعة. وهو إلى يوم يبعثون بلدي الثاني في حين هو البلد الأول لأخوتي الذين ولدوا من أم مغربية وعاشوا فيه دون انقطاع.
- ماهي التيارات الفكرية التي تأثرت بها خلال مرحلة شبابك؟
كنت متأثر بالقومية العربية، صورة جمال عبد الناصر كانت لا تفارق غرفتي. كنت أعتبر نفسي ناصريا. لم نكن نعلم آنذاك عن الخروقات في حقوق الإنسان التي سادت فترة حكمه، فالصورة التي كانت تروج آنذاك لجمال عبد الناصر هي أنه وقف في وجه إسرائيل.
- حدثنا عن دراستك بالمغرب؟
تلقيت تعليمي في مدرسة البعثة الفرنسية ليسيه رينيو بطنجة مدة ثلاث سنوات وفيها حصلت على البكالوريا، وقد أصر والدي عند وصولنا طنجة على دخولي المدرسة الفرنسية وعارضته في هذا أشد المعارضة. فكيف يمكن لقومي عربي متشدد آنذاك أن يدخل ثانوية استعمارية ويترك مدرسة عربية. والحقيقة أنه كان بي خشية مبهمة أن يكون مستواي في الفرنسية أضعف من المطلوب فيصاب كبريائي بصدمة لا يتحملها. ورفض والدي كل حججي بعلة ضعف مستوى التعليم في المدارس المغربية آنذاك. وحيث أن موازين القوى كانت لصالح الدكتاتورية الأبوية، فإنني دخلت الثانوية الفرنسية أقدم رجلا وأؤخر أخرى.
كان أول لقاء لي مع عالم جديد وحضارة جديدة. ولم يكن من السهل التأقلم مع هذا الجو الغريب خاصة وان اختلاط الجنسين فاجأ مراهقا خجولا ووضع أمامه لأول مرة إشكاليات لم يتمرن عليها في الصادقية.
مما أذكره أنني كنت أترقّب يوم إرجاع أول فرض في الإنشاء الفرنسية ببالغ الخوف لثقتي المطلقة أنني سأكون الأخير إذ من أين لي أن أنافس الفرنسيين في الكتابة بلغتهم الأم. ولما بدأت الأستاذة بإعطاء الأعداد تسارعت دقات القلب. وكان من عادة هذه الأستاذة أن تبدأ بالأصفار الرنانة وأن تتدرج ببطء متلف للأعصاب إلى الأعداد التي يفاخر بها الناس. وكدت أرقص طربا لأن صاحب الواحد على عشرين كان فرنسيا من أصفى القوم وكذلك صاحب الاثنين.
إذن لقد أنقذ الشرف التونسي والعربي من وصمة عار فأنا لست الأخير ولا حتى ما قبل الأخير. وعندما وصلت الأستاذة إلى المعدل أسقط في يدي وقد اتضحت لي الحقيقة الرهيبة: إن الفرض من الرداءة بمكان جعلت المرأة ترفض إصلاحه وتتأهب لدعوتي بعد نهاية الحصة لتطلب مني أن أبحث لي عن عمل يدوي لأن المجتمع بحاجة إلى العمل اليدوي الشريف. وعندما وصلت الأستاذة إلى مشارف الأعداد الضخمة، كنت قد أتممت إعداد وسائل الدفاع أمام مجلس تأديب المدرسة الذي كنت أتصور قرب مثولي أمامه وأمام أب كان يفاخر بي دوما في ظهري ويبدي معي من الشدة ما يقصم الظهر. وهو ما كان يجعلني اسميه الدكتاتور الأكبر مع العلم أنني كنت أسميه في أوقات الصفاء بصدق ممزوج بشيء من الفكاهة ”أين في الناس أب مثل أبي.”
وأخيرا وصلت الأستاذة إلى الفرض الأخير، تلوح به في وجه التلاميذ كأنها تهددهم به: هكذا تكون الكتابة فاستمعوا جيدا. تعال يا مرزوقي لقراءة هذا النص الرائع الذي أهنئك عليه. ومن يومها لم يسخر الفرنسيون والمتفرنسون من لهجتي ومن يومها بقي ”منصب” الأول في الفرنسية موقعا لي لا يهدده غريم إلا وعاد مكللا بالعار والشنار كما كان الأمر في الصادقية.
وفي السنة الموالية قدمتني المدرسة لمسابقة (Le concours général) وتقع بين أحسن تلامذة المعاهد الفرنسية ويفاخر بنتائجها رؤساؤها. ودخلت المسابقة لا أعلم أن نتيجتها ستغير مجرى حياتي. وتحصلت على الجائزة في مادة النقل والترجمة باللغتين وعليه سافرت إلى فرنسا لأتسلم جائزة مباراة التفوق من جامعة السوربون وأنا في السابعة عشر، لأتلقى من يدي وزير التعليم جبلا من الكتب و إناءا صينيا بالغ الجمال من البرسلين الفاخر، وهو ما مهد لحصولي بعدها على منحة من الحكومة الفرنسية للدراسة في جامعة ستراسبورغ حيث سجلت في كلية علم النفس ثم الطب.
- إلى من يعود الفضل في تفوقك الدراسي؟
يعود الفضل في هذا بالطبع للقراءة المكثفة التي كانت ولا تزال، مع الموسيقى، أطيب طيبات الحياة بالنسبة لي. ففي الخامسة عشر كنت قد التهمت تقريبا كل ما كان متوفرا من كتابات العقاد والمنفلوطي وتيمور وجبران وطه حسين ودوواين كبار شعراء الأمة. وبالفرنسية ”التهمت” قبل دخولي الجامعة كل المتوفر من مسرحيات موليار وراسين وكورناي وشعر بودلار وبريفار وكتب ألكسندر ديما وزولا وبلزاك. وكنت جد مشغوف بالأدب الروسي وكان تولستوي لزمن طويل كاتبي المفضل لا يفارقني كتابه ”الحرب والسلام” وهو من بين الكتب التي أعدت قراءتها على مر العقود أكثر من عشر مرات، لا أمل منه مثلما لا أملّ من سماع موسيقى ”باخ”. لكن الكاتب الذي أثر في حياتي بصفة بالغة العمق مصيغا في جزء كبير نظرتي للإنسان والسياسة والدين والمجتمع هو دوستويفسكي العظيم.
- ما الدوافع التي أدت بك إلى اختيار دراسة الطب بفرنسا؟ والتخصص في طب الأعصاب؟
كانت لي أخت حامل في الثانية والعشرين من العمر لفظت آخر أنفاسها على متن شاحنة نقل ريفية بين دوز وقابس لأنه ليس في دوز مستشفى لائق يحفظ حياة امرأة جاءها نزيف حاد إبان ولادة صعبة، لم تتحمل المسكينة الآلام وتوفيت رحمها الله، وتركت بنتين. بسبب هذه الواقعة التي أثرت في، اخترت دراسة الطب وتخصصت في الطب الاجتماعي لمصلحة الفقراء وسكان البوادي والقرى بتونس.
أما عن سبب اختيار طب الأعصاب وبالتحديد مرض الصرع الذي كتبت فيه العديد من المقالات العلمية ودرسته سنوات كأستاذ في كليتي تونس وسوسة، فقد كان وليد شغفي الشديد بشخصيات دوستويفسكي الغريبة المثيرة، ومنها الأمير مويشكين الذي كان مصابا بالصرع مثلما كان مصابا به الكاتب الكبير. وأذكر أنني إبان تدريسي للمرض كنت استشهد بالوصف الدقيق للنوبات التي تحفل بها روايات دوستويفسكي فأواجه باستغراب طلبة تعلموا منذ نعومة أظافرهم اعتبار الأدب ”كلام فارغ” يترك للراسبين في الحسابيات وللبنات. وما من شك أن أكبر مصائب التعليم في بلادنا هو هذه الأجيال التي لا تتقن أيا من اللغتين ولا تعرف للأدب قيمة دون أن تكون متمكنة من المنهجية العلمية الصارمة.
- على ذكر العمل كأستاذ للطب في تونس، متى عدت من فرنسا؟
سنة 1979 أخذت قراري النهائي بالعودة للوطن رغم إلحاح زوجتي الفرنسية وعائلتها بالبقاء في بلد يوفر كل ما يمكن أن يطمح له المرء. ولم يكن الخيار سهلا لأنني كنت أعلم ما الذي ينتظرني في تونس. لكني عشت طوال هذه السنوات بقناعة أنني لا أتعلم لحسابي الخاص. فثمة آمال الوالد العريضة وثم حلي الوالدة التي بيعت لكي لا يتوقف بي الركب. وثمة ذكرى موجعة لأختي التي توفيت، هكذا حزمت حقائبي لبلاد جارت علي وهي دوما عزيزة، وقوم ضنوا علي وهم دوما كرام.
- كيف وجدت المناخ السياسي والأكاديمي في عهد بورقيبة عندما عدت؟
لقد بدا لي واضحا أن رداءة العمل، غير مرتبطة بخلل وراثي وإلا لما نجحت في عملي في ستراسبورغ مثل كثيرين من العرب الذين أبلوا البلاء الحسن في بلدان الهجرة، وإنما يتعلق المرض بالمعطى الثقافي الناتج بدوره عن تنظيم سياسي متخلف، يضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب ويكافئ الموالي وليس الكفء ويحارب العقل المجدد فيجدب الخصب ويشل الطاقات ويكبل الفكر ويشيع الإحباط والغضب ثم للامبالاة والتسيب. والغريب في الأمر أنني لم أفهم قيمة الديمقراطية ولم ”أعتنقها ” إلا عند رجوعي إلى تونس. ففي فرنسا كانت الصبغة العروبية الاشتراكية هي الغالبة على تفكيري ولم أكن أرى في النظام السياسي الذي كنت أعيش في كنفه سوى الفضائح والإشهار الرخيص والصراعات السياسوية إلخ.
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. كانت الليلة الظلماء، فقدي لبدر الحرية واكتشافي لما نسيت وتناسيت من موبقات وغباء نظام الشخصانية والحزب الواحد والإعلام السفيه والانتخابات المزيفة وقمع المخالف في الرأي واستشراء المحسوبية والانتهازية والرداءة في كل مواقع القرار، لأن القاعدة في هذا النظام الولاء قبل الكفاءة. وفي قسم الأعصاب عهد إلي رئيس القسم بالعيادات الخارجية وهناك اكتشفت عمق الفقر والجهل لشرائح واسعة من شعبنا خاصة تلك التي كانت تأتي من القصرين وتالة وجندوبة ومدنين وأحيانا تبيت أمام المستشفى ليتلقاها طبيب عابس متهجم يحكم في دقائق معدودات على حالة ميؤوس منه.
لا شك أنني رأيت أمي الفقيرة في كل نساء الشعب ورأيت أختي التي ماتت على شاحنة نقل ريفية في كل المرضى وفي كل طفل معاق ابنة أخت أخرى تقول الشعر وتهديني لواعجها عبر قصائد بسيطة تدمع لها العينان ويدمى لها القلب. وهكذا استعصت العلاقة ”الطبيعية” بين الطبيب والمريض من تباعد ومهنية باردة إذ أصبحت كل حالة مسألة شخصية فانقلبت حياتي جحيما لا يطاق إذ من أين لي حل مشاكل بمثل هذا العدد وهذا التعقيد وهذه الخطورة.
وفي هذا الظرف بالضبط وصلت تقاطع طريق مصيري، هو الذي أدى إلى بقية التطورات.
- هل مارست نشاطا مدنيا أو سياسيا خلال عودتك؟
عندما عدت إلى تونس، انطلقت مسيرتي السياسية من خلال الانخراط في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكان دخولي لها في سنة 1980 بمجرد الصدفة أو هكذا خيل لي، فقد جاءني صديق يطلب مني الانخراط فسألته عن هذه الجمعية التي كنت أعجب ببلاغاتها التي تصدر في جريدة ”الرأي” فشرح لي نشأتها وأهدافها فلم أتردد في دفع معلوم الاشتراك ونسيت الموضوع لكثرة وتنوع مشاغلي. وسنة 1984 اتصلت بي بعض قيادات الرابطة لدخول الهيئة المديرة في قائمة وفاق. وكنت قد اكتسبت آنذاك عبر مقالاتي في ”الرأي” والاحتكاك بالطبقة السياسية والنشاط الطبي والاجتماعي، مكانة مشرفة في المجتمع.
ولم أتردد في قبول العرض دون أن يخطر ببالي لحظة واحدة أن الرابطة التي كان الكل يقسم فيها بأغلظ الأيمان أنها ليست مؤسسة سياسية ستكون الباب الكبير الذي سأدخل منه السياسة رفضت دخولها عبر الأبواب الصغيرة للأحزاب الصغيرة. والحق يقال أنني بقيت مدة طويلة عضوا ”لتزيين المحفل” فقد كانت الهيئة المديرة بين يدي كل من الجازي والشرفي والشماري أساسا. ولم يكن الأمر يضيرني كثيرا بما أن المواقف كانت جيدة ولم يكن لي متسع من الوقت لأبحث عن موقع قدم وأنا غارق إلى الأذنين في تجربة الطب الجماعي ومشاكل جمعية المعاقين والكتابة الفكرية في مشاكل الديمقراطية وحقوق الإنسان بجانب الأبحاث العلمية والإشراف على عدد متزايد من أطروحات الدكتوراه. ولم أكن أتدخل بقوة إلا في حالات نادرة منها نقاش ميثاق الرابطة. وإبان هذه الفترة بدأ مسلسلي مع ”القضاء” وأحلت على المحاكمة أكثر من مرة بسبب مقالاتي في ”الرأي” وخاصة من أجل كتاب ”دع وطني يستيقظ” التي صادرته السلطة.