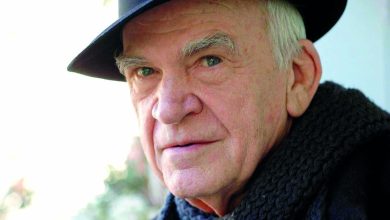الشاعرة التي كتبت بأظافرها على حائط زنزانتها…وتركت اسمها يتردد داخل كل مغربي

لوسات أنفو محسن برهمي:
“لماذا سميتني سعيدة. كان عليك أن تختاري أي اسم آخر، السعادة لا توجد هنا “، هكذا قالت سعيدة المنبهي، لأمها حين زارتها في السجن”
ولدت سعيدة المنبهي بحي رياض الزيتون بمدينة مراكش، في إحدى أيام شهر شتنبر1952 لتكون الثالثة بين أخواتها، “غيَّر وجود أربع بنات في البيت من طريقة تفكير والدي، أو لنقل أفكاره رغما انها كبرت معنا. لم يجبرنا أبدا، لا هو ولا الوالدة، على القيام بأي شيء. علمانا على أن نكون احرار، كان الأمر استثنائيا مقارنة بالعائلات الأخرى” تقول اختها خديجة المنبهي في حوار لموقع الحوار المتمدن. كانت والدة سعيدة المنبهي “فخيثة الهلالي”، امرأة منفتحة وذات فكر متفتح كذلك، بينما كان والدها مفتشا عاما بمستشفى، عاشت طفولة عادية، فلقد رسم لها القدر طريقا سارت عليه منذ أول صرخة لها في هذه الحياة، عن طفولتها تقول والدتها في تصريح سابق: “لم أجد صعوبة في تربيتها. كانت متواضعة، مجتهدة، تطالع باستمرار، تحب الأطفال، وكانت دائما وهي في طريقها إلى البيت، تصحب معها الأطفال الرعاة قصد إطعامهم، وبدورهم كانوا يعترضون طريقها ليقدموا لها الزهور”.

الماركسية الصغيرة:
في ثانوية أبي العباس السبتي بمراكش، نالت سعيدة المنبهي سنة1971 شهادة البكالوريا، لتسافر بعد ذلك إلى العاصمة الرباط، لتنخرط بعدها مباشرة بصفوف الحزب الشيوعي، استقرت سعيدة مع أختها خديجة التي كانت تتابع دراستها في الطب، فيما اختارت سعيدة دراسة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، لتنخرط بعد ذلك في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث أصبحت مناضلة نشطة داخل فصيل «الطريق الديمقراطي القاعدي» في هذا الصدد تقول خديجة المنبهي لنفس الموقع “لقد كانت طالبة جيدة، رائعة، إنسانية، لطيفة للغاية. لا تزعج الناس في النقاشات. كانت عكسي تماما”. بين الجامعة والنضال بدأت سعيدة في تدريس اللغة الفرنسية بإعدادية الخوارزمي، وهي التي قد وجدت ضالتها في حركة إلى الأمام السرية التي حظرتها الدولة آنذاك، بعد انفصالها عن الحزب الشيوعي. مع مطلع السبعينات أصبح النظام أكثر صرامة مع المناضلين/ت وبدأت الاعتقالات، لتظهر الماركسية الصغيرة وتتكفل بالأعضاء السريين في الحركة، بمساعدتهم على إيجاد مأوى لهم، بالإضافة إلى توفير تغذيتهم وحمايتهم من الشرطة.
لم ينسها النضال حياتها الخاصة، حيث تزوجت عام 1972 من رجل تعليم يكبرها سنا، لكن سرعان ما انتهى كل شيء بعد عام ونصف، لتطلب سعيدة الطلاق الذي حصلت عليه في الأخير. الحب الحقيقي الأول والأخير لسعيدة سيظهر بعد الزواج الفاشل عندما سيظهر عزيز لعريش، الذي يشترك ويتقاسم معها النضال في حركة إلى الأمام. كانت تخفيه في شقتها الصغيرة، حيث عاشا قصة حبهما، تقاسما فيها أسرار الحركة والرفاق، كما تقاسما كتب الثورات في العالم وعبر التاريخ. لكن للأسف مصيره مصير العديد من المناضلين، ففي 15يناير سنة 1976 تأكد خبر اختطاف عزيز، لتنتهي قصتهم مؤقتا. سعيدة احتفظت داخل شقتها الصغيرة بكل وثائق الحركة، هويات الأعضاء، تقارير الاجتماعات، كانت مقتنعة بأن عزيز لن يعترف بشيء تحت التعذيب، ولكن من باب الاحتياط جمعت الأختان المنبهي جميع الأشياء لتحتفظ بها خديجة في حقيبة سوداء، لتنتقل للعيش مع خديجة في شقتها، ” كانت الساعة تشير، بالضبط، إلى السادسة مساء. كان هناك رجلان من البوليس السري. لوثا مياه محيطي الهادئ في بيتي. أصبحت الجدران شاحبة بالكراهية، كراهية الفاشيين”. هكذا وصفت سعيدة مشهد اعتقالها من طرف الشرطة السرية بدقة في إحدى قصائدها الـ 26 التي كتبتها وراء جدران السجن.
مصير مجهول:
اختفت سعيدة بدون أن يعرف أحد من افراد عائلتها هل هي بخير أم لا، أو مكانها. بعيون مغمضة اقتيدت من الرباط إلى درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، حيث ذاقت كل أنواع التعذيب النفسي، والجسدي طيلة ثلاثة أشهر، رغم كل هذا ظلت سعيدة قوية، لم تتحدث او تعترف بمكان الحقيبة. بعد الصمود الذي واجهت به الشرطة وفقدانهم الأمل في اعترافها، تمت إحالتها إلى السجن في انتظار محاكمتها التي بدأت سنة 1977، أي بعد عام من اعتقالها، مثلت سعيدة أمام المحكمة ونددت بالعنف والقمع اللذين تتعرض له النساء في المغرب، والدفاع عن حق تقرير المصير، ليتم الحكم عليها بخمس سنوات حبسا نافذة بـ«تهمة الضلوع في أنشطة معادية للدولة»، اضافة الى سنتين بـ«تهمة الإساءة لهيئة المحكمة». كما حكم على عزيز بثلاثين سنة، لينقل الى السجن المركزي بالقنيطرة، فيما نقلت سعيدة الى السجن المدني بالدار البيضاء، لتنتهي قصة حب سعيدة وعزيز الى الابد، كل هذا لم يمنع سعيدة من اكمال مقاومتها فاختارت الكتابة كسلاح جديد، كانت تكتب لعائلتها وحبيبها، “بدأت سعيدة تكتب الشعر بأظافرها على حائط الزنزانة… كانت تكتب ولا تنقح، لأنها لم تكن تفكر في أضواء الشهرة، ولا في المخبرين وجواسيس اللغة” يذكر عبد اللطيف اللعبي الذي ترجم قصائدها إلى العربية، لم تنسى سعيدة عائلتها، فكانت تكتب بكل حب ورقة رسائل الى شقيقاتها، كتبت إلى أختها مليكة، التي كانت حاملا للمرة الثالثة، تنصحها بقراءة كتاب فرانسواز دولتو الأخصائية في الطب النفسي للأطفال: “اقرئي فقط ما يهمك وما يمكن أن تفهميه، واتركي الباقي”. كما كتبت إلى أختها الصغرى بهية، ذات الـ 19 ربيعا، تقول لها: “لا تمر دقيقة، في الليل أو النهار، دون أن أفكر فيك، دون أن أشتاق إلى عينيك الكبيرتين اللتين تشبهان محيطا أنهل منه قوتي وشجاعتي”. وإلى خديجة: “أخذت الكثير من الأشياء منك. علمتني الصبر والشجاعة، وشخصيتي مطبوعة بكل بصماتك، أختي خديجة، نحن لا نعيش، فقط، على الماضي، سواء كان أليما أم سعيدا، وإلا فإننا سنشيخ قبل الأوان. لأن الشيخوخة، في نظري، تبدأ عندما لا نستطيع أن نتجاوز وننسى الماضي الذي نعزه أو نكرهه”، وإلى حبيبها عزيز: “في رسالتك الأخيرة، أحسست أن حبنا قوي جدا. أقوى من القمع ومن ظلمة السجن الحالكة. حفزت كلماتك تلك دمي، وروت جسدي العطشان، وملأتني بقوة لا تقهر”.
روح مخترقة لأسوار السجن:

تعودت سعيدة على حياة السجن، فكوّنت علاقات مع السجينات خصوصا بائعات الهوى منهم، التي بدأت في تجميع شهاداتهم لموضوع رأت انه يستحق النشر لكن لم يكتمل فيما بعد. كانت تتضامن مع رفاقها الذين كانوا يدخلون في اضراب عن الطعام بين الحين والآخر. يوم 8 نونبر 1977، دخلت سعيدة إضرابها الثالث عن اضراب الامعاء الفارغة، بعد اربعة وثلاثين يوما، دخلت سعيدة في غيبوبة، لتقرر إدارة السجن إرسالها إلى مستشفى ابن رشد الذي لم يكن يتوفر على جهاز إنعاش. تقول خديجة مرة أخرى “تم اغتيال سعيدة. وارتكبت تلك الجريمة داخل أكبر مستشفى بالدار البيضاء…على مرأى ومسمع مني” وأضافت: “اقتناعي الراسخ وقناعتي التي لم تتزحزح، بعد مرور أزيد من أربعة عقود أنه كان بالإمكان إنقاذ حياة أختي المناضلة، التي ظلت في حالة لمدّة ثلاثة أيام طوال تصارع الموت، وحيدة، معزولة وبدون أية عناية كانت في غرفتها مُحاطة بجحافل من “العسكر” والبوليس، لمنعها من الهروب ليس إلاّ. نعم، وبكل تأكيد، كانت إمكانية إنقاذ حياة سعيدة مُتاحة ومُمكِنة… لو تجنّد طاقم من الأطباء المختصين في الإنعاش والعناية المركزة، لكن أصرّوا على إهمالها لتواجه مصيرها المحتوم”، واختتمت خديجة قائلة:” يزورها طبيب وحيد من حين لآخر. كان فرنسي الجنسية، في طور إنهاء خدمته المدنية. كان داخليا بصدد إتمام تكوينه الطبي، توجَّهتُ إليه، بعد خروجه من الغرفة، التي كانت من المفترض طبياً أن تكون غرفة إنعاش وعناية مكتفة، وصرح لي مباشرة أنه ليس بإمكانه تحقيق معجزة…طبيب وحيد، لم يستكمِل تكوينه بعد، كيف له أن ينتزع سعيدة من مخالب الموت؟ سعيدة، مغربية شابة، في ربيع حياتها عزلاء، من دون أية عناية طبية، تصارع الموت، من أجل الحياة، إنه الظلم بعينه، الموت/الاغتيال المُدبّر، مع سبق الإصرار والترصُّد!”.

“قاومي عزيزتي قاومي” تقول أيضا خديجة بعدما رخّص لها في الحادي عشر من شتنبر عام 1977، الذي تزامن مع عيد الأضحى لإلقاء نظرة عليها، بل إن صح التعبير لتوديعها، ففي نفس اليوم على الساعة الخامسة صباحا توفيت سعيدة عن عمر لا يناهز 25 سنة بسبب الإهمال، وفي نفس اليوم كذلك تم نقل جثمانها إلى مسقط رأسها.
فتح موتها نارا على تردي خدمات المستشفيات المغربية، وكذلك ظروف المعتقلين السياسيين. “بقي لي أن أشيد بكلّ العائلات التي تناضل وتُصرّ على معرفة الحقيقة، كل الحقيقة مهما كلّفها ذلك من تضحيّات… تقاوم الصمت وتزوير التاريخ منذ عقود خلت… تُقارع جبروت الدولة وأسرار الدولة من أجل معرفة مصير أبنائها المجهول، مجهولي المصير والمعتقلون في غياهب مراكز التعذيب… تحية خاصة لكل المحامين المناضلين الذي آزروا، بجرأة وتفاني، كل “ضحايا” القمع والاستبداد!” تنهي خديجة حوارها.
رحلت الشاعرة التي كتبت بأظافرها على حائط زنزانتها الى الأبد، لكن تركت اسمها يتردد داخل قلب كل مغربي، فكيف لنا أن نحزن على فراقها وهي التي قالت:
“تذكروني بفرح، فأنا وإن كان جسدي بين القضبان الموحشة، فإن روحي العاتية مخترقة لأسوار السجن العالية، وبواباته الموصدة، وأصفاد وسياط الجلادين الذين أهدوني إلى الموت. أما جراحي، فباسمة، محلقة بحرية، بحب متناه، تضحية فريدة، وبذل مستميت”.