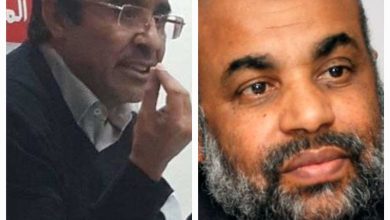تقرير مدرسة الريادة بين غزارة الصفحات وفقر التحليل

عبد الرزاق بن شريج
مدخل عام
دأبتُ على متابعة الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية لما تمثله من مؤشرات على توجهات الإصلاح التربوي في بلادنا، خصوصاً في ظل منظومة تعليمية تعاني منذ سنوات من اختلالات بنيوية عميقة. وفي هذا السياق، تأتي هذه القراءة النقدية لتقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية حول تنظيم التكوينات بمؤسسات الريادة (شتنبر 2025)، وهو تقرير يمتد على 98 صفحة، ويتناول ظروف تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الأساتذة خلال الموسم الدراسي 2025-2026.
ركز التقرير على تتبع شروط تنظيم التكوينات ومدى انخراط المستفيدين وجودة التأطير، مع تقديم خلاصات واقتراحات عملية لتعزيز نجاعة التكوين وضمان أثره في الممارسة الصفية.
شملت العملية 92 مركزًا للتكوين و51 مؤسسة محتضنة للورشات على صعيد جميع الأكاديميات الجهوية، واعتمدت منهجية كمية وكيفية استندت إلى استمارات موجهة إلى المديرين والمفتشين المكونين والمنسقين والأساتذة المستفيدين.
وقد نُفذت العملية التذكيرية أيام 4 و5 شتنبر 2025، عبر أربع مراحل متكاملة: التحضير، التنسيق، الزيارات الميدانية، ثم إعداد التقرير النهائي.
منهجية القراءة النقدية
فرضت القراءة المتأنية للتقرير اعتماد مقاربة نقدية مركزة على الجوانب التقنية والتحريرية قبل الخوض في المؤشرات التربوية. فحجم التقرير (98 صفحة) يوحي بغزارة المعطيات، غير أن التقارير الجيدة تُقاس بجودة عرضها وتنظيمها أكثر مما تُقاس بعدد صفحاتها.
ولأجل ذلك، قُسمت هذه القراءة إلى ثلاثة محاور كبرى:
- الجانب التقني والتحريري وتضخيم التقرير؛
- التناقضات البنيوية في محتوى التقرير؛
- أوجه القوة والضعف، مع اقتراح حلول عملية مستندة إلى دراسات وطنية ودولية.
وسيقتصر هذا الجزء على المحور الأول.
المحور الأول: الجانب التقني والتحريري وتضخيم التقرير
أولاً: أسباب تضخم التقرير
يُلاحظ من خلال تحليل بنية التقرير أن تضخمه لم يكن نتيجة لغنى المعطيات بقدر ما هو نتاج تكرار الأساليب والعبارات والمضامين. ومن أبرز المظاهر:
- التكرار اللفظي والمضموني في عرض الأفكار نفسها عبر مختلف الأسلاك التعليمية؛
- إعادة وصف المؤشرات والأرقام في أكثر من محور دون دمجها؛
- الإطالة في الشروح والتعاريف؛
- الإفراط في استعمال العبارات الرسمية المكرورة مثل “في إطار تنفيذ مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026…”؛
- تكرار نفس الجداول والمبيانات دون تقديم تحليل نوعي جديد؛
- تخصيص عشر صفحات تقريبًا (من 5 إلى 15) لعرض السياق التنظيمي والمذكرات بدل الانتقال مباشرة إلى النتائج.
يخلص هذا التحليل إلى أن تضخم التقرير نابع من غياب الاقتصاد اللغوي والتكرار البنيوي أكثر من كونه نتيجة عمق في التحليل أو ثراء في المحتوى.
ثانياً: سبل اختصار التقرير دون الإخلال بالمضمون
يمكن اختصار التقرير بشكل مهني وفعّال عبر الإجراءات التالية:
- الانتقال من “التقرير الوصفي” إلى “التقرير التحليلي”، أي التركيز على ما تكشفه المعطيات من دلالات وأسباب بدل الاكتفاء بسرد ما تم القيام به.
- تجميع المحاور المكررة في تحليل أفقي واحد يبرز أوجه التشابه والاختلاف بين الأسلاك التعليمية، مع توحيد أقسام “الإكراهات” و“التوصيات”.
- الاقتصاد في الصياغة عبر استعمال جمل مكثفة واضحة.
- الاعتماد على الرسوم البيانية بدل الجداول الطويلة، بحيث يمكن اختزال عشر صفحات من الجداول في ثلاث صفحات من المبيانات التفاعلية.
- وضع البيانات الإحصائية في ملحق مستقل، والاكتفاء بالإشارة إليها في المتن الرئيسي.
ثالثاً: الشكل الأنسب لتقرير مختصر ومهني
يمكن أن يُعاد بناء التقرير في صيغة مهنية مختصرة كما يلي:
- المقدمة والسياق: لا تتجاوز ثلاث صفحات، تركز فقط على الارتباط بخارطة الطريق والمراسلات الرسمية؛
- منهجية الإنجاز والعينة: ثلاث صفحات تتضمن جدولًا ومبيانًا مختصرين؛
- النتائج حسب المحاور (اللوجستي، التنظيمي، البيداغوجي، الأثر): عشر صفحات تتضمن تحليلاً نوعيًا مقارنًا؛
- الاستنتاجات العامة: ثلاث صفحات تبرز الاتجاهات الكبرى؛
- التوصيات والإجراءات المقترحة: ثلاث صفحات موجهة وطنياً وجهوياً؛
- الملاحق الإحصائية: بين خمس وثماني صفحات تخصص للبيانات والجداول التفصيلية.
وبذلك يمكن حصر التقرير في 25 إلى 30 صفحة دون المساس بالمضمون الأساسي أو القيمة التحليلية.
رابعاً: المراجع المعتمدة
ينص الدليل المرجعي لإعداد التقارير التربوية بالمغرب (IGAP, 2019) على أن “التقرير الجيد هو الذي يوجز المعطيات ويقود القارئ مباشرة إلى الخلاصات والتوصيات القابلة للتنفيذ.”
كما تؤكد منظمة اليونسكو (UNESCO, 2021) أن الحجم الأمثل لتقرير وطني حول التكوينات أو التقييمات يجب ألا يتجاوز 30 إلى 40 صفحة، على أن توضع التفاصيل التقنية في الملاحق.
خاتمة المحور الأول
يمثل تقرير المفتشية العامة حول تنظيم التكوينات بمؤسسات الريادة مجهوداً مؤسسياً مهماً في تتبع تنزيل مشاريع الإصلاح، غير أن الإفراط في الوصف والتكرار يحدّ من فعاليته كأداة تقييمية.
إن تطوير آليات إعداد التقارير عبر اعتماد التحليل الموجز والتمثيل البصري للمعطيات كفيل بجعلها أكثر نجاعة واستثماراً في اتخاذ القرار التربوي. فالتقرير الفعّال هو الذي يُوجز دون إخلال، ويُحلل دون إطناب، ويُقنع دون إغراق في التفاصيل. أما الحجم الكبير للتقرير الحالي، فيجعل من الصعب تداوله واستثماره من قبل الفاعلين التربويين.
ترقبوا المحورين:
الثاني: التناقضات البنيوية في محتوى التقرير؛
والثالث: أوجه القوة والضعف، مع اقتراح حلول عملية مستندة إلى دراسات وطنية ودولية.
قريبا