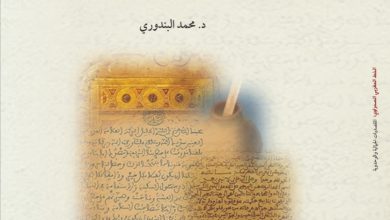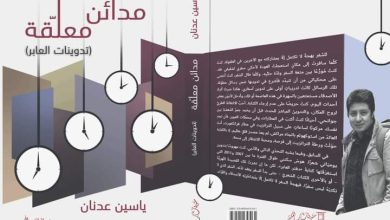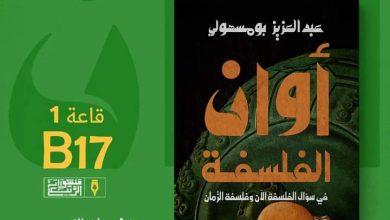قراءة في فكر عبد الله حمودي : تجاوز ثنائية الحداثة و التقليد من أجل التأسيس لمذهب سياسي جديد

لوسات أنفو : أيوب داهي
منذ قرون و منطق الهيمنة و التبعية و الضعف و اختلال موازين القوى هو الذي يحكم العلاقة بين شعوب منطقتنا و ثقافتهم و بين المسار الذي قطعته أروبا. تمخض عن هذا الوضع أن أصبحت كل مشاريعنا النهضوية في الماضي و الحاضر بمثابة ردود افعال فقط, ترتكن الى مواقع الدفاع بدلا من مواقع التوازن و القوة. هذا الوضع اقتضى طرح السؤال التالي : كيف يتحقق هدف تعديل ميزان القوى؟ و ما وسائل المواجهة ؟
يجيب عبد الله حمودي عن هذا السؤال بأن ذلك يتحقق بابداع آليات معرفية جديدة و مؤسسات تكون كفيلة باستيعاب طاقات الافراد و الجماعات, فالنضال ضد الهيمنة الغربية لا يمكن أن يكون الا بوسيلة العمل المنتظم في ميادين المعرفة الوعرة, بدلا من محاولات السطو على المنجز المعرفي للغير. يقتضي الامر اذا بناء نظامنا المعرفي الخاص, منطلقين من ضرورة الشعور باننا مقحمين في منظومة شاملة هي من صنع القوى الغربية العظمى و هي المنظومة التي أطلق عليها اسم ‘ الحداثة’ .
الحداثة هي بناء/حقبة تاريخية ساهمت عوامل متعددة في تشكيلها كواقع معقد و أسفرت عن تشكيلة اجتماعية و سياسية في اروبا الغربية شكلت قطيعة مع ما كان قبل. لقد تفاعلت معطيات تاريخية معقدة لتسفر عن منتوج الحداثة. انطلقت بتراكم مادي غير مسبوق بفعل ازدهار التجارة و الصناعة و تقدم المدن على حساب الاقتصاد الفلاحي الموروث, ثم ساهمت الثورة البروستانتية و الاصلاح الديني ضد الكنيسة الكاثوليكية و مارافق ذلك من صراع حول النفوذ الديني و الاخلاقي بين المذهبين, حيث دفع التيار البروستانتي في اتجاه الاعلاء من قيمة الاعتقاد الشخصي على حساب الانسياق خلف معتقدات مبسوطة من طرف الكنيسة و ادارة الايكليروس. هذا الواقع دفع بعمليات البحث الجاد في الوسائل العلمية لتنمية التقنيات و الموارد من جهة و البحث في الاسس الفلسفية للمعرفة و القوانين التي من شأنها ان تعين على تدبير الخلافات من جهة أخرى. و الراجح ان تمخض عن هذا كله مجهودات في حرية الفكر و الابداع , الشيء الذي كرسته حركات فكرية و فلسفية كان من نتائجها ثورات العقل في العلوم الطبيعية و في مجالات التنظير للدولة و تنظيم المجتمعات و اقتران الوجود ككل بالتفكير العقلي و استقلال الضمير في المجهود الفلسفي و المعرفي و في المجهود الاخلاقي.
يرتبط تصور الحداثة اذا باعتبارها بناء تاريخي حصل تدريجيا و تبلور في مظاهر شتى, فلا يستقيم تصورها كشكل لبرنامج مثالي تم وضعه أولا و قام الناس بتطبيقه. فالحداثة لم تخضع لبرنامج مسبق أو لجدول أعمال جاهز جاهز أو لعقل مدبر.
في هذا السياق يقول عبد الله حمودي انه يتفق تماما مع مقولة كارل ماركس ‘ التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه الا على شكل مهزلة’ , اذ يعتبر الحداثة واقع تاريخي محدد بمعطيات مظبوطة و عليه فانه من المستحيل ان تعيد نفسها على الشكل الذي ظهرت به عند غيرنا. و هنا يؤكد حمودي انه لا سبيل لاعادة البناء و تحقيق التوازن في ميزان القوى مع المجتمعات الغربية الا بالابداع في خضم الواقع الراهن المعاش, بدلا من تصورات مجردة و قوانين تاريخية عامة.
يعتبر حمودي ان فشل التيارات السياسية سليلة الحركة الوطنية التي أطرت المشهد السياسي منذ الستينيات الى حدود الربيع العربي و التي أنيطت بها مهام انجاز المشروع الوطني قد اسفر عن وضع جديد حابل بتحولات عميقة اعاد ترتيب الاوراق الاجتماعية و السياسية على شكل جبهتين, الاولى حداثية و الثانية دعوية.
يعتمد مشروع حمودي من أجل تجاوز هذا الوضع على ضرورة التنقيب عن المشترك بين الجبهتين, ثم البحث في اشكالية تهميش ذلك المشترك من طرف الجانبين. فالخروج من هذه الثنائية يمهد للتفكير في مشروع مجتمعي جديد يضمن اعادة تعريف الوطن على اسس مقبولة من طرف مكونات المجتمع الحية و يلبي رغباتها في المزيد من التحرر و السعادة. فمع تحليل هذه الاشكالية قد تظهر أوجه التوافق الممكنة في اتجاه منظومة سياسية تعالج مخلفات الانفصام.
و في أهمية البحث عن هذا, المشترك يعتبر حمودي ان وجود جبهة حداثية ثقيلة من حيث الوزن الديموغرافي و السياسي الى جانب تطلع الاجيال الجديدة الى مزيد من الحرية و العدل و الكرامة, بالاضافة الى ظهور اجتهادات كثيرة و مختلفة في ميدان اصلاح المعاملات من منظور الاصول الدينية و الشرعية, يجعل استمرار السلطويات سواء باسم الدين او باسم مبادئ اخرى أمرا مستحيلا, كما ان هذه المعطيات تفتح فضاءات جديدة للنقاش بين الجبهتين.
و لكي يتم استثمار التجربتين في اتجاه التوافقات المنشودة يتعين التنقيب حسب حمودي عن مكامن التهافت في تصورات الجبهتين, خصوصا في ما يتعلق بآليات الانتاج المعرفي و هو الامر الذي من شأنه أن يدلنا على مسلك للخروج من ثنائية الجبهتين و شق الطريق الى تشكيل جبهة جديدة موحدة تتجنب خطر الدوران في حلقات مفرغة.
يتفق المشروع الحداثي و المشروع الاصولي في ضرورة الاصلاح قصد اعادة بناء المجتمع و المؤسسات ( النمو الاقتصادي و العلمي,توفير الرخاء, العيش الكريم, تقوية الوطن قصد اقامة الموازنة مع الكيانات الفاعلة ….) , الاختلاف بين المشروعين يبقى في السند المعرفي لبناء تلك المؤسسات, انه مشكل آليات الانتاج المعرفي. واضح ان آلية المقارنة مع أروبا او ما يسمى غربا هي التي حركت انتاج المعرفة او المواقف التي اعتمدت في برامج الاصلاح الحداثية و الدعوية. ممارسة المقارنة تسكن الانتاج المعرفي للدعويين و الحداثيين على حد سواء. يتم التعامل مع الحادث على انه صادر عن مصدر يسمى الغرب او عن مصدر مناقض يسمى تراث, وهذا طرح مغلوط حسب حمودي, فان نحن نظرنا الى الطارئ بامعان سندرك ان اي ظاهرة جديدة هي بالضرةرة لا غربية و لا شرقية لا تقليد و لا حداثة انما هي وليدة التفاعل. لهذا لا يجب الحكم عليها من خلال ثنائية التقليد و الحداثة او الدخيل و الاصيل. اذا نحن انتبهنا الى انماط الحياة و المعاملات و الافعال اليومية سواء في المسكن و الملبس و المأكل او التنقل و الانتاج و الاستهلاك , فلن نجد الا انماط مبتكرة لا هي اصيلة و لا هي دخيلة. ان اهمال هذا الجانب يساهم في التنكر للطاقات و الجهود الهائلة التي يصرفها الناس في تركيب أنماط حياتهم. مصدر هذه الظواهر اذا, لا هو حداثة و لا هو تراث , لا هو أصيل و لا هو دخيل , ان المصدر الحقيقي هو الاستنباط في خضم الواقع المعاش. ان الاستنباط هو الاصل.
هذا التحليل يأتي بحصيلة ثقيلة لم تكن في الحسبان , مفادها ان أوجه التشابه بين الجبهتين موجودة و قوية و مع ذلك فانها تبقى خاضعة لنفي قاطع. و بالتالي فان نجاح ورش البحث في آليات الانتاج المعرفي سيحررنا لا محالة من ثنائية الحداثة و التقليد و خلفياتها السياسية.
يكشف حمودي عن جذور الحداثة و التقليد حيث يرجعهما الى الصراع بين المجتمعات الاسلامية و الدول الامبريالية, الذي اسفر عن تغيير موازين القوى لصالح الانظمة الاروبية , اي ان الظروف التي أتى في سياقها هذا التصور هي المد الاستعماري الذي هيمن عن الحياة و عن الانتاج المعرفي نفسه, كما على عمليات التصنيف و الفرز بين ما اعتبر تقليدا ميتا و ما اعتبرا رصيدا قابلا للتحديث. فالاصل التاريخي و الصراع مع الغرب و تغيير ميزان القوة لصالحه هو الاصل الحقيقي لثنائية الاصالة و الحداثة. و عليه فان الاصيل و الدخيل كما يجري العمل بهما اليوم ما هما الا موروثان استعماريان. ان تغاضي الجبهتين عن هذه الحقيقة هو رغبة كل واحدة منهما في قيادة المجتمع, فالفرق بينهما في الحقيقة ليس هو الاصالة و الحداثة بل الفرق هو الرغبة في التحكم في الموروث الاستعماري اي السيطرة على منتوجات و قوة الحداثة.
و في سعيهما لهذا المطمح تحاول كل جبهة تصوير الطرف المنافس في صورة النقيض المطلق, بذلك تتنكر لذلك المشترك الضخم المتجسد في ابتكار انماط جديدة للحياة بفعل التحول و التفاعل و الاستنباط. انكار هذا المشترك يتم عن طريق رفع الحداثة عن الدعوي و رفع الاصالة عن الحداثي في محاولة لاخفاء العمق الديني في حياة الحداثي و عمق التحول في حياة الدعوي, فيتحول الحداثي الى استعارة تحيل الى الاخر المنبوذ اي الغرب و يتحول الدعوي الى استعارة تحيل على الفكر المتحجر و التراث الجامد.
هذه الاستعارات تهمل الراهن المعاش و في هذا الاهمال يتجلى انكار المشترك. هذا المشترك هو الاستنباطات العملية الجارية في ميدان المعاملات و الافق العملي يتجسد في الاعتراف بهذا المشترك الضخم.
ان التخلص من ثنائية الحداثة و التقليد سيعطي الامكانية لاعادة تعريف الوطن من اجل اعادة بنائه.