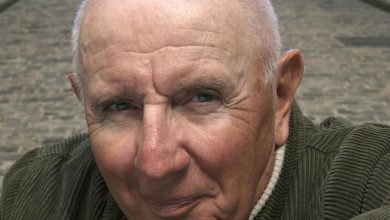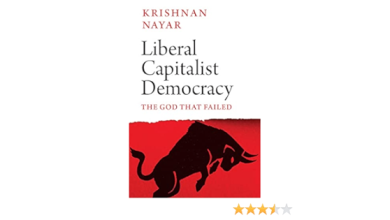“نظرية كل شيء” .. هل دخلت الفيزياء في ركود؟

دريان دي سوتر/ باحث في تاريخ العلوم و دراسات التكنولوجيا
تصفح رفوف كتب العلوم الشائعة في الفيزياء، وستجد غالبًا موضوعًا مشابهًا. سواءً كانت هذه الكتب تُقدم رؤىً حول “الواقع الخفي ” ( 2011 )، أو “شيءٌ خفيٌّ للغاية ” ( 2019 )، أو “كوننا الرياضي” ( 2014 )، فإنها تُلمّح إلى عالمٍ خفيٍّ ينتظر من الفيزيائيين كشفه – وهو مجالٌ يتجاوز إدراكنا الحسي، ويظلّ مجالَهم الخاص.
على مر تاريخها، قدمت الفيزياء أوصافًا دقيقةً ودقيقةً للكون المادي. أما اليوم، فإن الواقع الذي يسعى الفيزيائيون لكشفه يبدو أبعد ما يكون عن الواقع الذي يعيشون فيه. فعلى الرغم من نجاحاتها التجريبية، فشلت الفيزياء مرارًا وتكرارًا في تحقيق توقعاتها بتقديم فيزياء “نهائية” أعمق – واقع يوحد جميع الفيزياء الأخرى. وبالتالي، يبدو أن الفيزيائيين مجبرون على قبول افتراضاتٍ تخمينية متزايدة.
ومع ذلك، في ظل غياب أي سبل واضحة للتحقق من هذه التكهنات، لا يبقى أمام الفيزيائيين خيار سوى تكرار مناهج وتجارب مماثلة – وإن كانت أكبر حجمًا وبتكلفة أكبر – على أمل اكتشاف شيء جديد. ويبدو أن مجال الفيزياء الأساسية، الذي يكتنفه القلق من عدم اكتشاف أي جديد أو من أن التجارب المستقبلية لن تكشف إلا عن مزيد من الجهل، يشجعه على السعي وراء أفكار خيالية أكثر فأكثر.
أزعم أن السعي وراء وحدة واقع أكثر جوهرية وهيمنة عليه لا يُمثل امتيازًا خاصًا بالفيزيائيين، بل عبءً ثقيلاً أثقل كاهلهم من العالم الحديث. أقترح أن نتبنى فهمًا أكثر تعددية ودقةً لمكونات الكون، فهمًا لا يقبل فحسب، بل يدعو إلى نقد الممارسات والتخصصات والحقائق الأخرى في مأزقه الحالي. إن
الفترة التي قضيتها في الفيزياء، كفيزيائي نظري طموح، ثم كعالم اجتماع يدرس ممارسات الفيزياء الأساسية، جعلتني أتساءل إلى أي مدى لا تزال سرديات الوحدة والغائية تخدم المجتمعات التي تروج لها. وإلى أي مدى يتطلب تحقيق إخلاص أكبر تجاه مكونات الوجود، وطبيعة الواقع، ومكونات الكون، أن تتخلى الفيزياء عن دورها كمصدر رئيسي للواقع؟
في يومٍ ماطرٍ بوسط لندن، جلستُ لمقابلة أستاذٍ في فيزياء الجسيمات الفلكية. حينها، كنتُ قد أمضيتُ ما يزيد قليلاً عن عامٍ في مراقبة الاجتماعات الأسبوعية لمجموعته البحثية: جزءٌ من مشروعٍ تعاونيٍّ لبناء تجربةٍ واسعة النطاق للكشف عن المادة المظلمة.
خلال المقابلة، لاحظتُ شيئًا لم أُعره اهتمامًا حتى ذلك الحين. بعيدًا عن المناقشات التقنية حول نمذجة التجارب ومعالجة البيانات التي كانت تشغل اجتماعات المجموعات، أدركتُ شعورًا بالقلق، ليس فقط في هذه المجموعة، بل في مجتمع الجسيمات والمادة المظلمة الأوسع، وفي الفيزياء الأساسية عمومًا.
كان قلقًا غذّاه إدراكهم أنهم يعملون في هذا المجال منذ زمن طويل، وبدأ يدفعهم للتساؤل عما سيقدمونه. وكما أخبرني الأستاذ: “نستمر في التوسع والبناء بشكل أفضل. ولكن ربما لا يكون الأمر كذلك”. في مقابلتنا، تحدث مرارًا وتكرارًا عما سيفعله بشكل مختلف لو كان جديدًا في هذا المجال، وعن الأموال التي أُنفقت على هذه التجارب، وعن المسؤولية التي شعر بها تجاه الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية الذين جندهم لهذه المهمة. كان من الواضح أن هذا كان مصدر قلق شخصي بقدر ما كان مصدر قلق مهني.
بدأت رحلتي نحو هذه المجموعة من المادة المظلمة قبل سنوات. بعد تخرجي في الفيزياء الفلكية والرياضيات التطبيقية، آملًا دراسة الواقع في جوهره، فكرتُ في عروضٍ لمتابعة أبحاث الدكتوراه في علم الكونيات النظري. لكن عندما طُلب مني الاختيار بين مشاريعَ افتراضيةٍ لا أملَ في التحقق منها رصديًا، غادرتُ المجالَ خائبًا، مُدركًا أنني لن أجد فهمًا أعمق للواقع هناك.
“إنه أشبه بمعرفة كل شيء عن الكثبان الرملية … ولكن لا تعرف مما تتكون حبة الرمل “
بدلاً من ذلك، انجذبتُ إلى علم الاجتماع، الذي قدّم لي رؤيةً ثاقبةً لعالمٍ يبدو أكثر واقعيةً – عالم الحياة اليومية – وفرصةً لاستكشاف ظواهر تُهمَل عادةً لكونها غير قابلة للقياس، وفوضوية، وذاتية. في حين تسعى العلوم الطبيعية في المقام الأول إلى جعل غير المألوف مألوفًا، فإن العلوم الإنسانية النقدية غالبًا ما تعمل انطلاقًا من دافعٍ معاكس – جعل المألوف غير مألوف. طموحها هو استنطاق أمورٍ تُعتبر مُسلّمات، ومعرفة كيف تُحشد الخطابات والمعارف، وحتى الحقائق المُعطاة، سياسيًا.
في نهاية المطاف، أعادني بحثي إلى علم الكونيات. أردتُ أن أفهم كيف أصبح الكون مرادفًا للعالم ما وراء الأرض، ويُعتبر حكرًا على الفيزياء. لذلك، قررتُ إجراء بحث إثنوغرافي مع فيزيائيين يبحثون في المادة المظلمة ومسائل أخرى في علم الكونيات.
اطلب من فيزيائي أن يعدد لك المشكلات الكبرى المفتوحة في الفيزياء الأساسية وعلم الكونيات، ومن المرجح أن تكون مشكلة المادة المظلمة من بينها. يُعتقد أنها تُشكل أكثر من 85 % من إجمالي المادة في الكون، ويُستدل على وجودها، لكنها لا تزال غير مُكتشفة. وكما أوضح عالم الفيزياء الفلكية بريامفادا ناتاراجان بإيجاز في الأكاديمية الملكية للفنون بلندن عام 2019:
يمكننا رسم خريطة مكانية دقيقة، ونخبرك بمكان المادة المظلمة… وماذا تفعل… لكننا لا نعرف ماهيتها. يشبه الأمر معرفة كل شيء عن الكثبان الرملية: كيف تتشكل، وكيف تتشكل… ولكننا لا نعرف مما تتكون حبة الرمل .
لهذا السبب، وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، بنى فيزيائيو الجسيمات كواشف متعددة أملاً في العثور على تلك “الحبيبات”. ولا يزال هناك المزيد من الكواشف المخطط لها، وكل جيل منها أكبر وأكثر حساسية من سابقه. ومع ذلك، بدأ القلق يبرز مؤخرًا. فرغم كل استثمار الوقت والمال، فإن المرشحين المحتملين للمادة المظلمة، والذين كانوا واعدين للغاية في السابق، قد واجهوا “لحظة الحقيقة” ولم يتمكنوا من تحقيق ذلك. حتى أن بعض الفيزيائيين بدأوا يتساءلون عما إذا كانوا سيعثرون عليها أصلاً. في الواقع، ذهب شخص آخر أجريت معه مقابلة، والذي كرّس حياته المهنية للبحث، إلى حد القول إنه لا يعتقد بوجود المادة المظلمة، على الأقل ليس بالطريقة التي فهمها بها.
حتى لو لم تُقلق هذه المخاوف فورًا الباحثين في مجال المادة المظلمة، سواءً كانوا علماء الكونيات أو علماء الفيزياء الفلكية القادرين على رسم خريطة مكانية دقيقة للمادة المظلمة وإخبارنا بـ”ما تفعله”، فإنها تُثير قلقًا كبيرًا. وكما قال لي أحد أساتذة علم الكونيات: “الأمر كله مؤقت، بمعنى أنه إذا لم تكن متأكدًا من وجود الجسيم أصلًا، فهناك علامة استفهام تُحيط بالمسعى بأكمله”.
كما هو الحال مع مشكلة المادة المظلمة، أدركتُ أن جزءًا كبيرًا من الضيق الحالي الذي تعاني منه الفيزياء الأساسية لا ينبع فقط من عدم اكتشاف ممارسيها لواقع أعمق، بل من وطأة التوقع بوجوب اكتشافهم له . ويبدو أن امتلاك الفيزياء الظاهري للواقع الأعمق لا Jبرره النتائج التجريبية لهذا المجال بقدر ما Jبرره الأساطير والروايات التي تدعمه.
الحقيقة هي أن أبحاث الفيزياء الأساسية، وفقًا لمعاييرها العالية، دخلت مرحلة ركود. سيصف الفيزيائيون القلائل القادرون على التخلي عن المتطلبات الصارمة لممارساتهم الفيزياء بأنها على مفترق طرق، أو مضللة ، أو حتى في أزمة . وكما يشير جميع هؤلاء المؤلفين، يبدو أن الفيزيائيين الأساسيين يفتقرون إلى الأفكار بشكل متزايد، حيث تُثبت أحدث التجارب، في أحسن الأحوال، صحة النظريات القديمة.
مجال علم الكونيات أحد هذه المجالات. إذا حكمتَ فقط من خلال التبسيطات، فستبدو قصة الانفجار العظيم الكونية شبه محسومة. على سبيل المثال، يتحدث العديد من علماء الكونيات عن عصر “علم الكونيات الدقيق”، عصر لم يتبقَّ فيه سوى إضافة تفاصيل إلى كونٍ حُلّت معظم مشاكله. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من النموذج الكوني القياسي مجرد تكهنات نظرية.
ليست المادة المظلمة هي المشكلة الوحيدة. فالطاقة المظلمة، على سبيل المثال، التي أثار وجودها المُفترض في البداية الدعوة إلى علم الكونيات الدقيق، لم يُثبت بعد أنها سوى مصطلح رياضي ضروري لموازنة معادلات الفيزيائيين بما يتماشى مع الملاحظات. كما أن التضخم الكوني، وهو فترة نظرية لتمدد متسارع للكون في مراحله المبكرة، لا يزال يُثير جدلاً واسعًا نظرًا لطبيعته “المريحة للغاية”.
نحن نخاطر بما يُسمى “فيزياء ما بعد التجريبية”. باختصار، كونٌ ضائعٌ بالنسبة للعالم.
في الواقع، يشير التدقيق في ادعاءات علم الكونيات العديدة إلى كونٍ أقل وضوحًا من كونٍ هشّ التكوين من التكهنات، إذ يعكس بشكل أفضل مجموعةً من الكيانات التي، مثل المادة المظلمة، تبدو منطقيةً جيدًا لكنها تبقى مجهولة بعناد. وكما يقول عالم الكونيات بيدرو فيريرا ، هناك “خطرٌ حقيقي” في أن تكشف التجارب الإضافية عن “بيانٍ أكثر دقةً بكثير عن جهلنا، لا أكثر”.
يتردد صدى هذا في مجالات أخرى من الفيزياء الأساسية. ففي فيزياء الطاقة العالية، كان اكتشاف بوزون هيغز عام ٢٠١٢ تتويجًا لبرنامج بحثي استمر عقودًا، أكّد بنجاح تنبؤات النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، وهو إطار عمل لوصف البُنى المجهرية للمادة. ومع ذلك، لطالما اعتبر الفيزيائيون النموذج القياسي حلاً مؤقتًا ، وخطوة نحو “نظرية كل شيء” أكثر اكتمالًا، تُدمج الجاذبية في تفسيراتها، وتُفسّر بنجاح الظواهر الفيزيائية على جميع المقاييس. ولهذا السبب، تم التغاضي عن عيوب النموذج وخصائصه الأكثر ملاءمة.
ومع ذلك، ومع مرور السنين، لا تزال هذه العيوب قائمة. لم يُظهر مصادم الهدرونات الكبير (LHC)، الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، أي شيء يشير إلى أن توسعات المنظرين أو بدائلهم ليست سوى انغماس في التخمينات. ردًا على ذلك، دعا البعض إلى بناء مصادم أكبر، مثل المصادم الدائري المستقبلي (FCC) المقترح ، على أمل إلقاء نظرة خاطفة على فيزياء يعتقدون اعتقادًا راسخًا أنها تتجاوز النموذج القياسي. تُقدر تكلفته بنحو 17 مليار دولار.
يُضاف إلى ذلك تزايد الأفكار التخمينية حول فيزياء ما قبل الانفجار العظيم والكون المتعدد، بالإضافة إلى مُنظّري الأوتار الذين يُشيرون إلى أن الاتساق الداخلي لنظرياتهم قد يكون أهم من التحقق التجريبي. بهذا، نُخاطر بما يُسمى ” فيزياء ما بعد التجريبية “. ما لم يتغير شيء، فإن هذا يعني إما التخلي عن الفيزياء الأساسية، أو مجالًا فيزيائيًا يتحرر بشكل متزايد من الإثبات التجريبي. باختصار، يُخاطر هذا بفقدان كونٍ للعالم.
يميل الفيزيائيون الذين سلطوا الضوء على هذا الركود إلى وصف المزيد من الفيزياء، وإن كانت فيزياءً مُصممة بطريقة مختلفة. لكن لا أحد منهم يذهب إلى حد القول إن الحل قد لا يكمن في الفيزياء إطلاقًا. بدلًا من ذلك، أقترح النظر في كيفية رؤيتنا للفيزياء الأساسية وحديثنا عنها. وأنه على الرغم من أن الوحدة والغائية قد تكونان مهمتين لهذا التخصص، إلا أن هذه المفاهيم تعكس الكون بشكل أقل مما هو عليه، وأكثر كما نأمل أن نجده. في هذه الصورة، قد لا يكون الوصف المناسب لمأزق الفيزياء الحالي هو المزيد من الفيزياء، بل بالأحرى، أقل …
لطالما حفّزت أكوامٌ من “النظرية النهائية” الفيزيائيين. وعلى الرغم من أنها على وشك تحقيقها، إلا أنها ظلت بعيدة المنال، فقد سعت الفيزياء النظرية إلى جمع نظريتيها الأكثر نجاحًا، نظرية الكم والنسبية العامة، تحت “نظرية كل شيء”. ويُؤمل، بل ويُفترض أحيانًا، أن تسعى هذه النظرية، في رؤيتها الأشمل، إلى استيعاب جميع أشكال المعرفة الأخرى ضمن تفسيراتها.
حتى لو أصبح من غير المألوف اليوم الإشارة صراحةً إلى هذا الطموح الأخير، إلا أن سرديات الوحدة والنهاية لا تزال قائمة في هذا المجال. بل إنه افتراضٌ غالبًا ما يكون جزءًا لا يتجزأ من الممارسات نفسها. على سبيل المثال، في عام ١٩٩٣، صرّح عالم الفيزياء الفلكية إدوارد دبليو كولب :
وظيفة علم الكونيات هي توفير أرضيةٍ تُنسج عليها مجالاتٌ علميةٌ أخرى خيوطها الخاصة في نسيج فهمنا للكون. ولا تتجلى الوحدة الجوهرية للعلم في أي مكانٍ أفضل من التفاعل بين علم الكونيات، دراسة أكبر الأشياء في الكون، وفيزياء الجسيمات، دراسة أصغر الأشياء.
إنها وحدة يُعتقد أنها متأصلة في العلم، وعادةً ما تُصنَّف الفيزياء في صدارتها. وقد بلغ انتشار هذه السلطة المزعومة حدًا دفع بعض كبار الفيزيائيين إلى اعتبار الدين والفلسفة أمرين باليين. على سبيل المثال، في كتابه المنشور بعد وفاته ” إجابات موجزة على الأسئلة الكبرى” (2018)، ادّعى ستيفن هوكينج صراحةً أن الفيزياء الكونية لم تبقِ “إمكانية وجود خالق”. مع هذه الادعاءات، ليس من غير المألوف الاعتقاد بأن الفيزياء وحدها قادرة، بل ينبغي، على كشف “أسرار” الكون.
لفهم سبب خلطنا السهل بين عالم الفيزياء وواقعنا الفريد والأكثر جوهرية، دعونا نعود إلى القضية التي بدأنا بها، وهي الموضوع الذي تردده كتب الفيزياء الشائعة. إن الفكرة التي تسعى هذه الكتب إلى طرحها واضحة: هناك واقعٌ مخفي عن حواسنا، أعمق من كل ما سواه، يبقى فهمه من واجب الفيزيائيين. لو أُتيحت الفرصة، ولو بكتاب ورقي، لتمكنا من مشاركة هذا الواقع مع القارئ المحتمل أيضًا. علينا أن نتساءل عن الدور الذي تؤديه هذه الكتب وسردياتها، عند جمعها معًا وتكرارها باستمرار، ليس فقط لعامة الناس، بل للفيزيائيين أنفسهم.
لقد ارتكبنا خطأ الاعتقاد بأن الكون مادي في الأساس، وذلك لأن العالم يمكن استجوابه من خلال الفيزياء .
كما أشار الفيزيائي النظري كارلو روفيلي في مقدمة كتابه ” الواقع ليس كما يبدو” (2014): “كلما ازدادت معرفتنا بالعالم، ازدادت دهشتنا بتنوعه وجماله وبساطته”. وفي مقدمة الكتاب، يقدم روفيلي تفسيرًا مألوفًا لمجاز أفلاطون عن الكهف، دعمًا لسعي الفيزيائيين وراء الحقيقة ونحو واقع بسيط يتجاوز المظاهر المعقدة. ويشير روفيلي إلى أننا “جميعًا في أعماق كهف، مقيدين بجهلنا وتحيزاتنا”، ويجادل بأن العلم، من خلال قدرته على “كشف جوانب جديدة من الواقع، وبناء صور جديدة وأكثر فعالية للعالم”، سيُحقق لنا الخلاص.
كما قال عالم الاجتماع برونو لاتور في كتابه “سياسات الطبيعة” (1999)، فإن استعارة الكهف مألوفة، وتكشف عن سمة مميزة للفكر الغربي والعلمي: انقسام العالم إلى قسمين. من جهة، عالم ذاتي يسوده التشويش، عالمٌ يُطلق عليه روفيلي “التعصب” و”الجهل” – وهي كلها سمات لما يُمكن وصفه بالعالم الاجتماعي. ومن جهة أخرى، عالم طبيعي، موضوعي ونقيّ، لم تُزعجه البشرية.
يمكن للفيزيائي أن يزعم دورًا يبدو أنه خاص به وحده، ألا وهو الفرار مما يصفه لاتور بـ “طغيان العالم الاجتماعي… حتى يتمكن أخيرًا من تأمل العالم الموضوعي”. في هذا الدور، يكتسب الفيزيائيون سلطةً خاصة، وقدرةً فريدةً على التنقل بين هذه العوالم، والتحدث باسم واقع “حقيقي” لبشريةٍ ناقصة.
هذا التقسيم بين عالم من الصفات الجوهرية (المادة، والشكل، والجوهر) وعالم من الصفات الثانوية (اللون، والصوت، والذوق، والعاطفة، والفكر، وما إلى ذلك) هو ما أسماه الفيلسوف والرياضي ألفريد نورث وايتهيد، في عشرينيات القرن العشرين، “تشعب الطبيعة”. ومن خلال مغالطة، سماها ” مغالطة الواقعية الخاطئة”، أي “خطأ الخلط بين المجرد والملموس”، اعتبرنا عالم المجرد – العالم المُعطى للفيزياء – أكثر واقعية ، مُنشئًا وسببًا للثاني .
لا ينبغي أن يُفاجئنا أننا نعيش في زمنٍ يُعطي الأولوية، على ما يبدو، للواقع المادي والفيزيائي والموضوعي على ما يُظنّ غير مادي وعقلي وذاتي. فكثيرًا ما يكون الأمر مختلفًا. في الواقع، ووفقًا لوايتهيد، فإن هذا التشعب عرضي ويتوافق مع طريقةٍ خاصةٍ جدًا توصلنا من خلالها إلى تشكيل الواقع. فمن خلال النجاحات العديدة التي حققتها الفيزياء، ارتكبنا خطأ الاعتقاد بأنه لمجرد أن العالم قابلٌ للتحليل الفيزيائي، فإن الكون ماديٌّ في جوهره.
كيف إذن يمكننا أن نأخذ إمكانية الاختلاف على محمل الجد؟ وكيف يمكننا أن نتخيل عالمًا مُصممًا بشكل مختلف دون أن نتخلى بغباء عن الأفكار العديدة التي قدمتها لنا الفيزياء؟ تتطلب الإجابة على هذه الأسئلة مواجهة ما وصفه عالم النفس والفيلسوف ويليام جيمس، المعاصر الذي أثر بشكل كبير على وايتهيد، في كتابه “البراغماتية” (1907)، بأنه “أهم المشكلات الفلسفية”: الواحد والتعدد.
وعلى النقيض من الاعتقاد السائد بأن العالم هو واحد غير قابل للتجزئة، يلاحظ جيمس أن العالم قد يكون من الأفضل فهمه باعتباره واحداً ومتعدداً، وهو عالم ينكشف بقدر ما نواجهه على هذا النحو.
إن الفكرة التي يسعى إليها جيمس جذرية بقدر ما هي بسيطة، وتتناقض مع مدى نجاح الفلسفة والبحث العلمي. فعند التأمل، يبدو أنه لا يوجد ما يدعم افتراض الوحدة الكلية أو النهائية للعالم، ولا يبدو أن التجربة قادرة على تأكيد مفهوم الانقسام المطلق. وكما أشار جيمس في كتابه “الكون التعددي” (1909)، فإنه لم يجد “مبررًا كافيًا حتى للشك في وجود أي واقع ذي قيمة أعلى من ذلك النوع الموزع والمترابط والمتدفق من الواقع الذي نسبح فيه نحن الكائنات المحدودة”. ومع ذلك، غالبًا ما كان هدف العديد من أشكال البحث هو السعي نحو تمييز واقع ثابت ومفرد، أو أحد جوانبه.
يطلب منا “الكون المتعدد” أن نقبل أن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها التعرف على العالم والتواجد فيه
لذا، يقترح جيمس وجود كونٍ متعدد، أو “كون متعدد”، حيث لا تكون وحدة العالم وتعدده من سمات العالم كما هو، بل كما يصير . الكون المتعدد، قبل كل شيء، هو عالمٌ في طور التكوين. يبقى إلى الأبد غير مكتمل، ويحجب إجابة وحدته أو انقسامه، تاركًا إياه سؤالًا للبحث التجريبي المستمر.
لأخذ هذه الفكرة إلى أقصى درجات تطرفها، فإنها تطلب منا تقبّل وجود طرق عديدة لمعرفة العالم والوجود فيه، وأن نأخذ على محمل الجد الحقائق التي تقترحها المعارف والممارسات والثقافات الأخرى على أنها حقيقة واقعة . إلا أن “الأخذ على محمل الجد” يتجاوز مجرد تسامح ليبرالي. وكما قالت فيلسوفة العلوم إيزابيل ستينجرز عام ٢٠٠٣: “قد يبدأ الاختبار الأخلاقي… بمحاولة تصور أن الآخرين سيتحملونك “.
هذا لا يعني وجود عالم واحد يسعى لاستيعاب جميع التعددات. كما أن “الأخذ على محمل الجد” ليس ضربًا من النسبية الساذجة، حيث يُتوقع من حقائق مختلفة أن تتعايش بالتساوي دون دراسة نقدية لكيفية تقاطعها وتداخلها واحتمال تناقضها. التحدي أصعب بكثير من أيٍّ من هذين: بل هو دعوة للسماح لهذه الحقائق بأن تُقلقنا نحن أيضًا.
يُشير هذا إلى ضرورة أخذ إمكانية وجود عوالم أخرى على محمل الجد. لا أقصد بذلك التكهنات المألوفة حول تعدد الأكوان، أو فرضية العوالم المتعددة ، التي طرحتها الفيزياء لتفسير عدم تحديد الكون المستمر. بل أقصد أخذ العوالم التي رفضتها الفيزياء والواقعية الحديثة على محمل الجد. أي العوالم التي، على سبيل المثال، تكون فيها كائنات السكان الأصليين على الأرض حقيقية، وتُعتنى فيها أشباح أفراد العائلات اليابانية، وحيث يرد الله على المؤمنين الإنجيليين الذين يتحدثون معه.
هذا يشير أيضًا إلى العودة إلى التشكيك العلني في ادعاءات الفيزياء. فبينما كانت تُعقد نقاشات عامة واسعة بين الفيزيائيين والفلاسفة حول طبيعة الزمن ومدى قدرة الفيزياء على التعبير عن الواقع، نادرًا ما تكون النقاشات العامة بين الفيزياء والفلسفة جدية اليوم. بل على العكس، عندما تُناقش أسئلة مماثلة في المجلات الفلسفية، تُحسم غالبًا احترامًا لادعاءات الفيزياء.
لا شك في الإنجازات الهائلة للفيزياء الأساسية. علاوة على ذلك، قد تُكافأ رهاناتها التخمينية بمرور الوقت. إلا أن هذه الرهانات تركت المجال مبهمًا، إذ لم تُلبِّ توقعاتها العالية، وجعلت ممارسيها، الذين يُعتقد أنهم الأقرب إلى الواقع، أبعد ما يكون عنه.
استجابةً لذلك، نحتاج إلى فيزياء أكثر تواضعًا، لا تقلّ جذريةً في طموحاتها التخمينية، بل تُدخِل رؤىً متناقضة في مقترحاتها، لا رؤىً خاضعةً لمزاعم الفيزياء فحسب. في هذا، سنحصل على فيزياء أكثر جرأةً، فيزياء تقبل وتدعو إلى نقد الممارسات والتخصصات الأخرى في مأزقها الحالي.
من الناحية العملية، سيتيح ذلك إمكانية دمج الفيزياء مع مجالات أخرى. الفيزياء الحيوية وفيزياء المناخ مثالان جيدان على ذلك. فعلى عكس علم الكونيات والفيزياء الأساسية، لا ترتكز هذه العلوم على تفوق مجال على آخر، بل تدرك حدودها ومجالات تطبيقها المحدودة.
لكن قد نتجه إلى ما هو أبعد من ذلك، فنبتعد عن النهج الفيزيائي البحت، ونحتضن أنماطًا تُرفض باعتبارها مجرد خيال أو قصة أو “غير مادية”، لنعيد النظر في الفيزياء بنقاشات ورؤى وتكوينات بديلة للواقع. قد يتطلب هذا منا التخلي عن مكانة الفيزياء المتميزة كحاملة لواء العلم، كما فعلنا مع الفلاسفة وكهنة العصور القديمة، باعتبارها الممارسة التي تتمتع بإمكانية فريدة للوصول إلى واقع أعمق وأكثر جوهرية من غيرها.
قد يتطلب الأمر منا التخلي عن الفيزياء كليًا، سعيًا وراء واقع أوسع لا يقبل فحسب، بل يشجع أيضًا على إمكانية الاختلاف وأكثر. أو، كما قالت كاتبة الخيال العلمي أورسولا لو جوين ، ما نحتاجه هو “واقعيون لواقع أوسع”.