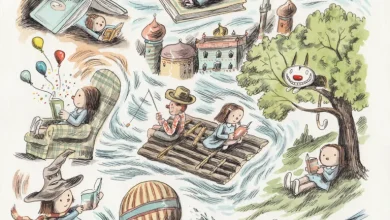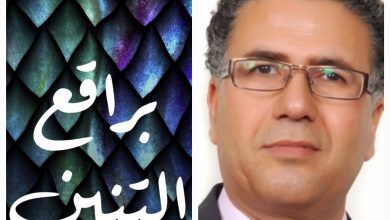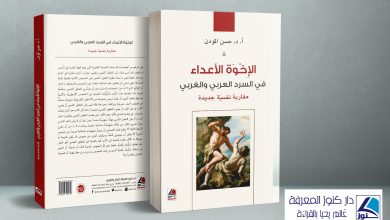هشام جعيط و أزمة الثقافة الإسلامية

لوسات أنفو : أيوب داهي
ظلت الرقعة العربية و لمدة طويلة مركزا للخلافة و الحضارة و الثقافة في مناطق مثل بلاد الشام و العراق ثم في مصر و بلاد المغرب ، لكن الضربات المغولية و التيمورية ثم الاحتلال العثماني، أحدث في هذه الربوع انهيارا فسباتا عميقا. فغياب الدولة و تنامي الخصوصيات المحلية ، دفع كل بلد الى الانطواء على ذاته دون معرفة بما يجري في العالم من تحولات في القرون ( 16,17,18,19) حتى باغتها الاستعمار. في لحظة الاستعمار هاته التي وضعت فيها أروبا الظافرة يدها على تونس و مصر على التوالي ( 1881و 1882) لتسيطر عليها سيطرة مباشرة ، كانت النهضة العربية اللغوية و الأدبية في ذروتها من إحياء للغة و انتشار الصحافة و التأليف و الترجمة ، كما كانت اصلاحية جمال الدين الافغاني في أوجها و هو يتصور إمكانية محاكاة الإصلاح البروستانتي بإصلاح إسلامي ينتج عنه إصلاح مدني سياسي. كان العالم الإسلامي في حركة إسترداد واع منذ أكثر من نصف قرن ( منذ استعمار الجزائر) كان يعي صعود أروبا و تأخره و ضرورة تجاوز هذا التأخر دون ان يضحي بذاته مقابل ذلك، كان الأفغاني مسكونا بشعور شديد بإنحطاط حضارته و كان يود ان يكون الاسلام قاعدة لكل نهوض، استكمل محمد عبده هذا الطريق عبر التأكيد على التوحيدية ، جاعلا منها سلاحا قويا لمقاومة الطبيعة الصوفية الطرقية. هنا يكمن الاسهام الحاسم للإصلاح- الديني : تطهير الإسلام و العودة الى الماضي المبكر النقي و رفض الوساطات دون الذهاب الى حد الغلو الوهابي. في أواسط القرن التاسع عشر اذا ، بدا العالم العربي على أعتاب تحوّل فكري كبير، تحوّل أراد أن يعيد للأمة العربية مكانتها اللغوية والثقافية بعد قرون من الركود والانحطاط. كانت الصحافة تزدهر، والمطبعة تنشر الكتب والمجلات، والمدارس الحديثة تفتح أبوابها أمام جيل جديد من المثقفين والمصلحين.
اجهض الاستعمار هذا المسار ، يقول هشام جعيط ” بعد صدمة الحداثة عام 1798 , لم يفهم المسلمون ان اروبا جنت ثمار القطيعة مع ركنها الديني اي ممارسة فعل التنوير و هو نقد مزدوج للدين و السلطة “. فقد كان السياسيون الأوائل أمثال محمد علي يعقلون بشكل أو بآخر رسالة الأنوار، باستثناء وضع المعطى الديني على المحك. كان اهتمامهم منصبا على التمدن اي تحقيق التقدم من حيث الحضارة و القوة. فرفاعة رافع الطهطاوي مثلا كان يبحث عن صيغة تسمح للبلدان الاسلامية باستعادة قوتها باتخاذ موقف إيجابي من الثورة الصناعية و العلمية ، لأن الأمر يتعلق بمسألة إمتلاك و ليس بأي شيء يمس الذات الحميمية لاسيما مسألة القيم.
التنوير الاروبي اذا حسب جعيط سعى الى إسقاط العالم القديم بكل مرتكزاته الثقافية ، أما التنوير الإسلامي فكان يبحث عن الوسط أو التركيب. وقف التيار الإسلامي الاصلاحي ضد كل محاولة للتقليل من قيمة الدين الإسلامي و الدفع بمزيد من التدين و تنقيته و العودة لممارسة السلف الخالية من الشوائب. يؤكد جعيط ان النهضة العربية ، كانت محاولة لإيجاد توازن بين المحافظة و والتحديث ، بين العودة إلى التراث الأصلي النبوي والانفتاح على منجزات الغرب العلمية و التقنية . غير أن الاحتلال أفرغ هذا التوازن من مضمونه، فوضع هذا الجيل من المصلحين في موقع الدفاع بدل المبادرة، وجعل من مهام التحرر الوطني أولوية ملحة على المشروع الفكري، وأجبر الثقافة على الانشغال بالحفاظ على الهوية في وجه الهيمنة الأجنبية. وهكذا تحولت النهضة من مشروع تاريخي آني إلى إرهاصات مؤجلة ، انشغل جزء من هذه النخبة بالمقاومة السياسية، وانشغل جزء آخر بالمحافظة على التراث، تاركين الجيل العربي أمام فجوة بين ما كان يمكن أن يكون وما أُجبر على أن يكون.
اليوم، حين نسترجع تلك المرحلة، ندرك أن رواد النهضة لم يكونوا مجرد مثقفين، بل كانوا مؤسسين لجيل حاول أن يفتح أبواب التطور والفكر، لكنهم اصطدموا بحائط قوة استعمارية لم تمنحهم الفرصة لاستكمال مشروعهم. إن سقوط مصر وتونس كان إعلانًا عن بداية مرحلة جديدة من الصراع، مرحلة لم يعد فيها النقاش حول الإصلاح الديني واللغوي منفصلًا عن معركة التحرر الوطني. ومن هذه الزاوية يمكن فهم هشام جعيط عندما يؤكد أن النهضة العربية، رغم إرثها الكبير، ظلت مشروعًا ناقصًا، وأن الأمة العربية تدفع اليوم ثمن ذلك الزمن الضائع، وتظل بحاجة إلى استكمال ما بدأه رواد الفكر والثقافة في زمن لم يكن يسمح فيه الاحتلال بالازدهار الكامل للأمة.