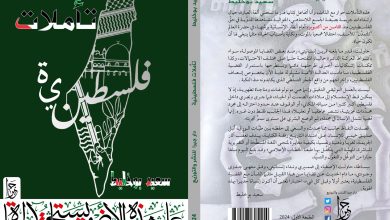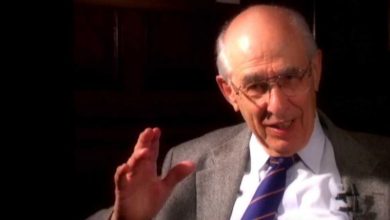علوم الملائكة .. كيف طورت فكرة الملائكة الفيزياء و غيرت مفهوم المكان

ريبيكا ولاس/ زميلة بجامعة أوكسفورد و باحثة في الفلسفة و الدين
أي علاقة للقوى الملائكية بالنشوة الجنسية؟ الإجابة، وفقًا للفيلسوف واللاهوتي موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر، بسيطة. بعض القوى الخفية التي تُسبب الحركة يمكن تفسيرها بأن الله يعمل من خلال الملائكة. ونقلًا عن حاخام شهير تحدث عن “الملاك المُكلَّف بالشهوة”، علَّق موسى بن ميمون قائلًا: “إنه يقصد أن يقول: قوة النشوة الجنسية… ولذلك تُسمى هذه القوة أيضًا… ملاكًا”.
قبل اكتشاف الجاذبية والطاقة والمغناطيسية، لم يكن واضحًا سبب سلوك الكون بهذه الطريقة، وكانت الملائكة إحدى طرق تفسير حركة الأجسام المادية. جادل موسى بن ميمون بأن الكواكب، على سبيل المثال، هي كائنات ملائكية لأنها تتحرك في مداراتها السماوية.
بينما يرفض معظم الفيزيائيين اليوم فكرة القوى الملائكية كتفسير لأي ظاهرة طبيعية، لولا الإيمان بالملائكة في العصور الوسطى، لكانت الفيزياء اليوم مختلفة تمامًا. حتى بعد أن تبددت هذه الفكرة لاحقًا، استمر الفيزيائيون المعاصرون في افتراض وجود ذكاءات غير مادية للمساعدة في تفسير ما لا يمكن تفسيره. ظهرت قوى ملائكية شريرة (أي الشياطين) في تجارب فكرية مؤثرة عبر تاريخ الفيزياء. وقد مثّلت هذه “شياطين الفيزياء” المعروفة بدائل مفيدة، ساعدت الفيزيائيين على إيجاد تفسيرات علمية لحلول غامضة. ولا يزال من الممكن العثور عليها في الكتب المدرسية اليوم.
لكن هذا ليس الإرث الأهم لعلم الملائكة في العصور الوسطى. فقد أثارت الملائكة أيضًا نقاشات حادة ودقيقة حول طبيعة المكان والأجسام والحركة، مما ألهم ما يشبه مجموعة أدوات مفاهيمية حديثة للفيزيائيين، صقل مفاهيم مثل الفضاء والبُعد. باختصار، تُشكل الملائكة أساس فهمنا للكون.
وُجدت الملائكة منذ العصور التوراتية على الأقل، ووُصفت بطرق مختلفة، بل غريبة أحيانًا. ففي سفر حزقيال، على سبيل المثال، للكروبين عجلات متقاطعة تلمع كالياقوت الأزرق، تُحركهم في جميع الاتجاهات الأربعة دون دوران، وكانت “أجسادهم، بما في ذلك ظهورهم وأيديهم وأجنحتهم، مليئة بالعيون، وكذلك عجلاتهم الأربع”. ومع ذلك، فإلى جانب هذه الملائكة ذات العيون الجاحظة، كانت الملائكة أيضًا، كما نرى من موسى بن ميمون، وسيلة لتفسير الحركة في العالم. كانت جواهر روحية يمكن أن تتخذ مظهر الكائنات الجسدية، ولكنها كانت أيضًا بمثابة قوى غير مرئية، ذكية، وغير مادية.
أصبحت هذه النظرة للملائكة كـ”ذكاءات” غير مادية سائدة في فلسفة العصور الوسطى وعلم اللاهوت. لكن الفترة المدرسية شهدت رغبة متزايدة في التنظيم المنهجي. أصبحت طبيعة الملائكة أو جوهرها الدقيق سببًا جديًا للنقاش، ولم تكن هذه النقاشات مجرد تجارب فكرية. بل بسبب الإيمان الحقيقي بوجود الملائكة، استطاع اللاهوتيون والفلاسفة التفكير من خلال الملائكة كوسيلة لفهم طبيعة العالم المادي وأشياء مثل المكان والأجسام والحركة. وقد حفز ذلك مخاوف لاهوتية مهمة. أحد هذه المخاوف هو: إذا كانت الملائكة ذكاءات غير مادية، فما الذي يجعلها مختلفة عن الله؟ بالنسبة لنا، أجسادنا هي ما يجعلنا محدودين، قادرين على ممارسة القوة بشكل مباشر فقط، كما هو الحال عندما أرمي الكرة. هل يعني هذا أن الملائكة، بلا أجساد، يمكن أن توجد في كل مكان أو أن تتصرف عن بُعد؟ كان هذا مجالًا خطيرًا لعلماء اللاهوت، مما قد يتحدى وجود الله الكلي وقدرته المطلقة.
كان الرأي السائد هو أن الملائكة يجب أن تكون موجودة (أي محدودة) ولكن بدون جسد. وقد ناقش علماء لاهوت بارزون، مثل بيتر لومبارد، وتوما الأكويني، وبيتر جون أوليفي، وجايلز الروماني، وإسكندر هيلز، وجون دنس سكوتس، والقديس بونافنتورا ، وغيرهم الكثير، مسألة تحديد موقع الملائكة. لم يكن هذا موضوعًا هامشيًا، مقتصرًا على المتشددين والعلماء، بل كان ذا أهمية بالغة في النقاشات التي حددت حدود الفيزياء والفلسفة واللاهوت وعلاقاتها. وقد شجع علم الملائكة، وتركيبه مع فيزياء عصره، المفكرين اللاحقين على التفكير في طبيعة الأجسام والمكان والحركة، ولكن الأهم من ذلك، في كيفية ارتباطها ببعضها البعض.
إن مفتاح فهم الجدل حول الملائكة في العصر المدرسي يكمن في فهم الأدوات المفاهيمية التي وفرتها فيزياء ذلك العصر. في الواقع، كانت هذه الفيزياء أرسطو. لقد شكّلت طريقة تصور الفيلسوف اليوناني للمكان والحركة والأجسام نظرة العصور الوسطى للعالم بشكل عميق. وقد استعان بعض أبرز علماء اللاهوت في ذلك العصر، مثل توما الأكويني، بأرسطو للتفكير في طبيعة الموقع الملائكي.
بالنسبة لأرسطو، كانت الفيزياء ببساطة تتعلق بالأشياء المتحركة، وحسب رأيه، لا تتحرك الأجسام بسبب الجاذبية أو الطاقة الحركية أو تشوه الزمكان، بل بسبب طبيعتها. فطبيعة النار، على سبيل المثال، هي التحرك لأعلى، وطبيعة الأرض هي التحرك لأسفل. ولهذا السبب تلعق النار الهواء، فتسقط الصخور .
وبالمثل، لم يكن هناك مفهوم للفضاء المطلق، بل مفهوم “المكان”، الذي، على عكس الفضاء المطلق لنيوتن أو الزمكان لألبرت أينشتاين، لا يوجد مستقلاً تمامًا عن الأجسام التي تسكنه. وكما تشير الفيلسوفة تيزيانا سواريز-ناني في كتابها ” الملائكة والفضاء والمكان” (2008)، فإن “الفضاء… كوعاء متجانس وغير متمايز، كان غريبًا على العقل القروسطي”. بالنسبة لأرسطو، لا يمكن للأجسام أن توجد بدون مكان، الذي كان بمثابة وعاء. وبالمثل، كان لا بد من وجود أجسام ليكون هناك مكان. بمعنى آخر، الفراغ غير ممكن من وجهة نظر أرسطو.
بدوره، أثّر مفهوم أرسطو عن الأجسام والمكان على فهم علماء العصور الوسطى للحركة. كان الرأي السائد هو أن للأجسام طبيعة تُحرّكها. هذه الطبيعة تُحرّكها في اتجاه مُحدّد ، لذا يجب أن يكون المكان أيضًا اتجاهيًا بطبيعته. نفهم الآن أن الاتجاه داخل الفضاء نسبي فقط لنقطة مرجعية ابتدائية؛ فالكون كما نعرفه ليس له “أعلى” أو “أسفل” مُطلق. ولكن في النظرة العالمية الأرسطية، تُمثّل الحافة الخارجية للكرات السماوية المرجع المُطلق لـ”أعلى”، مع كون الأرض نقطة ثابتة في المركز. لذا، كان مفهوم المكان مُرتبطًا بمفاهيم “أعلى” أو “أسفل” أو “يسار” أو “يمين”. لم يكن المكان محايدًا، بل كان مُحمّلًا بالاتجاهات، ويُمارس قوة على الأجسام لأن الأجسام تستجيب لنداء المكان وفقًا لطبيعتها. يمكن للنار أن تنتقل إلى مكان “أعلى” ولكن ليس إلى مكان “أسفل” وهكذا.
باختصار، ربطت فيزياء أرسطو بين الأجسام والمكان والحركة، وكل منها يعتمد على الآخر.
اقترح توما الأكويني أن الملاك له نوع مختلف من الموقع مختلف عن الكائن الجسدي.
إذن، ما علاقة ذلك بالملائكة؟ إذا كنت تتذكر، فقد كانت الاهتمامات اللاهوتية في ذلك الوقت تشترط أن يكون للملائكة موقع محدد – أن يكونوا محدودين وغير أجساد – لتجنب الملائكة ذوي القوة اللامحدودة، مما يجعلهم كليي القدرة وحاضرين في كل مكان. ولأن فيزياء أرسطو كانت الفيزياء السائدة في ذلك الوقت، فقد عمل علماء العصور الوسطى على تفسير مشكلات الموقع هذه في إطاره.
اقترح توما الأكويني أن الملاك له نوع مختلف من الموقع عن الكائن الجسدي
عادةً ما يُحدد الجسم المادي للشيء موقعه، فكيف يُمكن تحديد موقع الملائكة غير المادية؟ حلّ توما الأكويني وآخرون هذه المشكلة بإبداع، مُحددين مواقع الملائكة ليس من خلال بُعدهم المادي، بل من خلال عملياتهم. اقترح توما الأكويني أن للملاك موقعًا مختلفًا عن الكائن الجسدي. يكون الملاك في مكان ما بفضل تطبيق قوته على الأشياء المادية في مكان مُحدد. هذا حدّ من عمليات الملاك وموقعه، إذ تم تحديد موقعه من خلال عملياته، لا من خلال جسده.
لكن فيزياء أرسطو أثارت مخاوف كثيرة لدى بعض قادة الكنيسة في القرن الثالث عشر. فإذا كان الجسم لا يمكن أن يوجد بدون مكان، فهذا يحد من قدرة الله. زعم البعض أنه لو أراد الله، لكان قادرًا على خلق صخرة غير موجودة في مكان، لكن رؤية أرسطو للمكان والأجسام جعلت ذلك مستحيلًا. لذا، عندما أصبحت طبيعة الملائكة مجالًا للتفكير في طبيعة العالم، أصبح موضوعًا شائكًا للغاية.
وصلت مسألة الملائكة إلى ذروتها بشكل مفاجئ عندما نشر أسقف باريس ستيفن تيمبييه إداناته عام 1277، وهي قائمة تضم 219 أطروحة مُنع الكاثوليك من طرحها أو تدريسها في الجامعة. كان هذا جزءًا من رفض أوسع لأرسطو وغيره من الفلاسفة “الوثنيين”. غطت هذه الأطروحات مواقف فلسفية ولاهوتية مختلفة، ولكن 28 من أصل 219 أطروحة كانت تتعلق بالملائكة المعروفة أيضًا باسم “الجواهر المنفصلة” أو “الذكاءات”. كان لبعض هذه الأطروحات علاقة بطبيعة موقع الملائكة وعملها. والأهم من ذلك، أن إدانات عام 1277 منعت الاعتقاد بأن الملائكة تُحدد من خلال عملياتها وليس من خلال جوهرها، لذا أصبح حل توما الأكويني لموقع الملائكة غير وارد الآن. إذا كان الملاك موجودًا في مكان ما فقط من خلال عملياته، كما ادعى توما الأكويني، فماذا يحدث عندما لا يكون فاعلًا؟ كان لا بد من إعادة النظر في الملائكة. ما هي طبيعتها وجوهرها بحيث يمكن أن تكون غير مادية ومحددة الموقع في آن واحد؟ يتطلب هذا القيد من العلماء مزيدًا من الإبداع.
جاءت أبرز مناورات دونس سكوتس . أعاد علم الملائكة الذي ابتكره تعريف مفهوم المكان الذي كان محوريًا في الفيزياء الأرسطية والعصور الوسطى، وكما أشارت هيلين لانج في كتابها ” فيزياء أرسطو وأنواعها في العصور الوسطى ” (١٩٩٢)، فإن هذا سيُغير معالم الفيزياء إلى الأبد.
كما رأينا، كان لا بد من تحديد موقع الملائكة وقدرتهم على العمل بقدرة محدودة، وإلا لكانوا حاضرين في كل مكان وقدرة مطلقة كالله. لكن إدانات عام 1277 منعت صراحةً تفسير توما الأكويني، القائل بأن الملائكة موجودون في مكان ما وفقًا لأفعالهم. كان التحدي الذي واجهه مفكرو العصور الوسطى هو إيجاد طريقة لتحديد موقع الملاك من خلال جوهره، دون أن يكون جوهرًا جسديًا، وتحديد عملياته، ولكن دون أن تكون هذه العمليات العامل الوحيد في تحديد موقع الملائكة.
من الابتكارات التي أدخلها سكوتس للتغلب على هذا القيد المزدوج إعادة تعريفه لمفهوم “المكان”. فعل ذلك لحل المشكلة اللاهوتية المتمثلة في قدرة الله على خلق صخرة خارج المكان، وهو أمر ادعى علماء اللاهوت أن الله قادر عليه، لكن حله ينطبق أيضًا على الموقع الملائكي. وبذلك، أدت إعادة تفكيره الإبداعية في الفيزياء إلى مفاهيم جديدة وإعادة صياغة مفاهيم قديمة، مما شكّل الفيزياء الحديثة بشكل جذري .
إليكم ما فعله سكوتس: لقد جعل “المكان” أكثر رياضية، وأقل ارتباطًا بالموقع وأكثر تشابهًا مع مفهومنا عن البعد. عند التفكير فيه من حيث البعد، فإن “المكان” الذي يشغله الشيء يبقى كما هو أثناء تحركه عبر المواقع. بهذا المعنى، فإن “مكانه”، الذي أعيد تعريفه كبُعد، هو نفسه، حتى لو تغير موقعه. بعبارة أخرى، سكوتس، كما ذكر لانغ ببراعة، “يحيد” المكان جذريًا. وفقًا للرواية الأرسطية، كان الاتجاه أو الموقع جزءًا من تعريف “المكان”. عند إعادة تعريفه رياضيًا أكثر كنوع من البعد، لم يعد الاتجاه سمة ضرورية لهذا النوع الجديد من “المكان”. يمكنك الحصول على فكرة أشبه بكثير بفكرة “الفضاء”، وهو شيء لا يحتوي بطبيعته على “أعلى” أو “أسفل” أو “يسار” أو “يمين” في تعريفه.
الملائكة، لأنه ليس لديهم أبعاد، لا يمكن أن توجد إلا في مكان محدد بطريقة غير محددة
من الناحية الفنية، يعني هذا أن الله قادر على خلق صخرة في لا مكان، إذا كان المكان يُشير إلى تعريف أرسطو للمكان، وهو موقع داخل الحافة الخارجية للمجالات السماوية. بينما عرّف أرسطو المكان كسمة تعريفية ضرورية للأجسام المادية، لم يفعل سكوتس ذلك. بل وضع سردًا هجينًا يمكن فيه لشيء ما أن يوجد داخل الحافة الخارجية للمجال السماوي (يشغل مكانًا بالمعنى الأرسطي)، ولكن ليس بالضرورة ؛ بل يمكنه أيضًا أن يشغل حيزًا من خلال بُعد خارج تلك الكرة.
إذن، لدينا هنا خلق مفاهيم جديدة، نوع من مقدمة للبعد والفضاء، وإعادة ترتيب المفاهيم القديمة، وفصل “المكان” عن علاقة ضرورية بالأجسام. بالنسبة لسكوتس، كان من الممكن وجود مكان أرسطو، لكنه لم يُعرّف الأجسام. إذا وُجد شيء ما في “المكان” الأرسطي، فذلك بمشيئة الله، وبسبب ما يُسميه سكوتس “القوة المنفعلة”، والتي تعني ببساطة أنه قادر على الوجود في مكان ما دون أن يتعارض مع طبيعة الشيء.
هذه الفيزياء الجديدة تركت الباب مفتوحًا للملائكة. يجادل سكوتس بأن الملائكة أيضًا تمتلك القدرة السلبية على الوجود في مكان ما بمشيئة الله، لأنه في هذه الفيزياء الجديدة، لم يعد المكان والجسد مُعرّفين لبعضهما البعض. ولكن بخلاف الأجسام المادية، التي يجب أن توجد بطريقة محددة في مكان محدد، فإن الملائكة، نظرًا لعدم وجود أبعاد لها، لا يمكنها أن توجد إلا في مكان محدد بطريقة غير محددة. الصورة التي يستخدمها لانج، مستشهدًا بسكوتس، هي لسطح يجب أن يكون له لون، ولكن يمكن أن يكون لونه أي شيء. يمكن للملائكة أن تشغل مكانًا مهما كان صغيرًا أو كبيرًا، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، ويجب أن تعمل في مكان ما، على الرغم من أنها موجودة في المكان بشكل غير محدد.

أتاحت هذه إعادة النظر الجذرية في فيزياء أرسطو، والتي حفزتها نقاشات العصور الوسطى حول علم الملائكة، فهمًا جديدًا للعلاقة بين الأجسام والمكان والحركة، مما ساعد على إعادة صياغة فهمنا لبنية الكون. بالنسبة لأرسطو، كانت الحركة متأصلة في الأجسام، لأن للأجسام طبيعةً تجعلها تبحث عن مكانها الطبيعي. كان افتراض الملائكة كقوى خارجية غير مادية أقرب بشكل غريب إلى الفيزياء الكلاسيكية التي ترى قوةً خفيةً كالجاذبية تؤثر على الأجسام خارجيًا. في الواقع، اتهم غوتفريد فيلهلم لايبنتز نيوتن بإدخال قوى خفية في نظريته عن الجاذبية، لأن الجاذبية بدت قوةً خارقةً تؤثر على الأجسام عن بُعد.
لم تختفِ التجارب الفكرية التي استخدمت الملائكة والشياطين في العصر الحديث، لكنها تغيّرت شكلها. واستمرت الكائنات الخفية، التي يُشار إليها غالبًا الآن باسم “الشياطين”، في لعب دورٍ هام في تطوير الفيزياء. (لاهوتيًا، لا يوجد فرق يُذكر بين الشياطين والملائكة من حيث تكوينهم الميتافيزيقي. الشياطين فئة فرعية من الملائكة؛ إنهم ملائكة ساقطة ).
في القرن التاسع عشر، كان شيطان بيير سيمون لابلاس (الذي يسميه هو نفسه مجرد ذكاء، وهي كلمة تُستخدم غالبًا لوصف الجواهر الملائكية في العصور الوسطى) كائنًا يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة تُمكّنه من معرفة جميع قوى الكون وموقع كل ذرة. علاوة على ذلك، يتمتع هذا الكائن بقوة حسابية لا متناهية، يُمكنه استخدامها لحساب مسار كل ذرة. اعتقد لابلاس أن هذا سيُنتج قوة تنبؤية لا متناهية، وبالتالي يُمكن لهذا الذكاء الفائق معرفة تاريخ العالم بأكمله ومستقبل الكون في نهاية المطاف. ستُشكك ميكانيكا الكم لاحقًا في هذه الحتمية.
في تجربة فكرية لاختبار القانون الثاني للديناميكا الحرارية عام ١٨٦٧، تخيّل الفيزيائي الفيكتوري جيمس كليرك ماكسويل كائنًا افتراضيًا («عاملًا») يتمتع بقدرة خارقة على تحديد مواقع الجزيئات. وصفه معاصره ويليام طومسون (الذي أصبح لاحقًا اللورد كلفن) بالشيطان، وظلّ هذا الاسم سائدًا. كشف «شيطان ماكسويل»، الذي لا يزال يُطلق عليه هذا الاسم حتى اليوم، عن روابط عميقة بين المعلومات والإنتروبيا، مما طوّر فهمنا التجريبي للعالم.

أخيرًا، مع مطلع القرن التاسع عشر، أصبح شيطان فيلون-بيرسون – الذي اقترحه لويس فيلون وكارل بيرسون – ما يُسمى بـ”زميل شيطان ماكسويل”. كان بإمكانه السفر بسرعات خارقة، والانتقال الآني، والتصرف عن بُعد.
ساهمت ردود الفعل ضد استخدامات التفسيرات الخارقة للطبيعة في الفيزياء، حتى في صورة تجارب فكرية، في تطور الفيزياء. على سبيل المثال، لا بد أن أينشتاين قد قرأ أعمال بيرسون، وقد أدى نفوره من استخدام التفسيرات الخارقة للطبيعة إلى تعريف عمله بعلاقة سلبية مع القوى الخفية. زعم عالم الفلك آرثر إدينغتون أن أينشتاين طرد شيطان الجاذبية. ويزعم أينشتاين نفسه أنه طرد “أشباح” الزمان والمكان المطلقين بنظريته النسبية.
لكن هل كان بإمكان أينشتاين أن يحقق ما حققه لولا الإيمان المسبق بالملائكة؟ لا شك أن اللاهوت حفّز البحث عن تفسيرات بديلة تتعلق بالمكان والحركة والأجسام. ومع أن طبيعة الملائكة، كموضوع محوري ، كانت المحفز للنقاشات حول فيزياء المكان، إلا أن الباحثين فكروا أيضًا من خلال الملائكة لفهم طبيعة العالم المادي وعلاقته بالكون الأوسع. وقد أفضى هذا إلى مفاهيم أكثر تعقيدًا عن المكان والفضاء والأبعاد، مما منحها معنى جديدًا. كان دور الملائكة في هذه التجارب الفكرية فريدًا: فقد تجاوزت العالم المادي البحت، لكنها ظلت “مخلوقات” تلتزم بالقواعد والمنطق الذي يحكم الكون.
في الواقع، كان هذا الدور الوسيط جزءًا من منطق وضع الملائكة في المقام الأول. تظهر الملائكة في الكتاب المقدس، لكن توما الأكويني اعتقد أنه يمكن تقديم حجج مسبقة لصالح الملائكة على وجه التحديد لأن سلسلة الوجود العظيمة لا يمكن أن تفوت أي حلقات. أي فجوات تعني أن البشر لا يمكنهم القفز إلى فهم الله. نحن بحاجة إلى بعض المعرفة الوسيطة التي من شأنها أن تكون جسرا بين معرفة الله ومعرفة العالم. هذا هو السبب في أن الملائكة، منذ وقت مبكر مثل ديونيسيوس الزائف في القرنين الخامس والسادس الميلاديين، كانت مساوية للغة. كما أن الكلام يتوسط بين عالم الأفكار والعالم المادي. وإلا، يمكن تفسير جميع أعمال الملائكة ببساطة من قبل الله. ومع ذلك، فإن الملائكة، على وجه التحديد بسبب وضعهم الوسيط، سمحت للبشر بالتفكير في أبعاد الواقع المخلوق التي تتجاوز مع ذلك تصوراتنا البشرية المباشرة.
وفي حين أنه من السهل بما فيه الكفاية السخرية من اقتراح أن الحركة هي نتيجة لقوى خفية مثل الملائكة، لا يمكننا، بعد أن صعدنا سلم المعرفة، أن نركل هذا السلم من تحت أنفسنا بسهولة. تُظهر الدراسات في الإدراك المتجسد أن معرفتنا مبنية على تجربتنا في العالم. يُظهر كتاب جورج لاكوف ومارك جونسون ” الاستعارات التي نعيش بها” (1980) كيف تتجمع تجاربنا الجسدية معًا لإنشاء استعارات معقدة، مما يؤسس للمفاهيم المجردة. نحن نساوي “أعلى” بـ “المزيد” عندما نقول “يرتفع سوق الأسهم” لأنه عندما نرى، على سبيل المثال، الصخور متراكمة، نتعلم أن نساوي الأعلى بالمزيد. نقول إننا “نستوعب” فكرة لأننا جربنا الوصول إلى قطعة من الفاكهة على شجرة. بالإضافة إلى ذلك، نواجه صعوبة بالغة في تخيل شيء غير مادي. ما نتخيله، عندما نتخيل روحًا أو ملاكًا أو شيطانًا، هو نوع من الأشياء غير الجوهرية، ولكنها لا تزال شبحية .
على الرغم من أن القوى الخفية كالملائكة والشياطين قد تُسخر منها الثقافة الحديثة باعتبارها تفسيرات سطحية لظواهر علمية منطقية وواقعية، إلا أنني أقترح العكس. فالأمر الأكثر واقعية قد يكون في الواقع التفكير في قوى الطبيعة غير المرئية كملائكة، أو فاعلين، أو ذكاءات غير مادية ذات خصائص مألوفة لنا، ولكنها مُضخمة. خصائص مثل الفاعلية والنية. فقط من خلال التفكير من خلال هذه المفاهيم المألوفة، وبواسطتها، يمكننا اكتشاف مجموعة من المفاهيم الأقل بديهية، مثل الزمكان، والتي تتطلب التأريض في مفاهيم مثل البعد والجسد والمكان والحركة. وقد شُحذت هذه المفاهيم الأساسية الضرورية، تاريخيًا، من خلال التفكير في العلاقة بين العالم المادي وغير المادي، ولعب علم الملائكة دورًا مهمًا في صقلها.
استمر استخدام العقول الخارقة للطبيعة، كالملائكة والشياطين، للتفكير في الفيزياء لفترة طويلة بعد أن تبدد الاعتقاد بوجودها. ويبدو أن هذا الإطار الخيالي يتردد صداه في البنية الفعلية لكيفية عمل تفكيرنا. وبفضل هذا، مهّد علم الملائكة الطريق للتفكير في طبيعة المكان والزمان والحركة بطرق معقدة للغاية. هل نحتت الملائكة والشياطين مساحة مفاهيمية للقوى الخفية التي ستكتشفها الفيزياء لاحقًا؟ مع أنه قد يبدو أن العلم والشيطان على طرفي نقيض عندما يتعلق الأمر بتفسير العالم الطبيعي، إلا أن الملائكة والشياطين قد شكّلوا في الواقع التفسير العلمي الحديث كما نعرفه اليوم.
المصجر: AEON