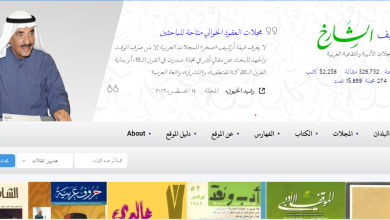جاك ديريدا: أود أن أتعلم كيف أعيش أخيرا
عندما أكتب أخترع نفسي في كلمات اللغة وأترك للآخرين أثر هذا الاختراع

مارك كريبون
“أود أن أتعلم كيف أعيش أخيرًا. «إذا كان صحيحًا أن هذه الجملة التي افتتحت بها «أشباح ماركس » (والتي كانت أيضًا بمثابة مقدمة للمقابلة) تشير إلى ما يسميه دريدا «قلق الميراث والموت» وخاصة إلى إمكانية تأكيد الحياة في المجتمع. التوتر ذاته الذي يسببه هذا القلق، لا يمكن فصله عن العلاقة المحددة باللغة والكتابة. ذلك لأننا لا ننتهي أبدًا من تعلم كيفية العيش (أو الموت)، لأننا لسنا متأكدين أبدًا من قدرتنا على الإجابة عن حياتنا وأسمائنا، خلال الوقت المخصص، لأنه لا شيء في هذا المجال يمكن تعلمه أو الاحتفاظ به بشكل نهائي مثل علاقتنا مع الآخرين. تتطلب اللغة اختراعًا فريدًا، متجددًا باستمرار، والذي لن ينحرف عنه دريدا أبدًا. إن مسألة المصطلح برمتها موجودة، حيث يتم تحديد بقائنا. ويشير إلى ضرورة ابتكار لغة أخرى داخل اللغة تتناسب مع هذا التعلم الفريد المرغوب فيه دائما والمستحيل إلى الأبد. ليس من السهل تلبية مثل هذا المطلب، كما أنه يفسح المجال للعديد من حالات سوء الفهم. إنه يتعارض مع الاستخدامات الأكثر تقليدية والأقل حرية أيضًا للغة. إنه يزرع التناقض، والارتباك، ويستخدم “المرادفات، وغير القابل للتقرير، وحيل اللغة” (ص 32) – حيث يطالب الرأي العام ووسائل الإعلام بإجابات أحادية ونهائية وقابلة للترجمة على الفور. هناك سمتان على الأقل تميزان المصطلح. أولاً، يتم تعريفها من خلال رفضها الاستسلام للترهيب من التبسيط، ومن خلال الحرب ضد العقيدة التي ترى نفسها، بهذه الحقيقة نفسها، مضطرة إلى خوضها بلا كلل.
ليس لدى دريدا كلمات قاسية بما فيه الكفاية للتعبير عن الخير القليل الذي يعتقده عن هذا الاستعداد الفلسفي للتفكير، الذي يدعي، بثقة وغطرسة، أنه بمثابة مكان لتعلم الحياة – هذا “الخطاب العام الذي صاغته القوى الإعلامية، التي تكون في أيدي جماعات الضغط السياسية والاقتصادية، وغالبًا ما تكون تحريرية وأكاديمية أيضًا […] إن الإنتاجات الجماهيرية التي تغمر الصحافة والنشر لا تشكل القراء، بل تفترض بطريقة خيالية وأولية لاعبًا مبرمجًا بالفعل “(ص. 29-32). في مثل هذه الإنتاجات، لا مجال للغة وإبداعها ومفارقاتها. لقد تم تصميم اللغة لتكون أداة تواصل شفافة، ويجب ألا يتعارض استخدامها أبدًا مع عقيدة التقبل الفوري. أما إذا كان المصطلح لا يحمل إلا خيط مطالبه بمعارضة كل الصيغ اللغوية، فإنه لا يخلو من مخاطب (السمة المميزة الثانية). والأمر الأكثر تطرفًا هو أنه بمجرد نشره على الملأ، فإنه لا يعود ملكًا للشخص الذي اخترعه. هذه هي مفارقة تفرده، التي عاد إليها دريدا في مناسبات عديدة، ولا سيما في أحادية لغة الآخر – والتي لا تزال تعيقه في مقابلته مع جان بيرنباوم. إن اختراع المصطلح الذي يهدف إلى أن يكون مفردًا تمامًا قد تم كشفه بشكل مضاعف.
إن تفرد الحدث، قبل كل شيء، هو الذي يؤدي إلى اختراعه، مثل هذا الشعور، ومثل هذا الإدراك، ومثل هذا اللقاء، ومثل هذا الفكر. إنها الرغبة في تحديد مصيري: «لو كنت اخترعت كتابتي، لفعلت ذلك كثورة لا نهاية لها. في كل موقف، من الضروري إنشاء طريقة مناسبة للعرض، واختراع قانون الحدث المفرد، مع مراعاة المتلقي المفترض أو المرغوب فيه؛ وفي الوقت نفسه، التظاهر بأن هذه الكتابة ستحدد القارئ، الذي سيتعلم قراءة (“العيش”) هذا، الذي لم يكن معتادًا على تلقيه في مكان آخر” (ص 31-32).
وبالتالي يمكن تعريف المصطلح، على عكس اللغة، باعتباره مشاركة في التفرد ــ وهي المشاركة التي، في نفس اللحظة التي تصبح فيها فعالة (على سبيل المثال، بمناسبة نشر كتاب) تحرم الشخص الذي بدأها. إذا كان التعلم عن الحياة مستحيلاً، فذلك لأن اختراع المصطلح الذي يطبقه يجعل منها تجربة متجددة باستمرار من الاستيلاء على الذات. وهذا هو قانون أثرها الذي يرسخ الارتباط البنيوي بين العلاقة مع اللغة والعلاقة مع الموت. في كل مرة أتكلم، وأكثر من ذلك عندما أكتب، في كل مرة أخترع نفسي في كلمات اللغة وأترك للآخرين أثر هذا الاختراع، أختفي في نفس اللحظة التي أظهر فيها. “أصبح، كما يكتب دريدا، “أظهر-أختفي، مثل هذا الشبح غير القابل للتعلم ، لن يتعلم أبدًا كيف يعيش… أترك قطعة من الورق هناك، أغادر، أموت: من المستحيل الهروب من هذه البنية، إنه الثابت”. شكل حياتي” (ص 33). وفي مثل هذه التجربة تتجلى القناعة والإيمان والأمل الذي تحمله ضمن ما تتذكره،ربما، الأجيال القادمة تحت اسم “التفكيك”.
ومع ذلك، كما يذكرنا جان بيرنباوم، فإن هذه اللغات لا يمكن فصلها عن لغة واحدة: الفرنسية، التي حافظ دريدا معها، كما أوضح مطولاً في كتابه “أحادية اللغة الأخرى” [1] ، على علاقة عاطفية. ومع خصوصية اللغة الوطنية، فإن قانون اللغة يتضمن في الواقع علاقة مزدوجة. بادئ ذي بدء، فإن المطالبة بالتفرد التي تسكنها تدحض كل أوهام السيطرة والملكية والانتماء. إن التحدث عن لغة بدلاً من “اللغة الأم” أو “اللغة الوطنية” يعني القول بأن اللغة لا تنتمي إلى أي شخص، وأنها لا تشير إلى أي مجتمع محدد مسبقًا، وأنها لا تفرض أي شكل من أشكال الولاء إلى ثقافة معينة. إذا كان هناك شيء مثل السياسة (ومصاحبها الحب والاحترام) للغة، كلغة معينة، فإن هذه (السياسة والحب والاحترام) لا يمكن أن تتكون من الحفاظ على الانتماء الوطني أو تعزيزه أو تمجيده، كما كان الحال في كثير من الأحيان. قضية. ولا ينبغي لـ “نحن” (“نحن”، الفرنسيون، “نحن” الألمان، نحن “الإنجليز”، وما إلى ذلك) أن يتعزى بهذا. إنها تكمن بشكل أكبر في المعركة التي يتعين على كل شخص أن يخوضها (مع وضد المؤسسات) لفتح الطريق داخل اللغة إلى الاختراع الاصطلاحي، أي إلى التفرد. لأنه بهذه الطريقة فقط، كما حدس نيتشه بلا شك، يمكننا أن نحب اللغة كما نحب الحياة – إن احترام اللغة هو في نفس الوقت “تأكيد للحياة”.

في المقابلة، التي تم إعدادها بدقة شديدة، ليس من المستغرب أن تؤدي أسئلة اللغة والانتماء هذه بشكل طبيعي تقريبًا إلى اعتبارات ذات طبيعة سياسية أكثر مباشرة. عند سؤاله عن إحجامه عن أي استخدام سياسي أو فلسفي لصيغة الجمع، يعود دريدا، في الواقع، إلى انتماءين أساسيين، لم يتوقف عن التساؤل بشأنهما أبدًا: اليهودية [2] وأوروبا [3] يتذكر من الأول وأنه لا يجوز لها أن تفرض أي ولاء لأية سياسة وطنية مهما كانت. ومن النقطة الثانية، فهو يؤكد أنه، خلافًا لأي اشتراك في الأيديولوجية الأوروبية، وفي أي مركزية أوروبية (التي عارضها التفكيك منذ البداية)، ولكن أيضًا في مواجهة أي إدانة متسرعة وطائشة لأوروبا (والتي من شأنها أن تنكر أي ميراث)، إنه يشير إلى ما بدونه لا يمكن الدفاع عن اختراع التفرد سياسيًا: اكتشاف المسؤولية. “نحن الأوروبيين”، هذا لا يمكن أن يقال إلا تحت غطاء المسؤولية – التي هي أولا وقبل كل شيء علاقة فريدة مع العالم أجمع – مسؤولية تتطلب الإيمان والأمل في إمكانية وجود عالم أكثر عدلا، وعلى النقيض من “سياسة الهيمنة الأمريكية” وكذلك “ثيوقراطية عربية إسلامية بدون تنوير وبدون مستقبل سياسي” (ص 43): “تجد أوروبا نفسها تحت وصية تحمل مسؤولية جديدة. […] إن ما نطلق عليه جبرياً أوروبا يتحمل مسؤوليات يجب أن يتحملها، من أجل مستقبل البشرية، ومن أجل مستقبل القانون الدولي – وهذا هو إيماني، واعتقادي. وهنا لن أتردد في القول: “نحن الأوروبيون”. إن الأمر لا يتعلق بالرغبة في تأسيس أوروبا التي قد تتحول إلى قوة عسكرية عظمى، تحمي سوقها وتعمل كثقل موازن للكتل الأخرى، بل إنها مسألة أوروبا القادرة على زرع بذور سياسة جديدة للعولمة البديلة. وهي بالنسبة لي النتيجة الوحيدة الممكنة” (ص 43-44).
هكذا يصبح الانتماء إبداعيًا واصطلاحيًا. هذه هي الطريقة التي تتوافق بها مع هذا التأكيد على الحياة، الذي يتذكر دريدا أنه في نفس المكان الذي ستشكك فيه التفكيكية في البقاء باعتباره الدستور الأساسي للوجود، بما يتجاوز تعارض العيش والموت وحيث يظل التعلم عن الحياة مستحيلا، فإنه سيظل، منذ البداية، الخيط المشترك لعملية كتابته وفكره برمتها: “البقاء هو حياة ما بعد الحياة، حياة أكثر من الحياة، والخطاب الذي ألقيه ليس مميتًا، بل على العكس من ذلك، هو التأكيد”. لشخص حي يفضل أن يعيشها وبالتالي ينجو منها حتى الموت، لأن البقاء ليس “ليس مجرد ما يبقى، بل هو الحياة الأكثر كثافة ممكنة” (ص 54-55).