تقرير الريادة… بين الخطاب المطمئن والواقع المقلق(2)
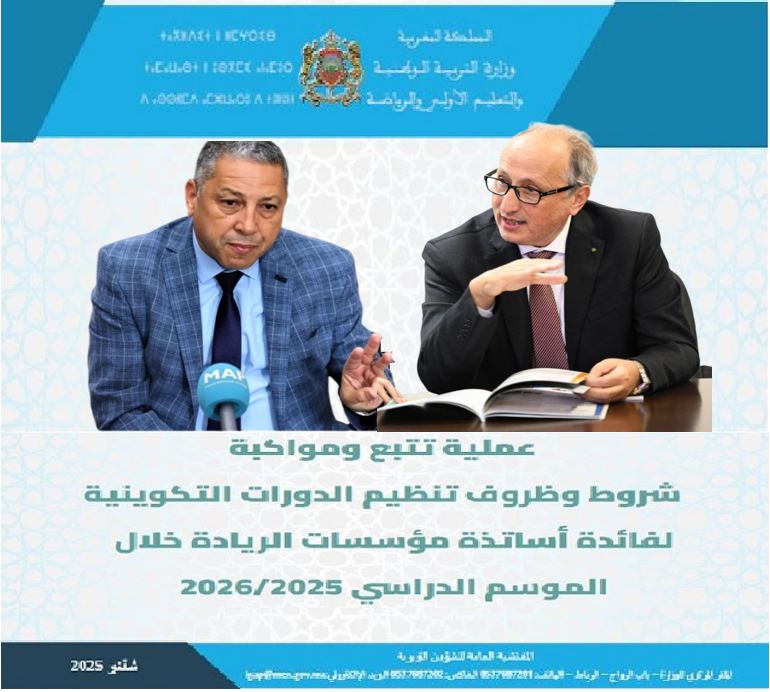
عبد الرزاق بن شريج
تذكير
ذكرتُ في المحور الأول المتعلق بالجانب التقني والتحريري وبمظاهر التضخيم في التقرير، أن تقرير المفتشية العامة حول تنظيم التكوينات بمؤسسات الريادة، رغم امتداده على 98 صفحة، يعاني من تضخّم شكلي وفقر تحليلي. فقد طغى عليه التكرار والوصف بدل التحليل العميق للمعطيات.
وأعتقد أنه كان بالإمكان إعداد تقرير مهني مختصر لا يتجاوز 30 صفحة، يركّز على التحليل النوعي والتمثيل البصري للبيانات، انسجامًا مع المعايير المعتمدة وطنياً ودولياً، مما كان سيجعل نتائجه أكثر وضوحاً وقابليةً للاستثمار في دعم القرار التربوي.
تقديم
عطفًا على ما سبق، سأتطرق في هذا المحور الثاني إلى التناقضات البنيوية في محتوى التقرير، معتمدًا أدوات التحليل العلمي ومنهجيته، بعيدًا عن أي خلفية شخصية أو ميدانية.
فـتقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية (2025/2026) حول تتبع ومواكبة الدورات التكوينية لفائدة أساتذة مؤسسات الريادة، يقدم وثيقةً غنية بالمعطيات الكمية والكيفية، تسعى إلى تقييم نجاعة برامج التكوين وديناميتها.
غير أن القراءة التحليلية المتأنية لهذا التقرير تكشف تناقضات واضحة بين الأهداف المعلنة والنتائج الميدانية، وبين الخطاب الإيجابي في المقدمة والاستنتاجات، والملاحظات السلبية التي تسجلها فصول التقرير نفسها.
أولاً: تناقض بين المنهجية المعلنة وحدود العينة الملاحظة
يؤكد التقرير في القسم الأول (ص. 9) أن هدف العملية هو {تتبع ظروف وشروط تنظيم الدورات التكوينية ورصد مستوى انخراط المستفيدين وجودة التأطير المنجز}؛
لكن في الصفحة (15)، يقر التقرير بأن عملية التتبع {اقتُصرت على عينة من المراكز المعدة للتكوين دون غيرها… لتعذر إنجاز تتبع شامل على الصعيد الوطني}.
التحليل:
هذا الاعتراف يضعف صدقية النتائج العامة، إذ لا يمكن بناء خلاصات وطنية على عينة محدودة لا تمثل جميع الأكاديميات والمديريات. فالتناقض بين “الرصد الوطني” المعلن و”الاقتصار العيني” المنجز يعكس اختلالاً منهجياً في التصميم التقييمي.
ثانياً: تناقض بين الأهداف المعلنة ونتائج التنفيذ
يصر التقرير (ص. 9–10) على أن العملية تهدف إلى {تعزيز نجاعة التكوين وضمان استمرارية أثره في تطوير الممارسات التربوية}؛
لكن المعطيات الميدانية (ص. 65) تسجل أن {70% من المديريات عرفت خصاصاً كبيراً في التأطير، خصوصاً في المواد العلمية واللغات، مما أثر بشكل مباشر على جودة التأطير}.
التحليل:
يتجلى هنا تناقض بنيوي بين الرغبة في ضمان النجاعة والاستمرارية، وواقع العجز التأطيري الذي يقوّض فعالية أي تكوين. فالتقرير يعترف ضمنياً بأن الجهاز المؤطر نفسه غير مكتمل، مما يجعل الغاية المعلنة طموحاً تنظيمياً غير مسنود بإمكانات فعلية.
ثالثاً: تناقض بين الحديث عن الجاهزية والمعيقات الميدانية
يذكر التقرير في فصل المراكز المحتضنة للورشات (ص. 36) أن {أغلب المؤسسات توفرت فيها شروط مادية ولوجستية مناسبة وجاهزية الفضاءات لاستقبال التكوين}.
لكن في القسم المخصص للإكراهات (ص. 86) يعترف بوجود {ضعف في تهيئة فضاءات المؤسسات وتجهيزها ووسائلها التكنولوجية لإنجاز الورشات التذكيرية}.
التحليل:
يقع التقرير في مفارقة واضحة بين الإشادة في الفصول الوصفية الأولى والاعتراف بالتقصير في الفصول الختامية. هذه الازدواجية تعكس توتراً بين الخطاب الإداري المبرِّر والرصد الموضوعي الميداني، بين الرغبة في إظهار النجاح والاعتراف الجزئي بالفشل.
رابعاً: تناقض بين النتائج الكمية الإيجابية والتوصيات التصحيحية
في القسم البيداغوجي (ص. 52) يورد التقرير أن {الجوانب البيداغوجية ساهمت في توفير أرضية عملية لإغناء الممارسات الصفية بنسبة ملاءمة تجاوزت 75%}؛
غير أن التوصيات (ص. 79) تدعو إلى {توحيد نماذج تقارير التكوين وتطوير آليات التقييم القبلي والبعدي}.
التحليل:
هذا التباين بين الأرقام الإيجابية والدعوة إلى الإصلاح المنهجي يكشف أن النتائج لا تعكس أداءً فعلياً، بل تقدم إحصاءات شكلية تبريرية أكثر من كونها قياسات تربوية دقيقة.
خامساً: تناقض بين الخطاب الرسمي عن الجودة والاعتراف بالارتباك الزمني والتنظيمي
يستعرض التقرير (ص. 11) المراسلات الوزارية (1271/25 و1541/25 و1715/25) التي تحدد {معالم تنظيم التكوينات وطرائق تأطيرها وضبط شروط إنجازها}؛
لكن في الصفحات (50–65) يقر التقرير بوجود {تأخر في انطلاق التكوينات، واكتظاظ داخل المراكز، وتزامن التكوين مع الدخول المدرسي أو الامتحانات، مما حدّ من فعالية التأطير}.
التحليل:
هذا التناقض يبرز الفجوة بين التخطيط المركزي والتنفيذ الميداني، إذ لا تُترجم الضبطية الوزارية إلى ممارسات عملية ناجعة. فالزمن البيداغوجي يتعرض للخلل بسبب ضعف التنسيق بين الفاعلين.
خاتمة
من خلال تحليل فصول التقرير يتضح أن الوثيقة تعكس نموذجاً تقويمياً هجينا يجمع بين اللغة التبريرية الرسمية والمعطيات النقدية الموضوعية، دون أن تنجح في التوفيق بينهما.
ففي الوقت الذي يسعى التقرير إلى تقديم صورة مؤسسية منسجمة حول {نجاح تجربة التكوين}، تكشف تفاصيله الداخلية عن واقع ميداني متعثر يتسم بضعف التأطير، واختلال التنظيم، وغياب التنسيق الزمني واللوجستي.
إن هذه التناقضات ليست مجرد تباينات لغوية، بل مؤشرات على غياب ثقافة التقويم المستقل داخل المنظومة، حيث تتحول التقارير من أدوات للمساءلة إلى أدوات لتبرير السياسات، لتنتقل المفتشية العامة من كونها جهازاً للتقويم الداخلي إلى مجرد مديرية تابعة للكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية.
يقول المثل المغربي: «يدي ويد القابلة يخرج المولود أعور».
وهو ما يستدعي بشكل ملحّ فصل جهاز التفتيش والتقويم عن الجهاز الإداري، فلكل واحد دوره الجوهري:
فالأول يقوّم ويحلّل ويوجّه، والثاني ينظّم وينفّذ ويتابع التطبيق.
ترقبوا المحور الثالث (الأخير):
أوجه القوة والضعف، مع اقتراح حلول عملية مستندة إلى دراسات وطنية ودولية.
قريباً…





