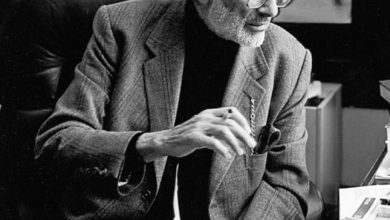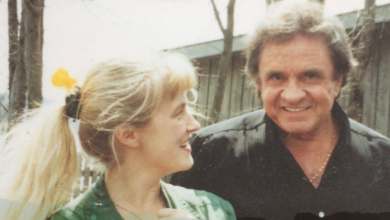جوليان باستور
مع استثناءات نادرة، فإن الأعمال – أكاديمية كانت أم لا – التي استند إليها عمل بيغي، تُفضي في النهاية إلى نفس الخيار. في ظلّ الإكراه التصنيفي الذي يُطاردنا، يُطرح السؤال باستمرار: هل يُصنّف في خانة “المُعادين للحداثة” ذوي الهوية المُشكِلة، أم بين أولئك “المُعاصرين” الذين يصعب تحديد هويتهم؟ بعد استشهاده في ساحة المعركة في الأيام الأولى من عام ١٩١٤، كان من المُمكن لشخصية بيغي أن تُؤثّر في الأجيال اللاحقة بلهجة ثورية، لشخص نائم في الوادي. كان من المُمكن، بعد نصف قرن من وفاته، أن نُحوّله إلى بلاء “للثورات المنطقية”. كتب: “بإمكان المرء أن يُحدث ثورةً بأي شيء، ما دامت لا مع الخيال ولا مع القديم “.
مع أن القول بتجاهل أعماله أو نسيانها خطأ، إلا أنها تظل ضحيةً لتدفقٍ غير متوقع. ربما كان ذلك سيلاً من “رجلٍ يساري […] صادف سوء حظه أن يلتقي، عبر سوء فهم التاريخ، بجيلٍ من اليمين” 3 ؟ وتبقى الحقيقة أننا غالبًا ما نقرأ ” شبابنا” أو “أموال فوق الأرض”؛ نداءاتٍ يائسةٍ لنقاء النوايا في مواجهة الدناءة السياسية لقضية دريفوس، أو الأسوأ من ذلك، كواجهةٍ مصقولةٍ لنظريةٍ موراسيةٍ مريضة. أعمال بيغي، المستخرجة من ساحة معركة الاشتراكية الجمهورية بين عامي 1890 و1910، مصبوغةٌ بصبغة الرجعية. كان سيكره عصره قبل كل شيء، ولم يكن ليفعل شيئًا سوى ذلك، مُشوّهًا العصر الحالي لصالح خيال فرنسا القديمة، رافعين القدح إلى مستوى ممارسةٍ أسلوبيةٍ بحتة. لقد ساهمت لغته، هذا النثر القاسي الذي لا يُخمد، المستمد من سفوح النص التوراتي وحوض الأوزان اللاتينية، في تشويه سمعته. وغالبًا ما تجعل قراءته غير ضرورية. 4 . ويشير برونو لاتور إلى أن “الجميع يتردد في فتحه، لأنه سيواجه تحذيرات كثيرة. ويواجه صعوبة في قراءته، إذ قُرئ كثيرًا سياسيًا ودينيًا وشعريًا، ولكن ليس فلسفيًا. يا له من منحدر شديد الانحدار يجب على المرء تسلقه لمجرد البدء في قراءته. […]. بالنسبة لبيغي، لم يُنجز العمل الدقيق في إزالة الألغام والتوضيح والتفسير والاستيعاب والتعليق” 5 .
كما يوضح أنطوان كومبانيون بشكل مقنع، فإن كل شيء يشير إلى أنه يجب منحه مكانًا لائقًا في دوريات المناهضين للحداثة – شخصية غريبة، فجوة حية، ضحية لوقت لا يحبه ومع ذلك يستمد من رثاء تقلباته مبدأ وجوده ذاته 6. مثل مايستر، غالبًا ما ينجرف بيغي وراء غضب الكلمات، وغضب الانتقام الذي يبدو أنه يريد تدمير كل شيء من أجل أن يكون عادلاً بدوره. إنه لا يخجل أحيانًا من الإفراط الذي يخدم القضية – “[…] إن سياسة المؤتمر الوطني هي جوريس في عربة ودقات طبول لإغراق هذا الصوت العظيم” 7. مثل بودلير أو باريس، فإنه يتخذ عن طيب خاطر الموقف الكئيب للمنبوذ. يأخذ الغضب المسترضي لهجات غنائية. من الرعب، كما نعلم، لا يتبقى سوى خطوة واحدة للوصول إلى الأرض. ولم يحرم بيغي نفسه من ذلك. بل أكمل اللوحة، منغمسًا في إعادة نسج لوحة البادرة الشعبية العظيمة – “لقد كانت فرنسا القديمة وشعبها بكل صرامة. لقد كان عالمًا، بتطبيقه، نال هذا التعبير الجميل عن الناس تطبيقه الكامل، تطبيقه القديم” 8. فيرجيل وكريتيان دو تروا، المنصهران في بوتقة واحدة، يستذكران “شعبًا في نسيجه، في نسيج وجوده اليومي، في اكتسابه، في كسبه، في جهده لكسب قوت يومه” 9 .
ساهمت نصوصٌ عديدةٌ من هذا النوع، لأسبابٍ لن نعود إليها هنا، في إضفاء طابعٍ مُبالغٍ فيه على قراءة بيغي. ولكن أليس هذا محاولةً للالتفاف على المشكلة أكثر من مواجهة اللغز؟ لغزٌ حقيقي، لأنه إن كان قادرًا على الانغماس في مدح “مسألة العمارة القديمة، التي كانت هياكل وتماثيل” 10 ضد “المادة الحديثة، […] القابلة للتبادل، والداعرة، والتي يمكن للجميع استخدامها” 11 ، إلا أنه ادعى انتماءه إلى “بنائي المدينة المجاورة، قاطعي الحجارة وخلاطي الملاط” 12. وإن كان قادرًا على انتقاد “العقم العميق” للاشتراكية، وإن كان قد أبدى نفوره من “جميع الكلمات في كلمة “ist “، فقد استثنى كلمةً واحدة، كما قال، “وهي عزيزةٌ عليّ، وهي الاسم الجميل للاشتراكية” 13 .
في العمل الذي يُكرّسه له، يُحافظ رومان رولان على هذه الصورة كصورة صادقة: “شعبٌ مُهمَل”. ويُضيف: “لا بدّ من القول، إن بيغي عالمٌ في حركة؛ شخصيته المتنوعة والعاطفية كانت تعددًا لا يخشى إظهار تناقضاته”. 14. لا شك في أنه كان يطمح إلى أن يكون “بنّاء المدينة القادمة”. ولكن أي مدينة تحديدًا؟ المدينة الاشتراكية؟ فحسب بيغي، ” الاشتراكية ، التي كانت نظامًا اقتصاديًا للتنظيم السليم والعادل للعمل الاجتماعي، أصبحت، تحت اسم الجوريسية […] إثارةً للغرائز البرجوازية في عالم العمل، وتدريبًا للعمال ليصبحوا بدورهم برجوازيين قذرين”. 15. المدينة الشعبية؟ ولكن هل بقي شيءٌ يُمكن تطبيق “كلمة الناس الجميلة هذه” عليه؟ عندما نتحدث عن شعب، فإننا اليوم نصنع أدبًا، بل حتى واحدًا من أدنى الأدبيات، أدبًا انتخابيًا وسياسيًا وبرلمانيًا. لم يعد هناك شعب. الكل برجوازيون. 16 إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمدينة العلمانية؟ مع ذلك: “العلمانية، التي كانت نظامًا للحياد في مسائل الإيمان والميتافيزيقيا، وباختصار، نظامًا لحرية الضمير […] أصبحت من أكثر الأنظمة تصلبًا، ومن أكثرها استبدادًا، […] ومن أشد أنظمة قمع الضمائر ضراوة.” 17 يمكننا بالطبع أن نتجاهل ميله إلى إصدار اللعنات، وإصدار قرارات حرمان لا تنتهي. لدرجة أن عباراته الأخيرة – “أنا جمهوري صالح. أنا ثوري عجوز” 18 – لها صدى غريب.
1.2. المدينة المراوغة؟
من الغريب أن يُنظر إلى كاتبٍ بهذا القدر من الاستياء، والتقلب والتذبذب في التعبير عن ولائه، على أنه مُروّج لمفهومٍ حصري للمواطنة، مُطعّمٍ في التراب، الوطن، أو الأمة. أليس، على العكس، لأنه أدرك في جميع الأنظمة والتجسيدات، في تصلب العقائد إلى عقائد، الخطر الذي يُهدد مدينة المُعاصرين، ما دفعه إلى ادعاء التحرر من الكفر الأبدي؟ ولكن يا له من مواطنٍ غريبٍ إذن، من يُعلن إيمانه بهذه الطريقة:
يجب أن تكون حياة الرجل الصادق […] ارتدادًا وتخليًا أبديين؛ يجب أن يكون الرجل الصادق مرتدًا دائمًا، ويجب أن تكون حياة الرجل الصادق، بهذا المعنى، خيانة أبدية. فالرجل الذي يرغب في البقاء وفيًا للحق يجب أن يُخون نفسه باستمرار لجميع الأخطاء المستمرة والمتتالية والمتجددة بلا كلل. والرجل الذي يرغب في البقاء وفيًا للعدالة يجب أن يُخون نفسه باستمرار للظلم المنتصر الذي لا ينضب . 19
مع ذلك، فإن الردة التي يدّعيها بيغي تنبع من شيء آخر غير الموقف الوجودي؛ إنها تعكس فشل التعافي، “مدينة في الفراغ” 20. فبالنسبة لجميع “العوالم القديمة”، تشكّلت المدينة من غيابٍ ظلّ، للمفارقة، لا يقلّ أهمية. تشير المدينة القديمة إلى المدينة المسيحية؛ فهي نفسها تُحدّد بدقة ملامح المدينة المتناغمة، التي لا يزال نصّ مارسيل يُحدّثنا عنها . ليس أن تلك تحتوي على غيرها، بل إنها “مُضمّنة” فيها بسرٍّ من الدمج الذي لن يكفّ عن إبهاره. تتشكل كل مواطنة، إن صحّ التعبير، في الاتجاه المعاكس، في إمكانية البناء على سابقة. لا تتطور المدينة إلا بشرط أن تكون قادرة على استملاك ما ليس من ذاتها، من خلال دمجه 21. الأشكال القديمة للمدينة لا تموت، بالمعنى الدقيق للكلمة، شريطة أن يبقى دائمًا مبدأ الخلافة ، أي مبدأ الاحتجاج. يستطيع الفرد إعادة ربط المدينة “بحوض جاف” ٢٢. لا شيء أصعب أو أهون من هذا العائق، أو هذا القطع، أو هذا التطعيم. ولكن كيف يمكن أن يترسخ ويثمر؟
مثل أستاذه في بورت رويال، يعتقد بيغي أن من طبيعة الإنسان الانحدار تدريجيًا لا فجأة. مع أنه قليل الحساسية لفكرة الانحطاط، إلا أنه مع ذلك شديد الحساسية لمفهومي البلى والشيخوخة. جميع المعتقدات والأفكار، حتى أسمىها، تتلاشى. هذا هو مصير “الإنسانية المشتركة”. مصير أكثر المدن إشراقًا هو الغرق تدريجيًا في غياهب النسيان. يمكننا أن نرثي هذا الزوال، الذي يُضفي على الرومانسية الحديثة نكهتها الخاصة. ولكن إذا كان بيغي مُفكّرًا روحانيًا، وإذا كان يعتقد أن القوة الملزمة لكل واجب مدني هي من نوع الروح، فإنه يرفض التضحية بمعركة الدنيا تمامًا. كل البشرية، مهما كانت متواضعة، تترك أثرًا. ووفقًا لإحدى أجمل استعاراته، “الروحاني يرقد دائمًا في فراش الدنيا “. 23 24 سيكون هذا هو الحال مع دريفوسية، كما كان الحال مع إينياس الذي حمل أنكيسيس على كتفيه بعد دمار طروادة: الابن يحمل الأب، والخليفة السلف، والفرد المدينة. من خلال ما نسميه بحقّ التجارب ، “يرفعنا” الدنيوي. نُجبر على تقييم أنفسنا في ضوء الوضع، بل وأكثر من ذلك، أن نُظهر جدارتنا به – أن نرقى إلى مستوى الحدث. الالتزامات تُعلينا. إنها تُنقذنا من ذلة كوننا أدنى من الأرض. بهذه الطريقة، نُصبح قادرين على تجنب الانحدار. جماعة – فريق، كنيسة ، جمعية، شعب – تحملنا وتُفوضنا سلطة تتجاوز الفردية المُطلقة 25 . ثم يمكن للمدينة أن “تنبثق” من الفرد الذي هو وسيطها أو مفسرها أو فاعلها: simul et singulis ، أي أن تكون معًا وتظل على طبيعتها 26. ينتبه بيغي إلى سر الفعل الذي يمكن من خلاله أن تتفتت الشخصية إلى أصوات متعددة، دون أن يعرض هذا الانفصال سلامة الفرد للخطر أبدًا. وعلى عكس ما يؤكده باريس في مشاهد ومذاهب القومية ، فإن الإخلاص للأرض وللموتى لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن تفرد الذات. إن الفوضوي فيه يمنعه من الاشتراك في ملاحظة باريس: “الذكاء، يا له من شيء صغير على سطح أنفسنا!” 27. المواطنة ليست مجرد ترقية(وهو ما يجعلنا ننمو لأنه يرتقي بالفرد داخل المجتمع)؛ وهو أيضًا ما يجعل من الممكن أن نكون على حق ضد الجميع، والتمرد الزمني باعتباره مقاومة لقوة روحية ديماغوجية تخفي في جوفها “ميتافيزيقيا الدولة”.
وهكذا ندرك طبيعة الانزعاج في وجه “العالم الحديث”. إن عبقرية الحداثة لا تكمن في تجريم المقاومة، بل في إلغاء مبدأ الاختلاف أو الانقطاع، وفي تحييد أو نسبية ما يُمكن مقاومته باسمه . «يفخر العالم الحديث بأنه، هنا، قد أدخل أسلوبًا، ولا شيء يُضاهي، كغاية إعدام، بعض المقاطعات المنظمة في العالم الحديث ضد المواطن الذي لا يريد السير على خطى ثابتة » . 28
كيف يُمكننا الحديث عن العمل الثوري، بينما الثورة، بحكم وجودها في كل مكان، لم تعد موجودة في أي مكان؟ ” لا شيء يُؤذي “، هي الكلمة المُستخدمة للدلالة على الكسل، والتراخي، والتردد، والكسل. إنها كلمة الجبن، بل أشد أنواع الجبن. إنها كلمة ميتافيزيقيا فجة ومبالغ فيها. فإذا لم يُؤذي شيء، فماذا يتبقى من كل ما نفعله، من كل ما هو حياة وفعل؟ ٢٩. منذ ذلك الحين، لم تعد المدينة الحالية تُشير إلى أي شيء سوى نفسها، التي تُشير باستمرار إلى فراغها الداخلي. مُخترقةً بانشقاق جذري، بل هجران – من الاشتراكية، والعلمانية، والجمهورية، والدين، والشعب – تُهدد وظيفة الشهادة ذاتها. “أعتقد أننا […] آخر الممثلين حرفيًا، وما لم يُشارك أبناؤنا، سنكون تقريبًا الناجين، بعد وفاتهم. على أي حال، نحن آخر الشهود . ما نعرفه، ما نراه، هو أننا في الوقت الحالي في المؤخرة. ” ٣٠
أمام هذا المأزق، هل يُمكن التمييز بين بيغي الفلسفي (الذي لا عقيدة له)، وبيغي السياسي (الذي لا حزب له)، والأكثر من ذلك بيغي المواطن ؟ بين مدينة الاشتراكية العاملة ، ومملكة المسيحية، والأرض الوطنية ، وحتى عالم العصور القديمة اليونانية اللاتينية، يبدو من الصعب للغاية تحديد أي مفهوم للمدينة يُشار إليه. بين مُحفّز دريفوسية في الحي اللاتيني والتضخم المعجمي لـ”العرق الفرنسي” في “لارجينت ” عام ١٩١٣، أي استمرارية منهجية يُمكننا أن نسمح بها؟ ألا يكون من المنطقي ترك بيغي “كما يُمدح”، مُتورطًا في تناقضاته التي لا تُحصى، مُحتلًا، حسب الموضة، دور “المُستهتر” أو “الروح الحرة” أو المُحتقر؟
العالم الحديث أو تقلبات التراث
٢.١. جمهورية مُحبطة
تكمن أصالة بيغي في انطلاقه من التناقض، ليس كملاذ أخير، بل كضرورة سياسية ومعرفية، تُكتشف من خلال أزمة المواطنة 31. ورغم أن هذا قد يتخذ معانٍ مختلفة لديه باختلاف النصوص والفترات الزمنية، إلا أن أحد أشكاله يبدو أنه يهيمن، كما قد يُقال عن إحدى درجات ألوان لوحة. هناك أزمة عندما يعجز الإنسان ولا المواطن عن تحديد موقعهما – أي تحديد المدينة التي ينتميان إليها. إن مفهوم النسب نفسه مُثقل بتناقض يبدو مستعصيًا على الحل. فبين الفرد والجماعة، والمواطن والمدينة، والفرد والجمهورية، تبدو الاستمرارية مُعرّضة للخطر أكثر من أي وقت مضى. منذ نصوصه الأولى، يبحث بيغي في الانسداد الذي يُؤثر على هوية الإنسان المعاصر، وما يمنعه من الإرث 32. وبهذا المعنى، تتسم أزمة المواطنة بسمة خاصة: فهي مرتبطة بموقف تاريخي مُحدد ، وبنظام زمني مُحدد يُغطيه التركيب النحوي المُتغير لـ”العالم الحديث”. يقارن بيجوي بين ملاحظتين حاسمتين.
الأول هو التناقض الجوهري في العالم الحديث. يجب فهم المصطلح حرفيًا: ما تتمثل صفته الأساسية في السير في الاتجاه المعاكس. وهكذا، ثمة بنية معارضة للحداثة، تتبنى عمدًا وجهة نظر معاكسة للاستخدام. إنه، على حد تعبير بيغي، “عالم الأذكياء […]، عالم من لا يؤمنون بشيء” 33. يتجاوز النقاش مسألة “الأشكال السياسية” التي تُحفّز الرابطة المدنية. إنه ليس، “كما يُقال، بين النظام القديم والثورة […]، بين نظام قديم، فرنسا قديمة ستنتهي عام 1789 وفرنسا جديدة ستبدأ عام 1789” 34. بتعبير أدق:
العالم الحديث لا يعارض النظام الفرنسي القديم فحسب، بل يعارض جميع الثقافات القديمة مجتمعةً، جميع الأنظمة القديمة مجتمعةً، جميع المدن القديمة مجتمعةً، كل ما هو ثقافة، كل ما هو مدينة. إنها في الواقع المرة الأولى في تاريخ العالم التي يعيش فيها عالم بأكمله ويزدهر، ويبدو أنه يزدهر في وجه الثقافة كلها .
إن التناقض الحديث ليس وظيفيًا فحسب، بل إنه ليس عرضيًا بحتًا. إنه جوهري وشامل: “بامبيوتيا” 36. إن الطابع غير المسبوق لنوع المواطنة الذي يُفرزه لا يقتصر على كونه ضد ما يسبقه مباشرةً – كالنظام الجديد ضد القديم، والعهد الثاني ضد الأول – بل إنه يتعارض مع “كل ما هو ثقافة، مع كل ما يُستشهد به”، باختصار: مع إمكانية النقل نفسها. “نتقاطع مرة أخرى مع هذا الطرح […] القائل بأن العالم الحديث، وحده ومن جانبه، يتعارض في آن واحد مع جميع العوالم الأخرى، مع جميع العوالم القديمة مجتمعةً ومن جانبها” 37. سيجادل بيغي أكثر فأكثر بأن فئة العصر الحديث تعيش وتزدهر من هذا الإنكار، وأنها تشمل كل ما يستمد منها منفعة وفائدة. بدلاً من ابتكار أساليب جديدة للوجود، و”تقليد الثوار القدامى ببراعة” بوضع أنفسنا “بمنتهى الحرية أمام العالم” 38 ، نستغل ما هو موجود بالفعل. “بجحود فكري غريب، تُعارض الحكومات الثورية والسلطات الاشتراكية العقل، والحرية التي وُلدت منها، والتقاليد الإضافية، والصيانة المُرهِقة” 39. لا يزال الديكور قائمًا، ولكنه فارغ.
2.2. مواطنة ساخرة
من هنا، وفي ملاحظة ثانية، ترتكز مدينة الحداثيين على نظام اعتقادي متناقض للغاية. ولأنها تتصور نفسها تتويجًا للتاريخ، ينبغي أن تُجسّد ظهوره، أو إعادة إنتاجه، أو إنجازه. هذا هو الاعتقاد الساذج نوعًا ما، والتقوى الكئيبة نوعًا ما، والرضا البرجوازي لـ “مجتمع الله” الذي يعتقد بيغي أنه يلمسه لدى علماء اجتماع مثل دوركهايم أو إيزوليه، أو لدى مؤرخين مثل رينان. نعيش “برجوازيين” من دخل من الماضي، كرأس مال نجمعه دون الحاجة إلى العمل من أجله 40. تاريخيًا، ينبغي أن نكون في أفضل وضع، إذ نمتلك في متناولنا كمًا لا يُضاهى من المعرفة، وكتلة من التعليقات والشروح لم يسبق لها مثيل، أي باختصار، علمًا متكاملًا. أما بيغي، فهو على النقيض تمامًا.
نحن في وضع سيء للغاية. في التسلسل الزمني. في تعاقب الأجيال. نحن مؤخرة ضعيفة الترابط، غير متصلين بالجسم الرئيسي، بالأجيال القديمة. نحن آخر جيل يحمل الغموض الجمهوري. […] نحن الأخير. تقريبًا ما قبل الأخير. بعدنا مباشرة يبدأ عصر آخر، عالم مختلف تمامًا، عالم أولئك الذين لم يعودوا يؤمنون بأي شيء، والذين يفخرون به ويفتخرون به .
في نظره، وسنرى إلى أي مدى تُغذّي تجربة دريفوس هذا الشعور وتُغذّيه، تكمن خصوصية المعتقد الحديث في استبدال معيار الحقيقة بالمحاكاة الساخرة . نعتقد أنه يكفي التظاهر لخلق شيء، والتظاهر للانخراط، دون إدراك الخطر الذي يُهدّد بتحويل الخداع إلى غباء.
لنُعبّر عن ذلك بكلمات. الحداثة هي عدم الإيمان بما يؤمن به المرء. الحرية هي الإيمان بما يؤمن به المرء والاعتراف (أو بالأحرى المطالبة) بأن جاره يؤمن به أيضًا. الحداثة هي عدم الإيمان بنفسه حتى لا يؤذي خصمه الذي لا يؤمن به أيضًا. إنها نظام من التنازل المتبادل […]. الحداثة نظام من الرضا عن الذات. الحرية نظام من الإذعان. […] لا ينبغي لنا أن نستخدم كلمات مُبالغ فيها، ولكن في النهاية، الحداثة نظام من الجبن. الحرية نظام من الشجاعة 43 .
إن طبيعة الحداثة والنظام السياسي المرتبط بها لا تعني غياب الحقيقة، بل نزع الشرعية عن مبدأ الدليل . إن أوضح ما يُنكر هو أشد ما يكون شراسة. يدرك بيغي جيداً أن آلية الإخفاء أو التظاهر هذه لا تنتمي تحديداً إلى عصره. بل ربما تكون من نوع الثوابت الأنثروبولوجية. ومع ذلك، فإن الأزمة الحديثة تُعمم هذا المبدأ بدرجة غير مسبوقة، لدرجة أنه تسلل إلى الحس السليم. ووفقاً لقراءة بيغي: فهو الآن منتصر تربوياً . لذلك، ليس من المستغرب أن “تظهر الأمراض الاجتماعية الناجمة عن الكذب أولاً كأعراض تربوية” 44. نجد أوضح مثال على ذلك في نص من عام 1904 بعنوان ” من أجل المستأجر “:
“تكمن الصعوبة كلها في هذا: أزمة التعليم ليست أزمة تدريس […]؛ لم تكن هناك أبدًا أزمة تدريس؛ أزمات التعليم هي […] أزمات حياة؛ […] إذا شئت، فإن أزمات الحياة العامة، أزمات الحياة الاجتماعية تتفاقم، وتتجمع معًا، وتبلغ ذروتها في أزمات التعليم، والتي تبدو خاصة […] ولكنها في الواقع كلية، لأنها تمثل الحياة الاجتماعية بأكملها؛ […] يمكن لبقية المجتمع أن تمر، مزورة، مقنعة؛ التعليم لا يمر؛ عندما لا يستطيع المجتمع التدريس، فهذا ليس لأنه يفتقر عن طريق الخطأ إلى جهاز أو صناعة؛ […] بل لأن هذا المجتمع لا يستطيع تعليم نفسه؛ إنه لأنه يشعر بالخجل؛ إنه لأنه يخشى تعليم نفسه؛ بالنسبة للبشرية جمعاء، فإن التدريس، في الأساس، هو تعليم نفسه 45. “
أزمة المواطنة، بمفهومها كنزعة فردية، هي في المقام الأول أزمة حياة اجتماعية. وفي المقابل، لا تحمل “أزمات التعليم” أي معنى في حد ذاتها. إنها تعكس فقط الصعوبة، مهما كبر حجمها أو صغر، في نقل المدينة إلى الفرد. التعليم ليس سوى وسيلة نقل – يشير ف. غافيوت إلى ” النقل “، إنه “العبور”، ولكنه أيضًا نقل شحنة – تسمح بدمج أحدهما في الآخر، وتنظيم علاقاتهما المتبادلة. وفيًا للتراث الثوري لعام ١٧٨٩، ومتماشيًا مع المشروع الذي وُلد في نهاية القرن الثامن عشر ، سيكرر بيغي أن عظمة الحداثة، عظمة الاشتراكية الحقيقية، تُفهم على أنها القدرة الانعكاسية للمجتمعات على أن تكون تربوية في حد ذاتها ٤٦. هذا الاعتقاد يتغلغل في مارسيل، عن المدينة المتناغمة عام ١٨٩٨، ولا يزال يتغلغل في نصوص الأعوام ١٩١٠-١٩١٣. إذا كان “التعليم للبشرية جمعاء هو تعليم الذات ” ، فإن صيغة الضمير مهمة. فالمواطنة، شأنها شأن المدرسة، لا يمكن تلخيصها في “صناعة” أو “جهاز” محدد. إنها تتكون أولًا من ذاكرة. وباستخدام مصطلحاتنا الخاصة، يقول بيغي إن مسألة “الوسائل” ليست إلا ثانوية. ففي “نظام الحداثة”، تُخفي مشكلة الأجهزة أو الوسائل أو الأساليب الشكلية قصور الجوهر – طابعه الساخر والفراغي.
من يتحدث عن العلم والفن والفلسفة والمجتمع الحديث في ضوء التصورات المدنية هو من يجهل ما هو المختبر أو الورشة أو الفكر الشخصي أو الإنسانية؛ وعندما يُبالغ الدجال العلمي في وصف العلم […]، فإنه يُلغي كل ما يظنه الدجال أو المُربي، سواءً كان نقصًا فيه، ليُمارس وظيفته الاجتماعية المتمثلة في التصوف العلماني الذي يُنسبه إليه السياسيون […]. إنهم يجدون أن العلم ليس جيدًا كما هو […]، ولأنهم عاجزون عن توسيعه في الواقع، فإنهم يُصرّون على توسيعه في الطباعة 47 .
أزمة الغموض الجمهوري
٣.١. تدهور التصوف
وضع بيغي عمله بأكمله تحت ختم الانعكاس أو التعارض الأساسي بين التصوف والسياسة. لقد أضعفت شعبية هذا التعبير في فرنسا إلى حد ما المعنى الذي أعطاه له مؤلف كتاب شبابنا – حيث تم تطويره بدقة أكبر. بعيدًا عن المواجهة البسيطة بين نقاء الدوافع وتسوية الدوافع، فإنه يحدد نوعًا معينًا من العمليات . كل سياسة، مهما كانت، تولد من التصوف. هذا هو المعنى الطبيعي والثمار التي يمكن للمرء أن يتوقعها منها، عملها . تنبت الفكرة 48 وتنمو، طالما أنها تتغذى – بشكل مبتذل، طالما أن المرء يؤمن بها. الآن نسيج العالم الحديث، كما رأينا، هو من تصميم متعارض. إن السببية التي تحكم عادةً ترتيب العلاقات بين التصوف والسياسة لم تعد معكوسة فحسب، بل مخربة. “المصلحة، والسؤال، والأمر الجوهري هو أنه في كل نظام، وفي كل نظام، لا يلتهم التصوف السياسة التي ولّدته.” 49 هناك انقلاب و”التهام” عندما يلتهم الثاني الأول إلى درجة امتصاصه بالكامل. ومن ثم، تنشأ أزمة مواطنة عندما “يتدهور” التصوف إلى سياسة، عندما يتحول “الموت من أجل” إلى “العيش منه”، أو مرة أخرى: عندما تتحول “جمهورية المتاريس” إلى “جمهورية المضاد”. السياسة تُدرّ دخلاً أكبر من التصوف؛ إنها عملية أكثر ربحية. “وأنت يا سيدي، الذي تطلب مني أن نحدد قليلاً من خلال التفكير البرهان، من خلال التفكير العقلاني، ما هو التصوف وما هي السياسة، quid sit mysticum، et quid politicum ، كان التصوف الجمهوري عندما مات المرء من أجل الجمهورية، والسياسة الجمهورية هي الآن أن المرء يعيش بها . ” 50
على الرغم من الاستخدام الشائع للكلمة – حيث تشير الأزمة إلى حلقة محددة – فإنها بالنسبة لبيغي تأسيسية ودائمة و”وجودية”. ففكره وكتاباته، التي يصعب فصلها، تبدو دائمًا متوترة للغاية، على وشك نوبة سكتة دماغية أثارها غضب غير مسيطر عليه. إنه منزعج وغاضب 51 ، بما يتناسب مع ما يراه أمرًا من العالم الحديث. ثم تصبح اللعنة أو الردة أو الزهد – وهي العديد من أشكال الإزعاج – الرهان الاستراتيجي للنضال المدني والأخلاق الجمهورية . وكما هو الحال مع آلان، “التفكير هو أولًا أن تقول لا”. يمكن اختزال جميع الأزمات التي يمر بها (أزمة العقل والتصوف والتدريس والجمهورية) إلى صعوبة أساسية أو خيبة أمل. إن الحداثة، نظامٌ متناقضٌ تكوينيًا، بل ساخرٌ بالضرورة، تُفضي إلى شكلٍ من أشكال التمثيل السياسي ، حيث تتجاهل الطبقات المختلفة بعضها بعضًا “رغم المظاهر، ورغم المصطلحات […] وعبارات التضامن الرنانة، كما نادرًا ما تُتجاهل” 52. جمهوريةٌ بلا جمهوريين، شكلٌ بلا جوهر، نظام ثمانينيات القرن التاسع عشر سيكون محصورًا بالكامل في الديكور، ولكن دون أي ممثلين. من أين يأتي هذا الوضع الغريب؟
يعتقد بيغي، وهو قارئٌ مُتمعّنٌ لبرغسون، أن جمهوريي عصره خلطوا خلطًا مُفرطًا بين الواقعين 53. فهم يعتقدون أن النظام الجمهوري هو ما جعل فرنسا، منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، تعرف شكلًا مستقرًا من الاستمرارية السياسية. ولأنه يدوم، فهم يستنتجون أنه دائم – كما يُغفِل الأفيون موليير بفضائله المُنومة. ومع ذلك، يُمكن التشكيك في شرعية هذا التجاوز وأهمية هذه الجمهورية المجازية حيث الجزء يساوي الكل. يُطالب الجمهوريون، من حيث المبدأ، بتجاوز الإسناد. ففي الجمهورية التي تدوم، ليست الجمهورية هي التي تدوم. بل هي المدة. ليست الجمهورية هي التي تدوم في ذاتها، في ذاتها. ليس النظام هو الذي يدوم فيها. ولكن فيها، الزمن هو الذي يدوم. […] فيها، ما يدوم هو كل ما يدوم” 54 .
الزمن المكاني، المُقاس بعدد السنين، لا يمت بصلة للصفة المُحددة التي تُبقي نظامًا، أو شيئًا، قائمًا. فالنظام الجمهوري لا يُنشئ استمرارًا بذاته، بل تأتي هذه الخاصية من مصدر آخر – من غموضه. لا تُنتج الهوية الاسمية سوى تشابه ميكانيكي بحت، كأثرٍ للواقع. “يجب على المرء ألا يتبع الأسماء والمظاهر والجوانب إلا قليلاً، وأن يكون حذرًا جدًا من الأسماء، فكما أن الإمبراطورية الثانية، تاريخيًا، حقًا، لا تُكمل الإمبراطورية الأولى، كذلك الجمهورية الثالثة، تاريخيًا، حقًا، لا تُكمل نفسها.” 55 تعتمد القدرة على الاستمرار على قدرة تأسيس حدث ينتشر كما لو كان في دوائر متحدة المركز في التاريخ – المدينة اليونانية، المسيحية، الثورة الفرنسية، الجمهورية، دريفوس. “الثورة […]، العظيمة، كانت تأسيسًا. تأسيسًا ناجحًا إلى حد ما، ولكنه تأسيس. تأسيس، أي أن كل استعادة بحد ذاتها ليست أكثر من تكرار لها” 56 .
مهما بلغت قوتها، فمن طبيعة “المؤسسات” أن تتراجع تدريجيًا. كان بيغي بلا شك، وإن كان نادرًا ما يتحدث عن ذلك، قارئًا منتبهًا لكتاب فوستيل دو كولانج ” المدينة القديمة” . المسيحية منفصلة عن المدينة القديمة؛ فهي في بعض النواحي تُغلقها، وتُحل محلها، وتتفوق عليها. لكنها في الوقت نفسه تحملها وتُبقيها لأن مبدأها الروحي وجد ما يغذيه فيها. فوستيل، كما نعلم، أعطى دورًا حاسمًا للإيمان بنشأة المؤسسات، وخاصةً مدتها 57. ويكتب مجددًا: “عندما يُنسب الجمهوريون مدة الجمهورية إلى قوة النظام، إلى فضيلة معينة للجمهورية، فإنهم يُبالغون […] في تقديرهم الأخلاقي “. ويضيف قائلاً: “إننا نعتقد على العكس من ذلك أن هناك قوى وحقائق أعمق إلى ما لا نهاية، وأن الشعوب، على العكس من ذلك، هي التي تصنع قوة الأنظمة وضعفها؛ ناهيك عن أنظمة الشعوب” 58 .
3.2. المدينة والمقدسات
ومع ذلك، إذا التزمنا بالوقت الذي أدلى فيه بيغي بملاحظته، فقد تبدو هذه الملاحظات غريبة. لقد كتب تحديدًا في وقت ما يُقدم نفسه في أعيننا (سواء كان ذلك وهميًا أم لا، فلا يهم هنا) على أنه “العصر الذهبي” للثقافة الجمهورية. إذا لم يكن جميع الجمهوريين في عصره جمهوريين سعداء بلا شك، فيمكننا على الأقل أن ننظر إلى تفاؤلهم أو إيمانهم على نطاق واسع إلى حد ما. على حد تعبير رويير كولارد، من المعقول القول إنه في تسعينيات القرن التاسع عشر، “تدفق سيل الديمقراطية بكامل طاقته”. في الواقع، فإن الحركة العظيمة التي بدأت في أعقاب عام 1789، والتي تمثلت في تسجيل الغزو الجمهوري للمؤسسات والأراضي، لديها الآن وسائل تعادل طموحاتها الأولية 59. من ناحية، يبدو أن الفكرة الجمهورية قد “تأقلمت”؛ من ناحية أخرى، فإن طابعها الراديكالي والاشتراكي يجعلها تميل بشكل ملحوظ نحو اليسار، إذا صدقنا ألبرت تيبوديه، الذي سيُغطي بصيغة شهيرة “الكآبة الكامنة” في الحياة السياسية الفرنسية. منذ عام ١٨٤٨، أصبح تحالف القوى الجمهورية ضد الرجعية خاضعًا لهذه “الفكرة العظيمة بحرف كبير”، التقدم ٦٠. والأهم من ذلك، أنها في طريقها لتحقيق العمل العظيم الذي وُضعت خطوطه العريضة عام ١٧٨٩: التعليم الإلزامي والمجاني والعلماني، وغزو العقول والأخلاق. ومع ذلك، فإن بيغي، المعاصر لحركة الفيريّة المنتصرة، يسير في الاتجاه المعاكس:
سياسيونا مخطئون. من أوج هذه الجمهورية، لا يتأملهم أربعون قرنًا (من المستقبل). […] اليوم، تُثبت الجمهورية وتُبرهن. عندما كانت حية، لم تُثبت. لقد عاشت. عندما يُثبت نظام ما بسهولة، وبشكل ملائم، وبانتصار، فذلك لأنه أجوف، إنه على أرض الواقع. اليوم، الجمهورية أطروحة، مقبولة، من قبل الشباب. مقبولة، مرفوضة؛ بلا مبالاة؛ إنها لا أهمية لها. ما يهم، ما هو جاد، ما هو مهم، ليس ما إذا كانت مدعومة أو مستدامة، بل أنها أطروحة. أي، على وجه التحديد، أنه يجب دعمها أو استدامتها. عندما يكون النظام أطروحة من بين أمور أخرى، فهو على أرض الواقع. النظام الذي يقف، الذي يصمد، الذي لا يزال حيًا، ليس أطروحة . 61
إذا اتفقنا على اتباعه، فإن نقد مدرسة الجمهورية الثالثة (ما يسميه “الهيمنة الأولية”) يتبين أنه شديد الضراوة. ليس لأنه يلومها على تعليمها الجمهورية، بل لأنها تفعل ذلك على طريقة التعليم الأخلاقي، فلسفة الدولة – أطروحة عقلانية 62. ستصبح الجمهورية نوعًا من أطروحة تنافسية، مجازًا – وهنا يحوم شبح فيكتور كوزان، شبح “روحانية الدولة”. وراء هذا النقد، يمكننا أن نستنتج قناعة أخرى: الجمهورية لا تحيا إلا بضمان وجود وإمكانية ما أسمته حنة أرندت لاحقًا “الثورة الثورية”. هذا أحد أسباب، إن لم نقل عدائية، بيغي تجاه الكومبزمية وقانون 1905؛ فبعد أن فقد أعداءه من يمينه، كان الإغراء هو إعادة تشكيل شكل من أشكال رجال الدين الأخلاقيين، وإعادة بناء كنيسة جديدة “علمانية” 63 . نجد هنا المشكلة الصوفية السياسية: “عندما نرى ما فعلته السياسة الدينية بالتصوف المسيحي، كيف يُدهشنا ما فعلته السياسة المتطرفة بالتصوف الجمهوري؟ عندما نرى ما فعله رجال الدين عادةً بالقديسين، كيف يُدهشنا ما صنعه برلمانيونا من أبطال؟ عندما نرى ما فعله الرجعيون بالقداسة، كيف يُدهشنا ما فعله الثوريون بالبطولة؟”
يتضح إذن أن موقف بيغي مُشكلٌ بقدر ما هو مُزعج: فهو يتطلب تنظيم نقد الجمهورية، باسم الجمهورية نفسها، وداخلها. هذا ما يُمكن أن نُسميه “جمهورية مُحبطة”، أو على طريقة كلود نيكوليه، “جمهورية مُؤلمة”. 64 في هذا السياق المُميز، ليس بيغي وحيدًا: فهو يسير برفقة برودون، إلى جانب ميشليه وكوينيه، أو مع تلك الشخصية الأخرى التي لا يُمكن تصنيفها، جورج سوريل. باختصار، مجموعة من الكُتّاب الذين لا يبدو تمسكهم بالإطار الأيديولوجي للجمهورية الفرنسية جليًا. ماذا يُمكن للمرء أن يفعل عندما يكون جمهوريًا دون التمسك بالجمهورية التي أمام أعيننا؟ مع أن السؤال يبدو عاديًا، إلا أنه يبقى حاسمًا. إنه يتطلب منا موازنة الإطار القانوني للمواطنة ببعد أخلاقي، والذي بدوره يُشرك البحث عن نظام جديد للمقدس السياسي.
قد يحدث بالفعل أن ينفصل جسد المؤسسات، إن جاز التعبير، عن روح القوانين. ودون حتى ذكر جمهورية الأربعينيات المتشردة، التي قطعت رحلة شاقة من باريس إلى لندن، ومن فيشي إلى سيغمارينجن، فإن المشكلة الشائكة المتمثلة في شغور الروح الجمهورية 65 قد برزت بالفعل لمنفيي ما بعد عام 1852، مثل هوغو، وكوينيه، وليرو، ولويس بلان. وبغض النظر عن الاختلافات التي فرقتهم، لم يعتبر أي منهم الفرار جبنًا، بل حمل معه جزءًا مما كان يعتز به. ومثل أساتذته، يعتقد بيغي أن المواطنة الجمهورية مسألة موقع، أو بعبارة أكثر ثقلًا: مسألة تجسيد . فطالما وُجد حامل واحد للفكرة أو الرسالة أو الوعد الجمهوري، فإنها لا تموت أو تستسلم. وهذا الاعتقاد يغذي “القلق الأبدي” الذي يدعي أنه السمة البارزة للأخلاق . دفعه هذا إلى البحث الدؤوب عن مصادر هذا التصوف – المدرسة قبل عام ١٨٨١، والشعب، والمدن القديمة والمسيحية، ونصوص هوغو، وكورني، وباسكال – باعتبارها مصادر متعددة للاستمرارية نفسها التي يمكن الاستناد إليها. وبتبنيه للتناقض، يتحدث بيغي عن “السلالات الجمهورية”، باعتبارها نقاط مرجعية وتجمع، كنوع من اتحادات المواطنين الخالدة:
عددٌ مُعينٌ […] من هذه السلالات المشتركة، التي عادةً ما تتحالف مع بعضها البعض، وتنسج بعضها مع بعض كالخيوط، بالنسب والتحالف، قد صنعت، ووفرت التاريخ الكامل ليس للجمهورية فحسب، بل لشعب الجمهورية أيضًا. هذه العائلات […] هي التي نسجت تاريخ ما سيُطلق عليه المؤرخون الحركة الجمهورية، والتي يجب أن تُسمى نشر الغموض الجمهوري 66 .
على عكس الأسطورة القاتمة التي استطاعت بعض الكتيبات نشرها ، فإن قراءة هذه المقاطع تُبرز بوضوحٍ طابع بيغي “المناهض للحداثة”. فإذا كانت المواطنة جزءًا لا يتجزأ من التراث، فمن المشكوك فيه أن تكون مواطنة أي “عرق”، مدعومة بمفهوم عرقي للشعب. فهو ليس باريس ولا جول سوري. على العكس من ذلك، تكشف “الحركة الجمهورية” عن نفسها على أنها تتكون من تعددية نسيج دائم (مختلط) يؤسس الانتماء إلى المدينة على إمكانية حوار جماعي مفتوح بلا حدود.
تظل الحقيقة أنه من الصعب فهم أزمة المواطنة، أو حتى انزعاج بيغي، دون إضافة أن إدامة هذا التراث ونقله ليسا تلقائيين على الإطلاق. “نعلم الآن أن الحضارات فانية”. هذه هي الملاحظة التي صاغها بول فاليري في كتابه ” أزمة الروح” عام ١٩١٩. قبله، كان بيغي قد اختبر هذا الشعور بهشاشة غير مسبوقة، وتهديدًا باحتمالية الاختفاء. “نحن الحرس الخلفي، […] حرس خلفي معزول إلى حد ما، مهجور تقريبًا. فرقة في الهواء. نحن تقريبًا عينات . نحن أنفسنا سنكون أرشيفات، أرشيفات وجداول، أحافير، شهودًا، ناجين من هذه العصور التاريخية. جداول سيتم الرجوع إليها .” ٦٨ ٦٩. “نظام الانحدار المتبادل”، الحداثة تخفض الأفراد بدلاً من رفعهم؛ يُجبرهم على خوض لعبة الصراع من أجل البقاء الدنيوي اللانهائية والقاسية، حيث يكتشف الإنسان، بدلًا من أن يكون فقيرًا فحسب، أنه بائس 70. ضحية شكل من أشكال العقم – “الجفاف” – يبدو أن العالم الحديث يُدمر إمكانية تجدده ذاتها. هذا الشعور بالتناقص التدريجي – “نحن نحيفون. نحن نحيفون. نحن شريط رقيق” 71 – يكاد يكون متطابقًا تمامًا في عمل بيغي مع الحدث الرئيسي الذي يُشكل قضية دريفوس.
رابعًا: دريفوس، أو الثورة الفاشلة
4.1. حدث صادم
مهما كانت تفاصيل التفسيرات والتسلسل الزمني، يوجد إجماع ضئيل على جعل قضية دريفوس، التي تكتسب هنا حرفها الكبير، انقسامًا حقيقيًا في الخيال السياسي الفرنسي 72. ونظرًا لعدم امتلاكنا لكفاءة المؤرخ، فلن يكون من المطلوب بالنسبة لنا مناقشة التفاصيل، ناهيك عن اقتراح تفسير، ولكن ببساطة التأكيد على خصوصيتها في مفهوم بيغي للمواطنة. في الواقع، كان الأمر بالنسبة لبيغي ما كانت عليه الحلقة 1848-1852 بالنسبة لأسياده (ميشليه، كوينيه، برودون): صدمة، حدث خادع سيتأمل فيه طوال حياته. ما طبيعة هذه الخيبة؟ ليس من السهل توضيح النقطة لأنها المحفز لكل فكره، والمدار الذي لن تتوقف نصوصه عن الانجذاب إليه أبدًا. ومع ذلك، يهيمن بُعد واحد: يعتبر بيغي أن دريفوسية كان يمكن أن تكون، وكان ينبغي أن تكون، ثورة روحية. “إلى “الهيمنة الأولية التي تأسست حوالي عام 1881، والتي ليست الجمهورية، التي تسمي نفسها الجمهورية” 73 ، فإن القضية قد تكون جلبت كذبة حرفيًا .
إن فكرة النضال من أجل الحقيقة، وحقيقة، إن جاز التعبير “مجانية”، محمية من غبار “المجد الدنيوي” 74 ، بالغة الأهمية في إدراك التجديد النافع الذي توقعه منها. وإذا كان هناك “تصوف”، فذلك لأن دريفوسية مرتبطة بتقليد تتبناه وتركز عليه. وبهذا المعنى، فهي عامل استمرارية ، قادر على إعادة صياغة الزمن في عالم يفتقر إليه بشكل فريد، أو يتجاهله أو يسخر منه. بالنسبة لبيغي، كما هو الحال لاحقًا مع إي. دوركهايم وم. موس، فإن القضية رمز . باختصار، يصبح ترتيب العرض، ونشأة الوقائع، ثانويًا. من المهم بالطبع معرفة الحقيقة 75 ، للتمكن من الحكم ، لكن بيغي يؤكد في مناسبات عديدة أن سمة القضية هي تجاوز نظام السببية. لو استطعنا، بمحض مصادفة مستحيلة، إثبات براءة ألفريد دريفوس آليًا ، لظل الصراع مختلفًا تمامًا . 76 إن القوة المحفزة للحدث تتجاوز مجرد تجاور الحقائق التي لا تُستنفد معناه. فإذا كانت دريفوسية “تُتوّج” بالتصوف، فذلك لأنها تُبلغ ذروتها وتُجمّع التاريخ الذي سبقها في نقطة واحدة.
في “المتتالية الفضية” ، يستخدم بيغي استعارة الإدراج لإبراز غموضها. يبدو أن بعض الأحداث “تدخل”، كما يُقال، في التاريخ:
إنه حقًا لغزٌ عظيم، هذا النوع من ربط المادي بالروحي. يكاد المرء أن يقول إنه أشبه بعملية تطعيم غامضة. المادي هو الجذر، والروحي، إذا أراد أن يعيش، إذا أراد أن يُنتج، إذا أراد أن يستمر، إذا أراد […] أن ينبثق ويُثمر، […] مُلزمٌ بأن يندمج فيه . 77
هذا هو سرّ الحدث، وربما الحدث الثوري تحديدًا 78. إنه يُشكّل “عصرًا” 79. الزمن مُعطّل ومُعلّق، مُتاح ومُراوغ. في الحوار السري الذي دار مع ميشليه، يُرجّح أن شخصية ألفريد دريفوس قد بدت لمؤلف “جان دارك وشبابنا “ بمثابة إحياء لهذا العصر المُسيحاني الذي أُسس عام 1789. بالنسبة للمؤرخ، أضاعت الثورة الفرنسية فرصة جعل الشعب السند الحقيقي للمدينة. هكذا كان أصل مشروعه ورسالة المؤرخ: سلطة قضائية ومهمة إحياء في آنٍ واحد. ستُشكّل قصة الشعب، ولفتته، الحلقة المفقودة: “يُرحّب التاريخ بهذه الأمجاد المُحرومة؛ يُعيد الحياة لهؤلاء الموتى، ويُحييهم […] وهكذا تُبنى عائلة، مدينة مشتركة بين الأحياء والأموات” 80 . تتخلل ذكرى ميشليه العديد من تطورات بيغي التاريخية – لا سيما في كليو . كلاهما يسعى بلا كلل إلى نفس المسعى: ما هي المدينة الحديثة ؟ كيف يمكننا تنظيم مجتمع الأجيال الذي يتجاوز الزمن وإدارة التراث الذي يضمن تماسكه – أن نكون، كما حلم ميشليه، “مديري ممتلكات المتوفى” 81 ؟ كيف يمكننا إحياء صوت الإنسانية في كل منا، وبناء جسر بين عبء المسؤولية التي تجعلنا ضمانات الاستمرارية، والحرية التي لا تُقهر والتي بدونها سنبقى خاضعين لتكرار جميع المصائر؟
4.2. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
لذا، لا بد من القول، وبكل جدية: إن قضية دريفوس كانت قضيةً مُختارة . 82 ومثل ميشليه، فإن بيغي مفتونٌ ومسكونٌ بمسألة الاختيار هذه – تجسيد الروحاني في الدنيوي، أو دمج الأبدية في الزمان. ” مسألة إقامة العبقرية […] من أصعب الأسئلة التي طُرحت على الإطلاق في علم النفس والأخلاق والميتافيزيقيا.” 83 ويبدو أن هناك أحداثًا مختارة واستثنائية :
إن وجود أمور لها قيمة حقيقية ومطلقة […] هو بالتأكيد أحد أعظم أسرار الحدث، وأحد أكثر مشاكل التاريخ إيلامًا؛ […] وأخيرًا، أن وجود البشر، أو حتى الآلهة، المنتخبين زمنيًا، ليس فقط، بل شعوب بأكملها منتخبة زمنيًا وربما أكثر، هو بالتأكيد ربما أعظم أسرار الحدث. […] إنها أعظم مشاكل الخلق 84 .
في ثلاثية “الشعب المختار، الآلهة المختارة، البشر المختارون”، يرى بيغي بلا شك عودة العلاقات المعقدة بين اليهودية والمسيحية والثورة الفرنسية. إذا أُريد للمدينة الحديثة أن تستحق لقبها، فلا يمكن أن تولد ، كما اعتقد ميشليه، من ثورة شعبية فحسب . سيتعين عليها أيضًا أن تتصالح مع الموروثات الرئيسية الثلاثة التي سبقتها، وأن تدمج الإرث الفردي للإنسان وحقوقه . وكما أوضح عمل ألكسندر دي فيتري بإعجاب، فإن نهج بيغي الفكري ينبع من علاقة متضاربة مع الفردية الجمهورية . 85 إن “بناء المدينة” لدى الراديكاليين، من خلال خضوع مُسيء الفهم للتقاليد الثورية لعام 1789، يميل إلى تفضيل الدولة باعتبارها الشكل الجماعي الحاسم. يُكافح بيغي ليدرك نفسه في سياق يبدو له أنه يقود إلى “تعاليم” الدولة. إذا كان مستعدًا للاعتراف، على غرار دوركهايم أو سان سيمون أو حتى كونت، بالأسبقية “العضوية” للاجتماعي على الفرد، فإنه يُصرّ مع ذلك على مقولة العلاقة. تبقى المدينة حية ما دامت قادرة على منع الوساطات التي تُنشئها – والمدرسة خير مثال على ذلك – من أن تُصبح نخرية. بعبارة أخرى، الفردانية دائمًا غزو، صراع، وليست أبدًا مقولة امتلاك.
نفهم إذًا الشدة التي تدافع بها نصوص مثل ” من أجل الإيجار” أو “الفضة” عن رسالة المدرسة . فهي مسؤولة عن بناء الرابط ، وهي مكانٌ للوساطة بامتياز، وتقع على عاتقها مهمة العمل كذاكرة حية، وأن تكون المكان الدائم للتذكير. “وكلما امتلكنا ماضيًا أكثر، امتلكنا ذاكرة أكبر (وكلما زادت مسؤولياتنا، كما تقول)، وازداد حرصنا (…) على الدفاع عنه”. 86. إن المجتمع الذي لم يعد يُعلّم نفسه، والذي تُختزل رموزه الحية في رسائل أو شعارات ميتة، سيفشل بالتالي في إنتاج مواطنين. فالذاكرة، ككائن حي، تتطلب التواصل؛ أما ككائن ميت، فهي ليست سوى تكرار تلقائي لصيغ مُضللة ومكررة.
بعيدًا عن كونه دافعًا للخراب، يُفضّل بيغي أن يُصوّر – وفقًا للتعبير الذي يُطبّقه دانيال بن سعيد على والتر بنيامين – “حارسًا مسيانيًا” 87. إن لم تكن نفخة رئوية ، أي مجردة من كل محتوى، فإن المواطنة هي أكثر الأشياء إلحاحًا. إنها تفترض قلقًا أبديًا ويقظة دائمة. لا يمكن أن توجد مدينة يعتمد إنجازها على التوقع السلبي لآلة إلهية ، جماعية أو لاهوتية. بالمعنى الحرفي، المواطنة هي النضال.
رغم أنه لم يتعافَ تمامًا مما اعتبره فشل دريفوسية – تدهور الغموض في السياسة، وتحول المواطن إلى ناخب – إلا أن بيغي لم ييأس أبدًا من بناء هذا “المجتمع المدني”. ويعتقد أنه كاد أن يُحقق النجاح:
لقد كان الأمر بمثابة مكالمة قريبة، كما نعلم، [بالنسبة للعالم الحديث] ليكون عالمًا اشتراكيًا أو شيوعيًا. ولكن اتضح أنه لم يكن شيئًا على الإطلاق. لقد كان أمرًا قريبًا من ذلك. وليس من المبالغة على الإطلاق التأكيد على أنه في الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر وحتى فجر هذا القرن العشرين الحالي، كانت الشيوعية أو الاشتراكية أو الجماعية أو الفوضوية أو الفوضى في بطنها ما هو مطلوب لإحضار عالم جديد إلى العالم […]، على الأقل عالم زمني، […] أريد أن أذهب إلى حد القول بعالم روحي. […] يمكننا القول […] أنه في هذا الدريفوسية كانت هناك على الأقل المادة اللازمة لإنشاء عالم وربما أكثر بكثير من مجرد إشارة إلى الشكل 88 .
لكن قد يقول قائل: ألم يختبر القرن العشرون هذا “الشكل”؟ ألا تُنذر هذه الفلسفة، برغبتها في إرساء المواطنة من خلال ربط الروحي بالدنيوي، بقدوم وحوش باردة؟ 89 إذا كان من الممكن اللعب بلا حدود بالأوهام الاسترجاعية، فيمكن للمرء أيضًا أن يجعل تناقض بيغي يظهر في شكل آخر. يقول: “لقد تخلينا عن الجمهورية، لكننا تعلمنا الحكم” . 90 ورثة التحالف غير المتوقع بين الديمقراطية والليبرالية، و”مجتمع الأفراد” غير المحتمل، نفكر في المواطنة من منظور التنظيم السلمي للمصالح. إذا كانت الجمهورية تعني بالطبع “الحكومة”، فهل من المؤكد أنه يمكن اختزالها في هذا؟ أليست أزمة المواطنة أيضًا ما يؤثر على نوع القداسة التي قام عليها مجتمع المواطنين، أي إمكانية وجود روح مشتركة ؟ حتى في أكثر الطرق قسوةً، تكمن فضل بيغي في مواجهتنا بمستقبل المقدس في نظام ديمقراطي، بالإضافة إلى شرعية الأشكال القادرة على ضبط تجاوزاته. أسئلةٌ مُلحّة؟ ولكن في النهاية، قال شاعرٌ : “التراجع إلى السطح لا يمنع المرء من التقدم تحت الأرض. الحركة السطحية أحيانًا ما تكون مجرد تيارٍ مُعاكس” 91 .
الكاتب:
-
Docteur de l’Université Paris X ; chercheur associé au Laboratoire Logiques de l’agir (EA 2274).