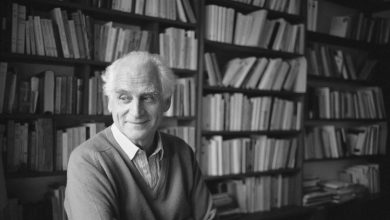حاورها: محمد بن الظاهر
(أستاذ مادة الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب)
بهذا الحوار الشائق العذب في قضايا فلسفة العلوم، تفتحنا يمنى طريف الخولي على آفاق رحبة تفكك وتببني بها فسائل من فهوم جديدة، هذه المفكرة والمترجمة البارزة في الأوساط الأكاديمية العلمية عرفت بانشغالاتها في ترسيخ الثقافة العلمية والفكر العقلاني. كل حوار مع يمنى طريف الخولي يعد بمثابة شهادة على فكر، كان وما يزال، متقدًا وصَحَّاحًا.
مرحبا بك دكتورة يمنى، في البدء أود سؤالك عن الحدود الفاصلة بين العلم والفلسفة، بمعنى أين تنتهي الفلسفة ويبدأ العلم؟
العلم الرياضياتي التجريبي منحصر في الكون الفيزيقي، أي العالَم الطبيعي العينيّ المشهود، المشترك بين البشر أجمعين. يفيض علينا بنوعية خاصة من المعرفة، لها مصداقية استثنائية. العلم معرفة بالعالم الواقع، سواء الواقع الكوزمولوجي الفلكي الفيزيائي بلغته الرياضية، أو الواقع البيولوجي الحيوي بلغته التكسونومية أي المصنفة لسائر الكائنات الحية وظواهر الحياة، أو الواقع الإنساني بظواهره الفردية والجمعية بلغات عدة. إنه عالم الشهادة بالتعبير الإسلامي النافذ، وليس عالم الغيب الأجل شأنًا، لكن لا شأن للعلم به، لا نفيًّا ولا إثباتًا. طبعا الغيب ليس البتة موضوعًا للعلم الرياضياتي التجريبي، الذي علم البشر التخصص الدقيق.
أما الفلسفة فهي مبحث المفاهيم والمقولات، تاركةً الواقع والوقائع لمباحث العلوم التجريبية. مجالها الوجود بما هو موجود، والمعرفة بما هي معرفة، والقيمة بما هي قيمة. العلم معرفة منصبة على الظواهر، أما الفلسفة فهي معرفة منصبة على الوعي البشري. وهما، أي الفلسفة والعلم بمعية سائر مكونات العقلية الحضارية، يتفاعلان ويتكاملان في منظومة الثقافة الإنسانيةالمتطورة. لا معنى ولا جدوى من محاولة ترسيم حدود فاصلةوتحديد نقطة بداية ونقطة نهاية لفاعلية كل كيان، بل إن هذا مستحيل.
صحيح أن الميتافيزيقا من ركائز الفلسفة بالإضافة إلى الإبستمولوجيا؛ إذن ماهي العلاقة بين العلم والميتافيزيقا؟وهل يمكن الحديث عن نوع من الميتافيزيقا الكفيلة بمرافقة العلم في الكشف عن الحقائق؟
أولا، العلم لا يكشف عن حقائق، هذا تصور بدائي ساذج، فما هي الحقيقة؟ وأين توجد؟ ثم أن الحقيقة لا تكون حقيقةً إلا إذا كانت ثابتة مطلقة، والعلم لا يعرف ثباتا ولا مطلقا. إنه بصميم بنيته كيان دائم التغير والتطور، بمثابة التمثيل العيني والتجسيد الماثل لمقولة التقدم المتوالي. قضايا العلوم قابلة دوما للاختبار والتكذيب والتعديل والتطوير.. للتقدم. وهيليست حقائق كما أشرت بل فروضًا. ليس العلم بناءً مشيداً من حقائق قاطعة، بل هو نسقمتنامٍ من فروض ناجحة، كلُ يومٍ فروضٌ أنجح من سابقتها، أجدر وأقدر. كل يوم جديد يتلافى أخطاء وقصورات القديم، فيلغيه أو على الأقل يستوعبه ويتجاوزه، ويقطع في طريق التقدم خطوة أبعد منه، في صيرورة – تغير مستمر نحو الأقرب من الصدق، الأفضل والأقدر.
وتأتي فلسفة العلم كصياغة منهجية ومنطقية للطاقة التقدمية العظمى المتوشجة في بنية العلم، ثم تنضيد علاقات العلم بالكيانات الذهنية والثقافية الأخرى، وبالتالي فإن فلسفة العلم كامتداد لمبحث الإبستمولوجيا، هي الكفيلة بمرافقة العلم في طريقه الصاعد دوما.
أما الميتافيزيقا، فإنالعلاقة بينهاوبين العلم من كبريات القضايا وأعقد الإشكاليات، شهدت وتشهد مداخلات ومقاربات ورؤى ومنظورات تختلف وتتفاوت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن الـتأكيد الدامغ إلى الإنكار التام. هكذا تترسم العلاقة بين العلم والميتافيزيقا وفقـًا للموقف الذهني والاتجاه الفلسفي، وتتغير بين اتجاه وآخر.
هل هنالك حدود لقدرة العلم على تفسير العالم؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ كيف يمكن للفلسفة أن تملأ هذه الفجوات؟
أحسبني قد أوضحت في فاتحة الحديث أن حدود العلم هي حدود الكون الفيزيقي، وإن كان هذا الكون لامحدود! أوضحت أيضا أن العلم معنيٌ بالظواهر والوقائع،بينما الفلسفة معنية بالمفاهيم والمقولات. المجالان متقابلان ونمطا الجهد مختلفان؛ قد يتحاوران ويتكاملان، ولكن لا يملأ أحدهما فجوات الآخر. وبشكل عام، ملء الفجوات مجهود ذاتي، كل كيان ينجز بإزاء فجواته قدر استطاعته وممكناته.
إذا ما تتبعنا تاريخ العلم من العصور القديمة إلى اليونان مروراً بالعصور الوسطى وعصر النهضة والعصر الحديث إلى عصر “النظرية النسبية”، إذا ما صح تحقيب القرن العشرين بها،والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي؛ نجد أن العلم بعد الثورة الصناعية يعتمد على التجريب المعملي والتكنولوجيا المتقدمة للتحكم في المتغيرات، فما هي التجربة العلمية الآن؟ وماهي أهمية التجارب العلمية في اختبار النظريات العلمية؟
اعتماد العلم على التجربة والتجريب المعملي الإمبيريقي من صميم العلم وصلبه، أو ماهيته وكينونته، وليس واقعة طرأت قبل أو بعد الثورة الصناعية أو سواها.المنهج العلمي بألف ولام العهد هو المنهج التجريبي، وفلسفة العلم في كلمة واحدة هي فلسفة التجريبيةEmpiricism، خصوصًا أن فلسفة الرياضيات قد تُعد مبحثا منطقيا.
التجارب العلمية ليست مسألةٌ أقل أو أكثر أهمية في اختبار النظريات العلمية، بل إن التجريبية هي ذاتها الاختباريةTestability. بعبارة أخرى، التجريبية التي يقترن بها العلم ليست معينا نغترف منه النظريات كما نغترف الطعام من الإناء، بل إن التجريبية في صلبها عملية اختبار مستمرة للفروض العلمية. وهنا تتجلى عبقرية اللغة العربية التي وضعت مصطلح “المُخْتَبر” مرادفًا للمعمل ورمزه النمطي أنبوبة “الاختبار” الشهيرة.
معنى هذا أن التجربة المعملية في جوهرها اختبار للفرض العلمي المطروح للبحث. الفرض قضية كلية، يبدأ بها العالم ثم يستنبط نتائجها وما تتنبأ به، أي يخرج منها بقضايا جزئية، فيدخل المعمل ويصمم التجربة ليواجه هذه القضايا الجزئية بالوقائع التجريبية التي تتأتى في التجربة المعملية، ويكون قبول الفرضالمطروح إذا اتفقت الملاحظات المعملية مع النتائج المستنبطة منه، ورفض الفرض أو تعديله إن تناقض مع الملاحظات.ذلكم هو التوصيف العام لمنهج العلم،فيُسمي المنهج التجريبي في نظريته العامة “المنهج الفرضي الاستنباطي Hypothetico-DeductiveMethod”. وتفصيل هذا والإحاطة بأصوله وأبعاده وآفاقه مطروح في آخر كتاب صدر لي “منهج العلم: الرياضياتي.. الطبيعي.. الإنساني، أقلام عربية، القاهرة، 2025”.
المهم أن نلاحظ كيف تقوم وقائع التجريب والملاحظات المعملية بدور ناقد قاسٍ لا يعرف الرحمة حين تعيينه لمواضع الخطأ، دور الفيصل والفاروق بين الصدق والكذب، القاضي الحاتم ذي الحكم الموجب النفاذ: إنها مسئولية عسيرة أمام الواقع والوقائع لا يقوى على الاضطلاع بها إلا المنهج العلمي. فهو التآزر الجميل المثمر الخصيب بين الذهن والحواس، اليد والدماغ، الفكر والواقع، إنه العقلانية التجريبية، حيث التجارب محك واختبار لإبداعات العقل.
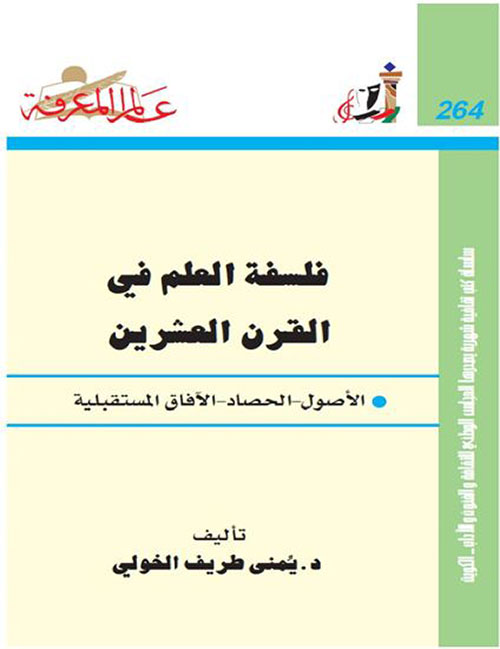
بخصوص التقدم العلمي؛ ما هو التقدم في العلم؟ وكيف نحدد ما إذا كان العلم يتقدم؟ وهل بشكل خطي، أم أنه يمر بفترات من الثورة العلمية؟
ورد في حديثنا وقوفٌ إزاءَ التقدمِ العلميّ وكيف أنه مفطور في البنية المنطقية للعلم. التقدم العلمي مسألة قائسةو مقيسة، أي قابلة للقياس الدقيق كما وكيفا. هذا على أساس أن العلمَيضطلع بأربعِ وظائف معرفية هي:التوصيف، والتفسير، والتنبؤ، والسيطرة التقانية أو التكنولوجيا.ذلك أن الهدف من البحث العلمي التجريبي هو الإجابة على السؤال: كيف ولماذا تحدث الظاهرة موضوع البحث؟ المرحلة الوصفية تجيب على السؤال: كيف تحدث؟ كيف تتبدى الظاهرة؟ وليس الوصف العلمي أمرا يسيرًا أو هيناً، إنه بمثابة اكتشاف للظاهرة موضع البحث، ومعيار وجود العلم الذي يبحثها. ولكن الوصف لا يكفي؛ فتمهيد الطريق للسيطرة على الظاهرة، فيما يعرف بالتقانة (التكنولوجيا) يستلزم الانتقال من المرحلة الوصفية، وبُناءً عليها، إلى المرحلة التفسيرية التي تجيب على السؤال: لماذا تحدث الظاهرة؟ وهنا ترابط العلوم الأساسية أو البحتة أو النظرية العامة، التي تمثل محاولة العقل العلمي للإحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة.
أما التنبؤ، فهو في واقع الأمر محك نجاح الوصف والتفسير، وهو وظيفة وخاصية لقوانين العلوم الطبيعية، ومادام القانون العلمي يخبرنا بشيء عن الواقع فهو يحمل تنبؤًا. مثلا أبسط قانون [ الماء يغلي في درجة 100° ] إنما يعني التنبؤ بحدوث الغليان حين تبلغ حرارة الماء هذه الدرجة. وتأتي الوظيفة الرابعة، أي السيطرة أو التقانة كغاية منشودة من العلوم التجريبية، وهي المحصلة للنجاح في أداء الوظائف الثلاث السابقة.
ومادام التنبؤ محكاً والسيطرة محصلة أو نتـيجة، نخلص إلى أن الوصف والتفسير هما الوظيفتان المعرفيتان الجوهريتان للعلم. وقيل إن الوصف هو جسد العلم ومحك وجوده، والتفسير روحه وهو الإحاطة بالظاهرة. وتبلغ المرحلة التفسيرية اكتمالها المنطقي في النظرية العامة أو البحتة، التي تعني الدامغ المعتمد للنسقية العلمية. مسار العلم هو التقدم المتوالي نحو توصيفات أشمل وأكمل وتفسيرات أدق وأعمق وتنبؤات أكثر تفصيلا وانضباطا وسيطرة تقانيّة أكثر فاعلية وإحكامًا، باختصار هو التقدم نحو الأنجح والأفضل كمًا وكيفًا.
وبشكل عام يسير التقدم العلمي عبر آليتين هما التراكم والثورة. يشير التراكم إلى التقدم الكمي في الحصائل المعرفية التي تتزايد وتتكاثر، بينما تشير الثورة إلى تقدم كيفي والصعود إلى منظور مختلف ورؤية مستجدة واعدة بالمستجد تمامًا.
والواقع أن التفسير الثوري يبدو الأقدر على تفسير طبيعة التقدم العلمي، حتىبات مفهوم “الثورة” مقولة مركزية في فلسفة العلم.ولا يدهشنا أن الثورة في أصلها مفهوم علمي، ومن العلم اقتبست الحضارة مفهوم الثورة. وبشكل عام تَعني الثورة نمطـًا من التغيير السريع المفاجئ، مُغايرا لمجرد النمو أو حتى التطور الذي هو تغير تدريجي بطيء.
في الأصول الإيتمولوجية أي أصول الاشتقاق اللغوي للفظة “الثورة revolution” في الإنجليزية، نجدها تأتي من المقطعين: دورة volution، والمقطع القبلي الذي يفيد إعادة أو تكرار: (re)؛ وبالتالي تعني اللفظة إعادة دورة، إتمام وإنهاء دورة لتبدأ دورة جديدة. وكان علماء الفلك في القرن السابع عشر أول من صاغ واستحدث هذه اللفظة من المقطعين المذكورين، لتكون مفهوماً علمياً بحتاً، فلكياً رياضياً، يختص بدورة الجرم السماوي في مداره، حيث تعني Re-volution : ثورة / إنهاء دورة واستهلال دورة جديدة، وبالتالي تعني revolutionary: ثوري… جذري… متطرف وأيضا دوّار.
على هذا النحو تشير اللفظة في أصولها إلى بدء الكوكب دورةً جديدةً في مداره..عام جديد من زمانه. ولأنها تشير إلى تغير ذي اعتبار وعهد جديد، فقد انسحب استعمالها إلى مجال الأوضاع المدنية التي بدت هي الأخرى في حاجة إلى الإشارة لانتقال جذري إلى مرحلة أعلى آن أوانها، لانتهاء المرحلة السابقة أو استنفاد مقتضياتها. وكان المقصود آنذاك انتهاء عصر الإقطاع وسيطرة الكنيسة والمنطق الأرسطي.. انتقالا إلى مرحلة البرجوازية والدولة المدنية والمشروع الاستعماري للسيطرة على العالم…. إلخ؛ فشاع وذاع استعمال مفهوم (الثورة) للإشارة إلى تغيرات سياسية واجتماعية.
ولئن أبدى مفهوم “الثورة” فعالية في تفسير تحولات تاريخ المدنية، فسوف يبدي فعالية أكثر في موطنه الأصيل: أي في تفسير تاريخ العلم وطبيعة التقدم العلمي. والتاريخ المتقد للعلم لا تحيط به إلا الرؤية الباحثة عن ثوراته. قد تستمر تراكمية التقدم العلمي حقبة ما، نظرية تتلو نظرية وكشف بجوار كشف، وكأن العلم مخزن بضائع يمتلئ باطراد، أو أن البحث العلمي يشكل لوحة فسيفساء تكتمل تدريجياً. والعلم ليس هكذا، بل هو فروض جريئة، تعقبها اختبارات وقضايا تصحح قضايا. من ثم تأتي في أعقاب التراكم لحظةُ اكتشافِ قصورٍ ما أو خطأ في نظرية معمول بها وظهور إشكالية علمية مستجدة، ويتقدم لمحاولة حله فرض جديد يمثل ثورة/ دورة جديدة.
تحدث خطوات التقدم الجذري في العلم عبرحدوسات جريئة تمثل قفزات ثورية، تعقبها أفكار تصحح أفكارا،سلسلة متوالية من ثورات كبرى وصغرى، انتهاء دورة محورية أو فرعية.. وبدء دورة جديدة. طريق العلم هو طريق التقدم المتوالي.. طريق الثورة/الدورة.
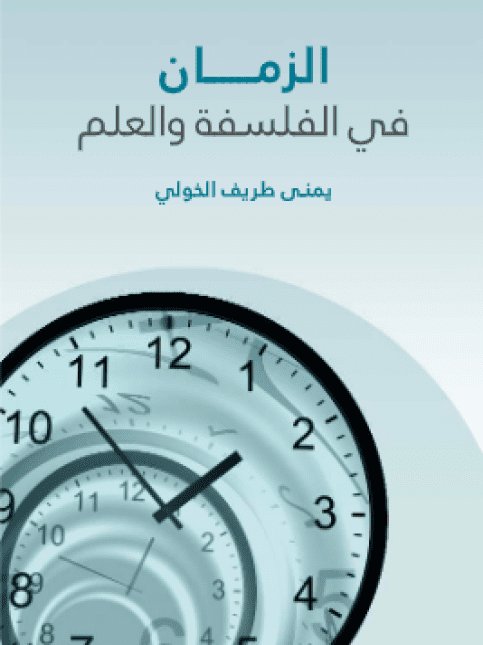
طبعا لا يمكنني أن أفلت الفرصة وألا أطرح سؤالا من صميم واقعنا والمرتبط بتخصصكم، إننا نعيش في عالم جامع بحيث أن الأخلاق آخر اهتماماتهوتصلنا أصداء حروب متطورة وبالتالي ما هو دور الفلسفة في توجيه النقاشات حول أخلاقيات البيولوجيا والتكنولوجيا الطبية؟
أخلاقيات البحث العلمي، وأخلاقيات الطب والتكنولوجيا الحيوية وصولا إلى أخلاقيات التكنولوجيا الرقمية وأخلاقيات الاتصال…إلخ باتت شغلا شاغلا للفلسفة الآن. من إسهاماتي أن شهدت المكتبة العربية منذ عشرين عاما عن سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون بدولة الكويت الترجمة العربية لكتاب “ديفيد ب. رزنيك،أخلاقيات العلم: مدخل، العدد 316، يونيو 2005.” نقله إلى العربية تلميذي الدكتور عبد النور عبد المنعم رحمه الله وأكرم مثواه، وقمت بصياغة المصطلحات ومراجعة الترجمة والتقديم لها وتزويدها بهوامش شارحة. لعل هذا الكتاب أول اقتحام منهجي في الثقافة العربيةلذلك الجهد الفلسفي الدؤوب في موضوعه أي أخلاق العلم والبحث العلمي.ومنذ العقود الأخيرة في القرن العشرين ثمة تيار دافق في العالم بأسره، حتى ظهرت هيئات ومنشورات رسمية وقوانين تصوغوتصون هذه الأخلاقيات. وتتدفق هنا وهناك مقاربات الأخلاقيات التي أشرت إليها، في العالم بأسره وفي الوطن العربي بالطبع. شخصيا ناقشت العديد من الرسائل الجامعية تبحث في أخلاقياتالعلم. الفلسفةلا تتوانى أبدًا. وتظل الأزمة في شذوذات الواقع، من قبيل الدول المارقة التي تتملص من محكمة العدل الدولية لتصون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حتى ولو كانت ببشاعة الإبادة !!
أخيرا أود ًسؤالكم أستاذتنا بعد كل ما راكمته من تجارب ومؤلفات، ماهي النصائح التي تقدمينها للباحثين الشباب الذين يهتمون بفلسفة العلم؟
أنصحهم بالالتفات إلى اتجاهات مابعد الحداثة وما بعد الاستعمار في فلسفة العلم، أو بعبارة أخرى إلى فلسفة العلم بعد توماس كون وكتابه اللافت “بنية الثورات العلمية- 1962″، وله أكثر من ترجمة عربية جيدة.هذا الكتاب جعل فلسفة العلم لا تقتصر على منهجية العلم ومنطقه، أي على النظرة إلى نسق العلم من داخله وفي حد ذاته، بل أصبحت فلسفة العلم لا تنفصل عن تاريخه وتطوره عبر المراحل أوالبارادايمات/النماذج القياسية الإرشادية المتتابعة، وتفاعله مع العناصر والبنيات الثقافية الأخرى.
بهذا تنهار غربة العلم واغترابه وزيف الزعم الاستعماري بأن العلم غربيّ وأن الغرب هو الحضارة التي صنعت العلم وتملكه، وعلينا أن نستجديه منها. عبر مفهوم البارادايم تتبدى حقيقة ظاهرة العلم عبر مسار الحضارة الإنسانية، وكيف ساهمت في صنعه أمم شتى. وقد كان دور الحضارة العربية الإسلامية محوريا، لإنها حملت راية البحوث الرياضية والتجريبية فيما سمى بالمرحلة الوسيطة التي كانت شمسها غاربة عن الغرب ومشرقة في الشرق. وتقدمت ترجمات الرصيد العربي إلى اللغة اللاتينية ثم لغات أوربية أخرى كاللغة الإيطالية بوصفها المقدمة الضرورية المفضية منطقيا وتاريخيا وجغرافيا إلى ثورة العلم الحديث في أوروبا في القرن السابع عشر.
بارادايم توماس كونجعل فلسفة العلم شاملة لسائر أبعاد ظاهرة العلم، الثقافية والقيمية والسوسيو- سيكولوجية والسياسية والاقتصادية والبيئية….. إلخ. بعبارة موجزة، فلسفة العلم بعدالحداثية باتت رؤية بانورامية شاملة لظاهرة العلم في السياق الثقافي وعبر تاريخ الحضارة.