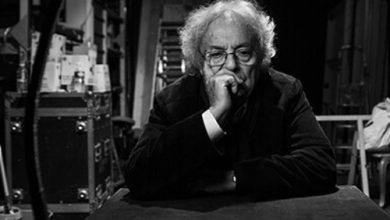الأزمة العالمية لتقدير الذات.. النتائج المدمرة لمعايير النجاح في الرأسمالية

بقلم ليو روجرز
يُوصف أوائل القرن الحادي والعشرين بأنه عصر الأزمات. فالديمقراطية الليبرالية، والاقتصاد الأمريكي (أو العالمي)، والبيئة، والذكورة، وشيخوخة السكان، والهجرة، والمعلومات المضللة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها يُفترض أنها تمر بأزمة – تُرقى إلى ما أسماه البعض “أزمة عالمية متعددة “. لذا، يُعذر القارئ على تشككه، إذ أعتمد على الأدبيات الفلسفية حول نظرية الاعتراف لأُعرّفه أكثر على هذه المرحلة. مع ذلك، تُفسر هذه الأزمة بعض الأزمات الأخرى – وتُقدم منظورًا مُستنيرًا لبعض التوترات في حياتنا اليومية.
هناك أزمة عالمية في تقدير الذات. تؤثر على الجميع تقريبًا، ولكن (كما سأجادل) تؤثر على المجتمعات المعولمة وغير المتكافئة اقتصاديًا بشكل أسوأ. تكاد تكون هذه الأزمة غير محسوسة لأننا نعيشها يوميًا، وهذا يزيد من خطورتها. أعني بتقدير الذات تقدير المرء لذاته: ما إذا كان يشعر بالنجاح، أو على الأقل بالقدرة على النجاح، وفقًا لمعاييره الخاصة. إن انعدام تقدير الذات هو الشعور بالعجز، بل وانعدام القيمة. تكمن الأزمة في وجود نقص واسع النطاق في تقدير الذات، ومنافسة عالمية عليه .
لتفسير ذلك، لا بد من العودة إلى انحلال الإقطاع الأوروبي. فرغم كل ما رافق الإقطاع من فظاعة وبؤس، ثمة ما يؤيده: جمود الأوضاع الاجتماعية يحمي احترام الذات. فإذا كان كل ما يمكن للمرء أن يصل إليه هو القن، فإن توقعاته الوحيدة ستكون توقعات العبودية. أما الفجوة بين النجاح والفشل فهي أصغر بكثير: فبما أن توقعات كل فرد نسبية لدوره الاجتماعي المحدد مسبقًا، فإن الحياة الطبيعية هي النجاح. وكما جادل الفيلسوف تشارلز تايلور ، ففي المجتمعات ما قبل الحديثة، “كانت الخلفية التي تفسر ما اعتبره الناس مهمًا لأنفسهم تتحدد إلى حد كبير بمكانتهم في المجتمع، وأي أدوار أو أنشطة مرتبطة بهذا الوضع”.
نظرًا لأننا نرى إنجازاتنا كتعبير عن تفردنا وتكوين هوياتنا بالكامل، فإننا نختبر الحياة الطبيعية (وخاصة الفقر) كفشل شخصي ومصدر للعار.
لكن مع انهيار التسلسلات الهرمية الصارمة للإقطاع تدريجيًا، وانتشار مبادئ الحقوق العالمية والكرامة الإنسانية، أصبح تقدير الذات مسألة أداء فردي. فالمعاملة المتساوية تُبررها إمكاناتنا البشرية المتساوية المفترضة، مما يعني معايير تفوق متساوية لجميع البشر. وبما أن التحرر من صرامة الإقطاع يسمح بالتنوع، فإن إحساسنا بذاتنا يصبح مرتبطًا بما يميزنا كأفراد.
لم نعد نُعرّف أنفسنا بالرجوع إلى الأدوار الموروثة، بل بنجاحاتنا وإخفاقاتنا الشخصية. وكما يقول تايلور:
هناك طريقةٌ مُحددةٌ للوجود الإنساني، وهي طريقتي . أنا مُدعوٌّ لأعيش حياتي بهذه الطريقة، لا مُقلّدًا حياةَ أيِّ شخصٍ آخر… هذه الفكرة تُعطي أهميةً جديدةً للصدق مع نفسي. إن لم أكن كذلك، فسأُفوّت غايةَ حياتي؛ سأُفوّت معنى أن أكون إنسانًا بالنسبة لي .
ثقافتنا مُشبعة بهذه النظرة إلى أنفسنا: فنحن نُصوّر، بشكل متزايد، حتى الجوانب البسيطة من الحياة على أنها تعبير عن تفردنا. يتطلب اختيار مجال الدراسة، أو البحث عن وظيفة، الكثير من التأمل العميق هذه الأيام. جميعنا نُطالب باتباع شغفنا ، مما يعني ضمناً أن على كل شخص أن يمتلك شغفه؛ فالرغبة في وظيفة عادية تُتيح له وقت فراغ كافٍ ليشعر بالسعادة تبدو للبعض بمثابة اعتراف بالنقص.
ومن هنا الأزمة إذن؟ ما الخلل في الأخلاق الاجتماعية الفردية – خاصةً عندما تقترن بالتسامح تجاه تنوع أساليب العيش التي يرغب الناس في اتباعها؟ ألا تُسبب التسلسلات الهرمية الاجتماعية الجامدة والتوقعات غير المرنة الكثير من البؤس؟ المشكلة التي أصفها ليست فردية المجتمع الحديث وتنوعه في حد ذاته، بل هي المنافسة التي تُطلقها هذه الفردية.
لفهم ما أقصده، قارن العلاقة بين خريج جامعي عادي من الطبقة المتوسطة وملياردير في عام ٢٠٢٤، بالعلاقة بين عبد وملك في عام ١٣٥٠ مثلاً. يتمتع خريج الجامعة العادي من الطبقة المتوسطة بحقوق وحريات أكثر بكثير مما كان يتمتع به العبد، ولديه خيارات محدودة متاحة له إذا أراد جمع الثروة لنفسه. هذه هي المشكلة تحديدًا: هناك قدر كافٍ من المرونة بين المراكز الاجتماعية يجعل من الممكن لأي شخص أن يصبح مليارديرًا، وهذا يُغير نظرة الناس العاديين إلى أنفسهم.
أن تكون متوسطًا يعني أنك غير راضٍ تمامًا: إن حقيقة أن الآخرين يفعلون ما هو أفضل بكثير تكشف عن النقص الجوهري (المفترض) لدى الشخص
لكي أكون واضحًا، أنا لا أقول إن الحراك الاجتماعي حي ويسير على ما يرام في الديمقراطيات الغربية. لقد كان في تراجع لعقود من الزمن، وفرص الصعود من القاع إلى القمة (أو العكس) ضئيلة للغاية. والأهم من ذلك، أن مثل هذا الشيء يمكن تصوره . لقد تخيل الجميع، في مرحلة ما، أنفسهم كمؤسسين تقنيين مليارديرين أو مشاهير يوتيوب أو ممول. يشعر الجميع بالذنب على الأقل قليلاً لعدم تمكنهم من إدارته – والأسوأ من ذلك هو أنه نظرًا لأننا نرى إنجازاتنا كتعبير عن تفردنا وتكوين هوياتنا بالكامل، فإننا نختبر الحياة الطبيعية (وخاصة الفقر) كفشل شخصي ومصدر للعار. في المجتمعات الإقطاعية، لم يكن الحراك الاجتماعي جزءًا من مجموعة الأدوات المفاهيمية، لأن معايير النجاح كانت مرتبطة بشكل صارم بالمواقف الاجتماعية غير القابلة للتغيير.
الطريقة الوحيدة للحفاظ على تقدير الذات في ظل الظروف المعاصرة هي التفوق على الآخرين، ولكن هناك دائمًا من يتفوق علينا. أن تكون عاديًا يعني شعورًا عميقًا بعدم الرضا، لأن كون الآخرين (حتى لو كانوا قلة) يتفوقون عليك يكشف عن شعورك (المفترض) بالنقص الجوهري. إن تفاقم هذه المشكلة يكمن في ظل نموذج رأسمالي يتسم بتفاوت حاد في الدخل والثروة. تساهم أزمته إلى حد ما في تفسير الأزمات الأخرى التي نتحدث عنها. خذ على سبيل المثال أزمة الذكورة التي كانت رائجة منذ خمس سنوات أو نحو ذلك. فقد صاحب التباعد غير المسبوق بين التوجهات السياسية للرجال والنساء معدلات انتحار عالية بين الذكور ، وأقلية متنامية منفصلة تمامًا عن سوق العمل (ناهيك عن سوق المواعدة ). أصبحت الشخصيات الديماغوجية مثل المؤثر الذي أعلن نفسه كارهًا للنساء أندرو تيت تحظى بشعبية كبيرة.
هناك إجماع واسع النطاق على أن شيئًا ما يحدث مع الرجال والرجولة: إما أن الرجال يشعرون بالإحباط والارتباك بسبب فقدان الامتياز (وفقًا للقصة اليسارية الليبرالية) أو أنهم يخنقون بالمعايير الاجتماعية المؤنثة ويمنعون من أن يكونوا رجالًا حقيقيين (وفقًا لتفسير اليمين البديل).
أزعم أن التنافس على تقدير الذات، وما ينتج عنه من انعدامه على نطاق واسع، هو المسؤول عن الكثير مما نعزوه إلى أزمة الرجولة. يشعر الرجال بالإحباط لأنهم يشعرون بالفشل، ويشعرون بذلك لأن – بالنظر إلى طريقة توزيع مجتمعنا لتقدير الذات – يكاد يكون من الضروري أن يشعر الجميع بالفشل. يزداد غضب الرجال وانعزالهم عن المجتمع السائد، ليس فقط لأنهم لا يعرفون معنى الرجولة في غياب الامتيازات، ولا لأن النخبة الليبرالية تنشر معايير سلوكية تقمع رجولتهم. بل إن الغضب والانعزال هو الاستجابة الإنسانية الطبيعية لمجتمع يجعل المرء يشعر بالعجز والدونية، ويمنح شعورًا بالسيطرة لقلة قليلة. (هذا يثير تساؤلًا حول سبب اختلاف استجابة النساء لأزمة تقدير الذات؛ أقترح أن التفاعل بين المعايير الأبوية والتنافس على تقدير الذات قد يعني أن النساء يشعرن بالإحباط نفسه، لكنهن يستجبن بشكل مختلف).
نحن بحاجة إلى إعادة تركيز اهتمامنا على توسيع نطاق الوصول إلى احترام الذات
ينطبق الأمر نفسه على انفصال المجتمعات في المناطق ما بعد الصناعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن سياسات المؤسسات. وكما هو الحال مع أزمة الذكورة، ثمة الكثير مما يجري هنا. ولكن الأهم من ذلك، أن نتناول في نقاشاتنا حول هذه القضية بُعد تقدير الذات. فجزء من الخسارة، عند اختفاء قطاع ما، لا يكمن في الوظائف نفسها، بل في الأدوار الاجتماعية التي تمثلها – فرص الشعور بالنجاح في مجتمع المرء. ولن يُسد هذا الفراغ سوى تخصيص المزيد من الأموال من الحكومة المركزية، أو إطلاق حملات تمثيلية ضد الهجرة، أو تحسين وسائل النقل إلى المدن الكبرى.
إذا كانت المنافسة على تقدير الذات هي المشكلة، فما الحل؟ علينا إعادة تركيز اهتمامنا على توسيع نطاق الوصول إلى تقدير الذات. وهذا يعني ضمان الوصول إلى ما اعتدنا اعتباره مستوى معيشة أساسيًا: عمل مستقر، وسكن لائق، ورعاية صحية.
وهذا يعني أيضًا، كما جادل مايكل والزر وتيمو جوتن وغيرهما من فلاسفة السياسة، إعادة تركيز معاييرنا المشتركة للنجاح. تُسمى هذه المعايير في الأدبيات الأكاديمية “معايير المساهمة”: المعايير التي يجب على المرء استيفاؤها ليشعر بالنجاح، وبأنه ساهم مساهمة فعالة في المجتمع.
يجب أن ننتهز كل فرصة لتكريم الإنجاز البشري بجميع أشكاله المتنوعة: يجب أن نعيد تركيز اهتمامنا على رعاية أحبائنا، والإبداع الفني، والمشاركة في النشاط السياسي المحلي، والتطوع في المجتمع. يمكن أن يبدأ هذا بإصلاح نظام التعليم والقيم التي يغرسها في الأطفال. وأخيرًا، يجب أن نذكر أنفسنا بأن نجاح أي شخص يعتمد إلى حد كبير على الحظ (كما جادل مايكل ساندل في كتابه ” طغيان الجدارة” (2020)). هذا ليس مهمًا لمجرد تداعياته على توزيع السلع المادية؛ بل إن التأمل في أهمية الحظ يمكن أن يكون بمثابة تمرين تأملي، لتخفيف حدة التنافس على تقدير الذات.