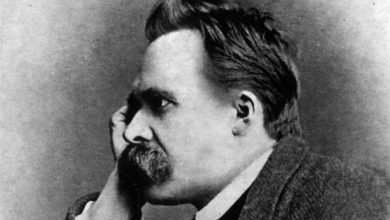فلوران بوسي: عصرنا يحمل في داخله الكارثة
النتيجة الكارثية الأولى لوصول الإنسان إلى مرحلة النضج هي أن الإنسان الحديث أصبح مستاءً من كل ما وهب له، حتى وجوده الخاص

لوسات أنفو: اقتراح باسم الشغوف
” في هذا النص يتأمل المفكر و الناشط البيئي فلوران بوسي، فكرة الكارثة، مقترحا مدخلا للتفكير في كوارث عصرنا، إن لم يكن هذا العصر في حد ذاته هو الكارثة..”
التفكير في الكوارث المعاصرة يجب أن يجعل من الممكن تسليط الضوء على خصوصياتها، بما يتجاوز القواسم المشتركة الواضحة للأحداث المتطرفة التي عانى منها البشر منذ بداية تاريخهم. ومن الضروري بالفعل تجنب الوقوع في مأزق الارتباك التاريخي الذي يتجاهل حقيقة أن عصرنا يحمل في داخله الكارثة، لأنه يثيرها ولأنه ينفيها. إن معرفة الكوارث الحالية والمستقبلية الجديدة تظهر أولاً كاعتراف بالسبب الذي يجعلها كوارث “نحن”. ولا يمكن للسياسة أن تكون على مستوى تحديات العصر إلا بهذا الشرط، وهو أيضًا ثمن.
إن فكرة الكوارث العالمية تثير في كثير من الأحيان السخرية، لأن الوجود الحالي للعالم سيكون دليلاً من لحم ودم على أنه تم تجنب الكوارث أو أن آثارها كانت جزئية فقط. “لا يكفي جلد قطة”، “هراء دعاة نهاية العالم”، سيقول من يسمون بالمفكرين الواقعيين.
ومع ذلك، فإن وضعنا يقاوم ما يسمى بواقعية القياس والحس السليم، لأن شيئًا ما قد تغير في طبيعة الكوارث التي يواجهها الإنسان بشكل دوري، وهو ما يجعل من المستحيل علينا أن نعلن ببساطة، بشكل عرضي أو واثق، أن:غدًا كما اليوم (اليوم كما بالأمس)، سوف يتعافى العالم من العنف الذي هزه لبعض الوقت. هذا هو التغيير الذي نقترح مساءلته هنا، لأنه يتعلق بحالة الإنسان المعاصر.
سوف ندرك بسهولة أن هذه الكوارث تجد مصادرها في تصرفات الإنسان. ولكن، بعيداً عن ما هو واضح، هناك الرابط الذي يوحد الكوارث التي تجتاحنا اليوم ـ والتي تستمر حدتها في النمو ـ بالعلاقة التي يحافظ عليها رجال الحداثة المتقدمة مع الطبيعة والعالم والوجود.
نتحدث هنا عن “كوارثنا”، لأن الكوارث التي من المناسب التفكير فيها، والتي تشكل الحقيقة الكبرى في عصرنا (وبخاصة تلك التي لم تحدث بعد ولكن تم الإعلان عنها)، تأتي منا، بدلاً من أن تسقط. بالنسبة لنا على أنها “كوارث طبيعية” أو “غضب إلهي”. انفجرت «كوارثنا» على الشاشة، وتردد الأخبار اليوم أصداء الكوارث من جميع الأنواع التي تتخلل تاريخ العالم. ومع ذلك، فهو في الواقع أمر غير مدروس، غير مفكر في عصرنا، الذي لا تأخذه أي سياسة في الاعتبار، ولا يأخذه أي تحليل إعلامي في الاعتبار، لأنه لن يكون من حق البشرية المنشغلة بمهام أكثر إلحاحًا وجدية أن تفكر فيه.
إن فكرة الكوارث تدين بالكثير لعمل وتصرفات جونتر أندرس، المؤلف الألماني الذي شارك في النضال من أجل نزع السلاح النووي، والذي لم يكن معروفاً منذ فترة طويلة، وخاصة في فرنسا، ولكن السنوات الأخيرة جعلته فيلسوفاً رئيسياً. منذ انفجار القنبلتين الذريتين، أخذ أندرس يفكر في كوارث من نوع جديد، مصدرها أفعال البشر. انتقل تفكيره من التفكير الأنطولوجي الكلاسيكي إلى ضرورة فهم الوضع الجديد، حالة الطوارئ الحيوية، التي تجد البشرية نفسها في مواجهتها. يهدف هذا المفهوم للفلسفة إلى مواجهة تحديات العصر، وحالة الإنسان في الحداثة المتقدمة، بعيدًا عن أكاديمية الفلسفة الجامعية 2 .
ويصم أندرس ما يسميه “التفاوت البروميثيوني” في عصرنا، أي حقيقة أن ملكاتنا (الفعل، والفكر، والخيال، والمشاعر، والمسؤولية) لا تنجح في الاتفاق، ولكل منها إيقاعها الخاص: فالرجال غير قادرين على ذلك. في التفكير فيما يفعلونه، في فهم معنى ما يعرفونه، في الشعور أو تخيل ما ينتجونه.
وبالتالي، «لا جدال في أننا «نعرف» العواقب التي قد تترتب على حرب ذرية. لكن على وجه التحديد، نحن “نعرف” ذلك فقط. هذه “فقط” تعني أن “معرفتنا” هذه هي في الواقع قريبة جدًا من الجهل. وهو أقرب إليه من الفهم” ( 3) .
يبدو أن الرجال منقسمون عن أنفسهم، على الرغم من أنهم اكتسبوا قوة غير مسبوقة. إننا نشهد استخفافًا شديدًا بالشر، مما يجعله غير محسوس وغير مفهوم. يبتعد الوعي عن كل مسؤولية وعن كل عاطفة. وهكذا أصبحت القنبلة الذرية اختراعا تقنيا كأي اختراع آخر. إن حقيقة أن السلاح النووي الحراري يمكن أن يقتل عدة ملايين من الأشخاص لا ينبغي أن تعيق عملية التصميم والتصنيع.
فشل الخيال يعني «أننا لسنا على مستوى «بروميثيوس الذي فينا» 4. يلخص “التفاوت البروميثيوني” عدم حساسية الإنسان المعاصر تجاه المعاناة التي يساهم فيها. يخضع الناس لعمليات تحيط بهم وتصبح أفقهم الفكري الوحيد، فهم غالبًا ما يتصرفون، في إطار مهنهم وأنشطتهم الترفيهية واستهلاكهم، بما يتجاوز الخير والشر، دون أي اعتبار للتبعات المحتملة. تفعل فعلها، على رجال آخرين، على الطبيعة أو على المستقبل. وهذا يمنحهم الاستقرار العقلي، حيث يتحررون من عبء حرية الوعي الذاتي. “إن الشعور بالأمان هو الثمن الذي ندفعه مقابل مسؤوليتنا، أي حريتنا. وهذا الشعور بالأمان يتدفق نحونا بشكل عفوي وتلقائي مثل الماء والغاز وصور التلفزيون، 5 .
وسوف توجه تحليلات أندرس دراستنا للكوارث، لأنها تسلط الضوء على ما يشكل ينابيعها النفسية الرئيسية، أو على وجه التحديد فقدان الوعي والافتقار إلى المسؤولية.
منذ وقوع كارثة تسونامي التي دمرت سواحل جنوب شرق آسيا في ديسمبر/كانون الأول 2004، أصبحت صور الكوارث مألوفة بالنسبة لنا، وذلك بفضل انتشار وسائل التسجيل المصغرة. لقد رأينا أنه من خلال اختراق المياه للأرض، يمكن للمياه أن تحمل الحافلات والقطارات والمنازل وجميع الأشخاص الموجودين هناك. لقد أذهلنا أيضًا الفرص العديدة التي تحكم موت الأشخاص أو بقائهم على قيد الحياة أثناء وقوع الكارثة. أحيانًا يتم لعب أحداث الحياة في بضع ثوانٍ فقط، وغالبًا ما يكون الجهل وفقدان الوعي حاسمين.
إن السمة الأساسية للكوارث (الهجمات، والفيضانات، والانهيارات الأرضية، والعواصف، وما إلى ذلك) هي الظهور كنتيجة لآليات عمياء يعاني منها ضحايا أبرياء لا حول لهم ولا قوة. وبالتالي كشر كامل، دون عزاء ممكن. يتم تجريم الأنشطة الإنسانية، وفي الحالة الأولى يتم إدانة الإرهابيين. يمكننا أيضًا أن نتحدث عن طرق إلهية غامضة ويمكنها، بطريقة أو بأخرى، أن تجلب التبرير أو العزاء أو الوعد بالانتقام أو الدعم البسيط. لكننا نسارع إلى نسيان هذه الأسباب الحاسمة أو تهميشها، والاحتفاظ فقط بالكارثة بطبيعتها الأولية، لأن كل الأسباب المقدمة ليست كافية لطمس “فضيحة البراءة المنتهكة”، التي تكشفها الصور متى شئنا. وهذا الدليل – الذي يعد التلفزيون ناقله الرئيسي – يفرض نفسه على ضمير الجميع: أفعال الإنسان وإرادته وفكره لا علاقة لها بالكوارث التي تعبر عن بؤس الحالة الطبيعية للإنسان. إن الفيضانات المتكررة في بنجلاديش تسلط الضوء، كما لو كانت هذه الأدلة ضرورية، على المحنة التي يواجهها الإنسان طوال حياته، تماماً كما رافقته الأمراض والموت منذ بداية تاريخه.

لم تدم براءة تسونامي آسيا إلا بضعة أيام. وبطبيعة الحال، تم الاعتراف مرارا وتكرارا بأن الكارثة لا يمكن أن تكون أكثر “طبيعية”، ولكن مع مرور الوقت بدأ هذا اليقين في التفكك. لقد تعلمنا أنه لو لم يتم تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية بلا رحمة بسبب التحضر وتربية الأحياء المائية والاحتباس الحراري، لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدم الموجة القاتلة وتقليص حجم الكارثة بشكل كبير. ثم جاءت اللحظة، يا لسخرية التغطية الإعلامية للعالم، عندما فوجئنا بإيلاء كل هذا الاهتمام للكارثة بأنفسنا. ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للعثور على التفسير المناسب: لم يحدث الزلزال بالكامل في الصحراء، أي في زاوية نائية من العالم الثالث، مثل تلك التي ضربت مدينة بام الإيرانية في العام السابق، ولكن في أماكن يسكنها “سادة المدينة” الذين يطلق عليهم اليوم السياح. وبسرعة كبيرة، اتخذ التسونامي هوية عامل مساعد بسيط للعمليات الاجتماعية بنسبة 100%، تلك التي تساهم في زيادة الظلم الاجتماعي في العالم بلا هوادة. ومرة أخرى، كان مساكين الأرض هم الذين دفعوا الثمن 7 .
ويجب علينا بلا شك أن نؤكد على الاحتمالية التي لا ترحم لوجود الإنسان وجهله الذي لا يمكن التغلب عليه، وألا نحرم إخواننا من البشر، ضحايا الكوارث، مثل كارثة عام 2004، من تعاطفنا وتضامننا ومساعدتنا. ومع ذلك، فإننا نرى على الفور ما هي العواقب التي تترتب على هذا الدليل في الواقع: نظرًا لعدم وجود مسؤولية إنسانية في إثارة الكوارث وتكشفها وتقييمها، فلا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، ولا يمكننا منعها (وهو شيء آخر غير مجرد التنبؤ بها) أو حتى التفكير فيهم. لا يمكننا إلا أن نلاحظهم، ونستعد لهم بأفضل طريقة ممكنة ونتحملهم دون ألم قدر الإمكان. وسيُعاد الإنسان إلى عجزه الطبيعي، إلى ما هو أبعد من الأسطورة الديكارتية المتمثلة في “جعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكيها”.
سوف تستعيد الطبيعة حقوقها، وبالتالي تدعو الإنسان إلى مزيد من التواضع. ستكون الكارثة بمثابة فرصة لا مثيل لها لتقدير وضع الإنسان في العالم والتشكيك في الأسطورة الحديثة حول التقدم اللامحدود في السيطرة على الطبيعة. كان من الممكن أن يتمتع الرجال المعاصرون بتجربة أجداد هنا، وبالتالي كان إعصار كاترينا قد جعل الأمريكيين أقرب إلى البنجلاديشيين أو الهولنديين في القرون السابقة.
ومع ذلك، ليس هناك ما هو أقل يقينا. لا شيء في خطابات السياسيين يشير إلى أن كبار المسؤولين الغربيين يعتقدون أنهم قريبون من كوارث كبرى تدعو إلى التشكيك في أنماط حياتنا وأنماط استهلاكنا، ويعتبرون أنه من الضروري العمل باسم مجتمع مصير الإنسانية الذي لا يمكن إنكاره.
إن النتيجة الكارثية الأولى لوصول الإنسان إلى مرحلة النضج هي أن الإنسان الحديث أصبح مستاءً من كل ما وهب له، حتى وجوده الخاص – مستاءً من حقيقة أنه ليس خالق نفسه ولا خالق الكون. […] إن البديل لهذا الاستياء، وهو الأساس النفسي للعدمية المعاصرة، سيكون امتنانًا أساسيًا للأشياء الأولية القليلة التي تُمنح لنا حقًا ودائمًا، مثل الحياة نفسها، ووجود الإنسان والعالم .