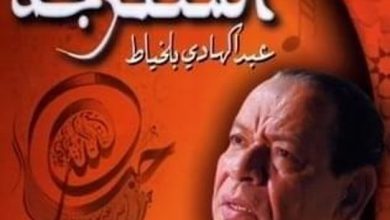بقلم بنيامين موسر
يُسأل الكاثوليك في عيد الفصح: “هل تتخلى عن سحر الشر، وترفض أن تتحكم الخطيئة بك؟” يُبقي هذا السؤال على خلط نادر: كان السحر صفةً تُربك الأشياء، وتُغير أشكالها، وتُضفي عليها هالةً غامضةً؛ كما كتب السير والتر سكوت: “القوة السحرية التي تُفرض على بصر المُشاهدين، بحيث يصبح مظهر الشيء مختلفًا تمامًا عن حقيقته”.
كلاريس ليسبكتور ، الجميلة الأسطورية ، طويلة القامة وشقراء، ترتدي نظارات شمسية جريئة ومجوهرات ضخمة، كإحدى سيدات ريو دي جانيرو العريقات في منتصف القرن العشرين، وقد استوفت تعريفنا الحالي للجاذبية. قضت سنوات كصحفية أزياء، وعرفت كيف تظهر بمظهر يليق بها. ولكن كلاريس ليسبكتور فاتنة بالمعنى القديم للكلمة: ساحرة، ساحرة بكل معنى الكلمة، شبحها العصبي يطارد كل فرع من فروع الفنون البرازيلية.
لقد ازداد سحرها بلا انقطاع منذ وفاتها. حينها، في عام ١٩٧٧، كان من المبالغة وصفها بأنها أبرز كاتبة معاصرة في بلدها. أما اليوم، وبعد أن اندثر هذا السحر، فقد أصبحت المسائل ذات الأهمية الفنية، إلى حد ما، غير ذات صلة. ما يهم هو الحب الجذاب الذي تُلهمه في قلوب أولئك الذين يتأثرون بها. فبالنسبة لهم، تُعدّ قراءة كلاريس ليسبكتور إحدى أعظم التجارب العاطفية في حياتهم. لكن سحرها خطير. قال صديق لقارئ قبل عقود، مستخدمًا الاسم الوحيد الذي تُعرف به عالميًا: “كن حذرًا مع كلاريس. إنها ليست أدبًا، بل سحر”.
لطالما شكّلت الصلة بين الأدب والسحر جزءًا أساسيًا من أسطورة كلاريس. هذه الأسطورة، بدعمٍ قوي من الإنترنت، الذي يُحوّل الشائعات إلى حقائق بسحرٍ ساحر، اكتسبت تداعياتٍ هائلةً لدرجة أنها تُصنّف اليوم كفرعٍ ثانويٍّ من الأدب البرازيلي. يتداول الإنترنت بلا هوادة عملٌ أدبيٌّّ كاملٌ من الظلّ، يحاول عمومًا، ويفشل، في أن يبدو عميقًا، مفعمًا بالعاطفة. على الإنترنت أيضًا، اكتسبت كلاريس جسدًا ظلّيًا بعد وفاتها، حيث تُعاد باستمرارٍ صورُ الممثلات اللواتي يُجسّدنها بدلًا من الأصل.
إذا كانت التكنولوجيا قد غيّرت أشكالها، فإنّ الأساطير نفسها ليست بالأمر الجديد. اشتهرت كلاريس ليسبكتور عندما نشرت، في نهاية عام ١٩٤٣، روايتها “بالقرب من القلب الجامح”. كانت طالبة، بالكاد تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا، من عائلة مهاجرة فقيرة. كان لروايتها الأولى تأثيرٌ هائلٌ لدرجة أن أحد الصحفيين كتب: “لا نذكر روايةً أولى أكثر إثارةً من هذه، رفعت اسمًا إلى هذه الشهرة، كان مجهولًا تمامًا حتى وقت قريب”. ولكن بعد أسابيع قليلة فقط من شهرة هذا الاسم، غادرت ريو مع زوجها، الدبلوماسي. عاشا في الخارج لما يقرب من عقدين من الزمن.
رغم زياراتها المنتظمة لوطنها، إلا أنها لم تعد إليه نهائيًا إلا عام ١٩٥٩. في تلك الفترة، ازدهرت الأساطير. أصبح اسمها الأجنبي الغريب موضع تكهنات – أشار أحد النقاد إلى أنه قد يكون اسمًا مستعارًا – وتساءل آخرون عما إذا كانت رجلاً بالفعل. تعكس الأساطير مجتمعةً شعورًا بعدم الارتياح، وشعورًا بأنها كانت شيئًا مختلفًا عما تبدو عليه.
في قصصها الخمس والثمانين التي كتبتها، تستحضر كلاريس ليسبكتور، قبل كل شيء، الكاتبة نفسها. من أقدم قصصها، التي نُشرت في التاسعة عشرة من عمرها، إلى آخر قصة، التي وُجدت في شظايا متناثرة بعد وفاتها، نتتبع حياة من التجريب الفني من خلال مجموعة واسعة من الأساليب والتجارب. هذا الأدب ليس للجميع: حتى بعض البرازيليين المتعلمين للغاية قد حيروا من الحماسة الشبيهة بالطائفة التي تلهمها. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفهمونها غريزيًا، فإن حب شخص كلاريس ليسبكتور فوري ولا يمكن تفسيره. فنها يجعلنا نرغب في معرفة المرأة؛ إنها امرأة تجعلنا نرغب في معرفة فنها. من خلال قصصها يمكننا تتبع حياتها الفنية، من وعد المراهقة إلى النضج المؤكد إلى الانفجار الداخلي عندما تقترب من الموت – وتستدعيه.
لكن شيئًا أكثر إثارة للدهشة يظهر عندما تُرى هذه القصص أخيرًا بكاملها، وهو إنجاز لم تكن الكاتبة نفسها على دراية بأهميته، لأنه لا يمكن أن يظهر إلا بأثر رجعي. يكمن هذا الإنجاز في المرأة الثانية التي تستحضرها. كانت كلاريس ليسبكتور فنانة عظيمة؛ وكانت أيضًا زوجة وأمًا من الطبقة المتوسطة. وإذا كانت صورة الفنانة الاستثنائية آسرة، فكذلك صورة ربة المنزل العادية، التي تُعتبر حياتها موضوع قصصها. ومع نضوج الفنانة، تكبر ربة المنزل أيضًا. عندما تكون ليسبكتور مراهقة متمردة مليئة بإحساس بإمكانياتها الخاصة – الفنية والفكرية والجنسية – كذلك تكون الفتيات في قصصها. عندما يحل الزواج والأمومة محل الطفولة المبكرة في حياتها، تكبر شخصياتها أيضًا. عندما يفشل زواجها، وعندما يغادر أطفالها، تظهر هذه الرحيلات في قصصها. عندما ترى الكاتبة، التي كانت ذات يوم جميلة بشكل رائع، جسدها مشوهًا بالتجاعيد والدهون، ترى شخصياتها نفس التدهور في أجسادهن؛ وعندما تواجه الانهيار النهائي للشيخوخة والمرض والموت، فإنها تظهر في قصصها أيضًا.
هذا سجلٌّ لحياة امرأة كاملة، كُتب على مدار حياتها. وبالتالي، يبدو أنه أول سجلٍّ شاملٍ من هذا القبيل يُكتب في رواية، بأي لغة. هذا الادعاء الشامل يتطلب مؤهلات. زوجة وأم؛ حياة امرأة برجوازية غربية مغايرة جنسياً. امرأة لم تُقاطع: امرأة لم تبدأ الكتابة متأخرةً، أو تتوقف للزواج أو الإنجاب، أو تستسلم للمخدرات أو تنتحر. امرأة، كغيرها من الكُتّاب الذكور، بدأت في سن المراهقة واستمرت حتى النهاية. امرأة، من حيث التركيبة السكانية، تشبه تمامًا معظم قرّائها.
لم تُكتب قصتهن إلا جزئيًا. قبل كلاريس، كانت امرأة كتبت طوال حياتها عن تلك الحياة نادرةً لدرجة أنها لم تُسمع بها من قبل. يبدو هذا الادعاء مُبالغًا فيه، لكنني لم أعثر على أي أسلاف لها.
المؤهلات مهمة، ولكن حتى عند إسقاطها، من المدهش إدراك مدى قلة النساء اللاتي تمكنّ من إنتاج مثل هذه الأعمال الكاملة. والنساء اللاتي فعلن ذلك هن بالتحديد أولئك اللاتي تم إعفاؤهن من العقبات التي منعت معظم النساء من الكتابة. هذه هي العوائق التي أشارت إليها تيلي أولسن في مقالها الشهير عام 1962، “الصمت في الأدب”، العوائق التي أدت إلى أن تشكل النساء، حسب حساب أولسن، “واحدة من كل اثنتي عشرة” كاتبة في القرن العشرين. كتبت أولسن: “في قرننا كما في القرن الماضي، جاءت جميع الإنجازات المتميزة تقريبًا من النساء اللواتي ليس لديهن أطفال”. كانت إديث وارتون بعيدة كل البعد عن الطبقة المتوسطة؛ بالكاد عاشت كوليت، أو كتبت عن، حياة برجوازية تقليدية. أما الآخرون – غابرييلا ميسترال، وجيرترود شتاين – فقد كان لديهم، مثل العديد من الكُتّاب الرجال، زوجاتهن.
كانت كلاريس ليسبكتور، كما توضح قصصها، مُلِمَّةً بهذه الحواجز عن كثب. تُكافح شخصياتها ضد المفاهيم الأيديولوجية حول دور المرأة المناسب؛ وتُواجه تشابكات عملية مع الأزواج والأطفال؛ وتُقلق بشأن المال؛ وتُواجه اليأس الشخصي الذي يُفضي إلى الشرب أو الجنون أو الانتحار. ومثل العديد من الكاتبات في كل مكان، تجاهلها الناشرون، بشكلٍ مُؤلم، لسنوات؛ ووُضِعت باستمرار في فئة مُنفصلة (أدنى) من قِبَل النقاد والباحثين. (مع ذلك، أصرت على ذلك، مُعلِّقةً ذات مرة أنها لا تُحب مُقارنتها بفيرجينيا وولف لأن وولف قد استسلمت: “الواجب المُرهِق هو الذهاب إلى النهاية”).
لكن تعاطفها مع النساء الصامتات والمُكتمات يُلازم هذه القصص. القصص الأولى، التي كُتبت في مراهقتها وأوائل العشرينيات من عمرها، غالبًا ما تُصوّر فتاةً قلقةً في صراع مع رجل، كما في قصة “جيمي وأنا”:
إذا كانت هؤلاء النساء يُسحقن أحيانًا أمام رجالٍ مهيبين وجذابين، فإنهن يزدادن ثقةً بالنفس مع تقدم الكاتبة في العمر. لكن هذا نوعٌ مختلف من الثقة بالنفس. فالنسوية الصاخبة التي سادت سنوات دراسة كلاريس تفسح المجال لشيءٍ أقل صراحةً، وتتوقف الشخصيات عن التباهي بأفكار “الحرية والمساواة للمرأة”. إنهن ببساطة يعشن حياتهن بأقصى ما يمكنهن من كرامة. في الفن كما في الحياة، هذا ليس دائمًا كثيرًا.
كثيرون صامتون. الجدة في “عيد ميلاد سعيد” تُمعن النظر في تفاهات الحياة التي ولّدتها باشمئزازٍ لا يوصف. القزم الكونغولي في “أصغر امرأة في العالم” لا يجد كلماتٍ للتعبير عن حبه. الدجاجة في “دجاجة” لا تجد كلماتٍ لتقول إنها على وشك الولادة، وبالتالي لا يمكن قتلها. في “الخاطئة المحروقة والملائكة المنسجمة”، لا تنطق زانيةٌ بكلمةٍ واحدة، وفي النهاية تُحرق كساحرة. عند الإعدام، يُنبّه زوجها الحشد قائلاً: “احذروا المرأة التي تحلم”.
كانت كلاريس في التاسعة من عمرها عندما طرحت فرجينيا وولف سؤالاً اقتبسته لاحقًا: “من ذا الذي سيقيس حرارة قلب الشاعر وعنفه وهو عالق في جسد امرأة؟” اعتقدت وولف أن هذا السؤال ينطبق على نساء عصرها بقدر ما ينطبق على نساء عصر شكسبير. كيف نجحت كلاريس ليسبكتور – من بين جميع الناس – في زمنٍ أُسكتت فيه أصوات الكثيرات من النساء؟
وُلدت في العاشر من ديسمبر عام ١٩٢٠ لعائلة يهودية في غرب أوكرانيا. كان ذلك زمنًا من الفوضى والمجاعة والحرب العرقية. قُتل جدها، واغتُصبت والدتها، ونُفي والدها مُفلسًا إلى الجانب الآخر من العالم. جرف البحر بقايا العائلة الممزقة إلى شمال شرق البرازيل عام ١٩٢٢. هناك، تمكّن والدها اللامع، الذي انحدر إلى بائع الخرق، بالكاد من إطعام أسرته؛ وهناك، عندما لم تكن كلاريس قد بلغت التاسعة من عمرها، توفيت والدتها متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها خلال الحرب.
كتبت شقيقتها إليسا أن والدها الليبرالي، الذي أحبطت معاداة السامية رغبته في الدراسة، “كان مصممًا على أن يُظهر للعالم أي نوع من البنات لديه”. وبتشجيعه، واصلت كلاريس تعليمها متجاوزةً المستوى الذي يسمح به حتى للفتيات الأكثر حظًا. بعد عامين فقط من وصولها إلى العاصمة، التحقت كلاريس بأحد معاقل النخبة، كلية الحقوق الوطنية بجامعة البرازيل. في كلية الحقوق، كان عدد اليهود (صفر) أقل من عدد النساء (ثلاث).
لم تترك دراستها للقانون أثرًا يُذكر. كانت قد بدأت بالفعل مسيرتها المهنية في غرف الأخبار بالعاصمة، حيث ترك جمالها وتألقها انطباعًا مبهرًا. كتب رئيسها أنها كانت “فتاة ذكية، ومراسلة ممتازة، وعلى عكس معظم النساء، تعرف بالفعل كيف تكتب”. في 25 مايو 1940، نشرت أقدم قصة معروفة لها، “الانتصار”. بعد ثلاثة أشهر، وفي سن الخامسة والخمسين، توفي والدها. قبل عيد ميلادها العشرين، كانت كلاريس يتيمة. في عام 1943، تزوجت من رجل كاثوليكي – وهو أمر غير معتاد في ذلك الوقت بالنسبة لفتاة يهودية في البرازيل. في نهاية ذلك العام، بعد وقت قصير من نشر روايتها الأولى، غادر الزوجان ريو. في وقت قصير، لم تترك عائلتها ومجتمعها العرقي وبلدها فحسب، بل تركت أيضًا مهنتها، الصحافة، التي كانت تتمتع فيها بسمعة مزدهرة.
وجدت المنفى لا يُطاق، وخلال السنوات الخمس عشرة التي قضتها في الخارج ازدادت حدة ميلها للاكتئاب. ولكن، على الرغم من مساوئه، ربما يُفسر المنفى – سلسلة المنافي هذه – كيف نجحت في الكتابة. جعلتها خلفيتها المهاجرة أقل تأثرًا بالأفكار السائدة في المجتمع البرازيلي. ومن الناحية المالية البحتة، كان زواجها خطوةً للأمام. لم تكن غنيةً قط، ولكن طالما كانت متزوجة، لم تكن مضطرةً للعمل في أي شيء سوى الكتابة. كان لديها طفلان، لكنها كانت تحصل أيضًا على مساعدة بدوام كامل. هذا يعني ساعات فراغ كل يوم: غرفة خاصة بها.
بالطبع، سبق أن كُتب عن مواضيع “أنثوية” تقليدية – الزواج والأمومة، والأطفال والملابس. ولكن هل سبق لأي كاتب أن وصف امرأة في السابعة والسبعين من عمرها تحلم بممارسة الجنس مع نجم بوب، أو امرأة في الحادية والثمانين تمارس العادة السرية؟ بعد نصف قرن أو أكثر من كتابتها، لم تفقد العديد من قصص كلاريس، التي قُرئت في عصر مختلف تمامًا، أيًا من حداثتها.
المواضيع الجديدة تتطلب لغة جديدة. يُمكن إرجاع جزء من قواعد كلاريس الغريبة إلى التأثير القوي للتصوف اليهودي الذي عرّفها عليه والدها. لكن جزءًا آخر من غرابتها يُعزى إلى حاجتها إلى ابتكار تقليد. وكما سيلاحظ أي شخص يقرأ قصصها من البداية إلى النهاية، فإنها مُشبعة ببحث لغوي متواصل، وعدم استقرار لغوي، يمنع قراءتها بسرعة كبيرة.
غالبًا ما يتعثر القارئ – ناهيك عن المترجم – في أنماطها شبه التكعيبية. في بعض القصص المتأخرة، تكون الصعوبات واضحة. لكن العديد من إعادة ترتيب كلاريس دقيقة، ويسهل إغفالها. في “الحب”، على سبيل المثال، نقرأ: “كانوا يكبرون، يستحمون، يطالبون بأنفسهم، ويتصرفون بشكل سيء، لحظات أكثر اكتمالًا”. الجملة، مثل العديد من جمل كلاريس، تبدو منطقية إذا قُرئت بنظرة سريعة – ثم، عند إعادة النظر فيها، ببطء، تبدأ في التلاشي. في “عيد ميلاد سعيد”، وسط احتفال محرج، ينطق طفل بوقفة صمت محرجة: “أمهم، فاصلة!”
في كتابي “لماذا هذا العالم”، سيرة كلاريس الذاتية، بحثتُ في جذورها في التصوف اليهودي والدافع الروحي الجوهري الذي ألهم أعمالها. وكما وجد الكاباليون الألوهية بإعادة ترتيب الحروف، وتكرار الكلمات غير المنطقية، وتحليل الآيات، والبحث عن منطق غير العقلاني، كذلك فعلت هي. مع بعض الاستثناءات، فإن هذه الصفة الصوفية، التي قد تجعل نثرها شبه تجريدي، أقل وضوحًا في قصصها منها في روايات مثل “آلام المسيح” أو “التفاحة في الظلام”. لكن النظر إلى كتابات كلاريس ككل يُفهم الصلة الوثيقة بين اهتمامها باللغة واهتمامها بما أسمته – لعدم وجود كلمة أفضل – الله.
في قصصها، يتفجر الإلهام الإلهي من تحت وطأة الحياة اليومية المُعتنى بها بعناية. كتبت في إحدى القصص: “لقد أجادت تهدئة الحياة، وحرصت على ألا تنفجر”. وعندما تأتي الانفجارات الحتمية، تُنذر بها تغيرات في قواعد اللغة قبل وقت طويل من ظهورها في الحبكة. لورا، ربة المنزل المملة التي ليس لديها أطفال في “تقليد الوردة”، لديها “ذوق دقيق في المنهج” – إلى أن بدأت، بينما كانت تفكر في كيفية شرح نفسها لصديقتها كارلوتا، تتراجع قواعدها.
يمكن أن تكون هذه الإشارات أكثر إيجازًا، كما في قصة “الآلام بحسب GH”، عندما تروي ربة منزل أخرى الصدمة الغامضة التي تعرضت لها في اليوم السابق. تتذكر نفسها كما كانت آنذاك، فتقول GH: “لقد نهضت أخيرًا من على مائدة الإفطار، تلك المرأة”. يُستأنف التحول الموصوف في الرواية – من ذلك الحين إلى الآن، ومن الأمس إلى اليوم، ومن هي إليّ، ومن ضمير المتكلم إلى الغائب – بأسلوب أناكولوثون منعش، حيث يرمز الخلل النحوي تمامًا إلى الخلل في حياة هذه المرأة. ومثل العديد من أفضل عبارات كلاريس، فهي أنيقة تحديدًا لأنها تتجاهل الأعراف المتكلفة التي تُشكل أناقة الأدب الجميل .
كتبت: “في الرسم، كما في الموسيقى والأدب، غالبًا ما يبدو لي ما يُسمى تجريديًا مجازًا لواقع أكثر دقةً وصعوبةً، وأقل وضوحًا للعين المجردة”. وبينما سعى الرسامون التجريديون إلى تصوير الحالات العقلية والعاطفية دون تمثيل مباشر، ووسّع الملحنون المعاصرون قوانين التناغم التقليدية، ألغت كلاريس الأنماط الانعكاسية في قواعد اللغة. وكثيرًا ما اضطرت إلى تذكير القراء بأن كلامها “الأجنبي” لم يكن نتيجة ولادتها الأوروبية أو جهلها باللغة البرتغالية.
ولا داعي للقول إن النساء يُظهرن أنفسهن بشكل لائق. بصفتها كاتبة أزياء محترفة، استمتعت بمظهر شخصياتها. ثم أشعثت فساتينهن، ولطخت ماسكاراهن، وعبثت بشعرهن، وسحرت وجوههن الجميلة بسحرٍ مُخيف وصفه السير والتر سكوت. بكلماتٍ مُقلوبة، استحضرت عالمًا مجهولًا بالكامل – واستحضرت أيضًا كلاريس ليسبكتور التي لا تُنسى: تشيخوف أنثى على شواطئ غوانابارا.
تنبيه:
هذه المقالة مُقتبسة من مقدمة كتاب “القصص الكاملة” للكاتبة كلاريس ليسبكتور، الصادر في أغسطس عن دار نشر نيو دايركشنز. بنجامين موسر هو محرر سلسلة ترجمات ليسبكتور الصادرة عن دار نشر نيو دايركشنز