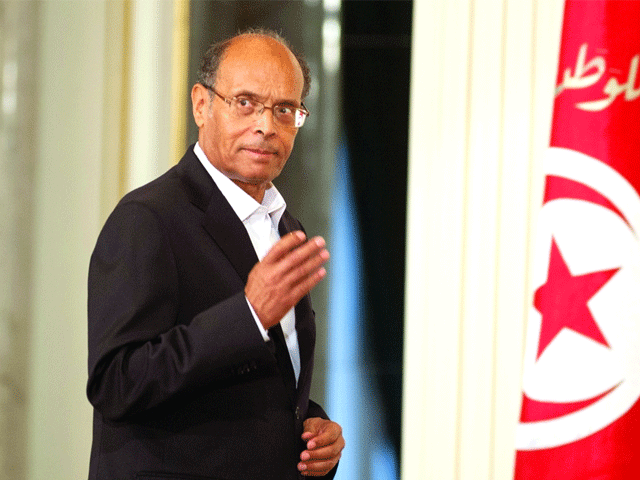المفكر المغربي عز الدين الخطابي: لاجدوى من الاعتقاد بإمكانية عقد صلة متكاملة مع المعرفة العربية القديمة

الأمر جد واضح بالنسبة للمفكر المغربي عز الدين الخطابي، فالتنوير يشترط نقدا فعالا لكل الأنظمة التي ترسِّم نفسها وصيا على العقل البشري و حريته ملزمة إياه بأشكال عنيفة من الدوغما. إن التنوير يستلزم بلورة منظومة سياسية و فكرية تصرف مفاهيم الحرية و المساواة و التسامح في الحياة العامة وتجعلها مرجعا منظما لحياة الافراد داخل المجتمع. وبقدرما تتضخم الرؤية اللاهوتية للعالم و السياسة بقدر ما تتراجع إمكانيات التغيير الإيجابي و تعرقل عملية التحديث السياسي.. إن درجة تحرر الأفراد هي المقياس الحقيقي لمدى استيعابنا لفكرة التقدم التاريخي.. في حوارنا معه يحلل المفكر المغربي عز الدين الخطابي هذه الأفكار، و هو الذي انشغل عبر تراكم مهم يتكون من مجموعة من الأعمال الفكرية من دراسات و ترجمات، بفتح منافذ متعددة لمساءلة البنى الفكرية للمجتمع و الأنظمة الثقافية المتحكمة فيه ، مقترحا بذلك حوارا عميقا بين الثقافة العربية و المتن الفلسفي الكوني.
حصل الدكتور عز الدين الخطابي على جائزة الكتاب لسنة 2012 ، و منحته جدية أعماله انتشارا أكبر على مستوى فضاءات النشر في بلدان الشرق العربي التي تستقطب خلاصات أبحاثه و دراساتها إلى صفحاتها . يصر على أن الفكر فعالية تخترق البنى الجامدة ، لذلك لم تقتصر أعماله على الفلسفة بل شملت السوسيولوجيا و الانثروبولجيا و الفن و التربية …
– يبدو أن التنوير يمثل تحديا حضاريا أمامنا اليوم
بكل تأكيد، خصوصا إذا ما انطلقنا من المبادئ الأساسية لفكر التنوير، المتمثلة في استقلالية العقل ورفض الأحكام المسبقة التي تدعي امتلاك سلطة ما وبلورة منظومة فكرية/سياسية تقوم على مفاهيم الحرية والتسامح والمساواة وفكرة التقدم المبنية على أساس فهم تاريخي لتطور المجتمعات.
فنحن في حاجة إلى تفعيل هذه المبادئ لكي يكون لنا موقع في الحضارة المعاصرة ولكي نواجه كل عوامل النكوص والتخلف التي تريد العودة بالمجتمع إلى الوراء. وأريد التأكيد بالخصوص على فكرة التقدم التي ارتبطت لدى مفكري الأنوار (كوندورسي، كوندياك، كانط .. الخ) بالحرية وبالدفاع عن حقوق الإنسان الطبيعية والمدنية.
ـ ماهي المهام التي تندرج تحت مطلب التنوير اليوم ؟ هل هي رفع الوصاية على العقل البشري كما قال كانط و الخروج بالإنسانية من حالة القصور ؟ أم إرساء علاقة نقدية بالذات ؟ أم بناء تصور تحرري للإنسان ؟
تندرج هذه المهام جميعها تحت مطلب التنوير، وهو ما تلخصه هذه العبارة الوجيزة للفيلسوف الألماني كانط في نصه الشهير: “الجواب عن السؤال ما التنوير؟” والتي جاء فيها: “إن الاستعمال العام لعقلنا يجب أن يكون حرا على الدوام، وهو وحده القادر على أن يوصل الأنوار إلى الناس”.
فهناك ارتباط بين استعمال العقل والحرية وهذا شرط ضروري لقيام الوعي المتنور الذي يروم تحرير الإنسان من الاعتقادات الدوغمائية والمتحجرة. فالعقل هو وسيلة الإنسان لممارسة النقد والدفع به لكي يعبر عن إرادته في المعرفة وفي اتخاذ المبادرة. وكما أكد كانط أيضا، فإن الميل نحو التفكير الحر يؤثر على عقلية الشعب، مما يجعله قادرا على ممارسة حريته “كما يؤثر على مبادئ الحكم ذاتها والتي من مصلحتها معاملة الإنسان وفق كرامته”.
-كيف يمكن أن نتصور اشتغالا سياسيا لمفعول التنوير ؟ هل بتحصين المجال السياسي من الالتباس بالحقل الديني؟ أم بالفصل بين المجال العمومي والمجال الخاص؟ أم بجعل الدولة راعيا رسميا للتنوير؟
يطرح هذا السؤال قضية هامة متعلقة بالحداثة السياسية. ومعلوم أن ظهور هذه الأخيرة بالغرب (حوالي القرن 16 تقريبا) اقترن بتطور النزعات العقلانية والتجريبية والإنسية والتنويرية عموما وبتراجع التصورات اللاهوتية للعالم وللسياسة. وقد ركزت الحداثة السياسية على مواجهة السلطة المطلقة القائمة على نظرية الحق الإلهي وأضفت طابعا تاريخيا وإنسانيا على الدولة وعلى الحكم المدني. وبذلك بحثت عن المنطق الخاص لما هو سياسي في استقلال عن المقولات اللاهوتية والأخلاقية، معتمدة على مقولات فلسفية مثل حرية التفكير والاعتقاد وعلاقة الحق الطبيعي بالحق المدني والمساواة والعدالة كغايات لنظام الدولة.
لذلك نعتقد بأنه ينبغي تمييز المجال السياسي عن المجال الديني، واعتبار الدولة مؤسسة سياسية هدفها رعاية الحقوق الطبيعية والمدنية للأفراد، وإقامة تمييز واضح بين المجال العمومي وهو مجال السلطة السياسية والصراع من أجلها والمجال الخصوصي المتعلق بمصالح الفرد المادية والمعنوية. فضبط العلاقة بين هذين المجالين هو الذي سيسمح بتفعيل مفاهيم مركزية في الشأن السياسي، مثل التعاقد والميثاق والحق والإنصاف والعدالة. وهي مفاهيم معارضة تماما للتصورات اللاهوتية التي سعت دوما إلى جعل السلطة السياسية حقا مطلقا لهذا الشخص أو لتلك الفئة.
-في المجتمعات العربية، يمثل تقديس النص، وتحويله إلى مرجع للوجود، عقبة اساسية في وجه التنوير، هل ترون أن اقتحام هذه العقبة شرط اساسي لتدشين مشروع التنوير ؟
لا شك في أن مفهوم التقديس يتعارض مع مفهوم التنوير. فتقديس النص في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وتحويله إلى مرجع وحيد بالنسبة للوجود الاجتماعي والثقافي والسياسي ، يشكل عائقا أمام إمكانية التغيير. لذلك يلزم مشروع التنوير القيام بنقد فعال لكل أشكال الجمود والدوغمائية والنكوصية التي تختفي وراء “قدسية” النصوص، وذلك عبر تأويل ثقافتنا التقليدية لكي تكون قادرة على استيعاب التحولات الفكرية والتقنية التي يعرفها العالم المتقدم. وهذا ما أدعوه بالمنظور الديناميكي لعلاقة التقليد بالحداثة، والذي يقتضي القيام بنقد مزدوج، حسب تعبير الراحل عبد الكبير الخطيبي، تجاه الذات وتجاه الآخر (الغرب) كشرط أساسي لإبراز التباينات والاختلافات الثقافية في إطار ما يعرف بجدلية الخصوصية والكونية أو الهوية والاختلاف. وتحضرني هذه القولة الجميلة للخطيبي في مؤلفه النقد المزدوج (ص. 163) والتي جاء فيها: “إننا نريد التاريخ بصفته ممارسة نقدية لما يحدد وجودنا هنا والآن. وإذا حررنا مشكلة التاريخ، فمعنى ذلك أننا سنزعزع دعائم النظام المسيطر للمعرفة الحالية. ومن المعلوم أن لا فائدة من المرور ثانية بطريقة أو بأخرى، بكل المراحل التي يمر بها الفكر الغربي. كذلك لاجدوى من الاعتقاد بإمكانية عقد صلة متكاملة مع المعرفة العربية القديمة.
-هل توافقون تودوروف في رأيه الذي عبر عنه في كتابه ” روح الأنوار ” و الذي يقول أن التنوير مهمة لا نهاية لها ؟
تذكرنا هذه القولة بعبارة شهيرة للمفكر الألماني يورغن هابرماس جاء فيها أن “الحداثة مشروع لم يكتمل بعد” (وهذا عنوان مداخلة ألقاها في شتنبر 1980 بمناسبة تسلمه جائزة أدورنو). فالأمر يتعلق بسيرورة دائمة لا يمكنها أن تتوقف، لأنها مرتبطة بفعالية الإنسان. وهو ما دعاه مفكرو الأنوار بالتقدم المقترن بالتنوير التدريجي، كما تم ربطه بخاصية أساسية مميزة للإنسانية، وهي قابليتها للاكتمال وحتمية تطورها. فقد أظهر التاريخ بأن الإنسان تقدم في مسار اكتماله على مدى القرون وسيستمر على هذا النهج مستقبلا. لهذا اعتبر هؤلاء المفكرين بأن التاريخ هو نتاج للفعل الإنساني وليس لقوة غير مشخصة تتجلى في العالم. فالإنسان هو الذي يصنع التاريخ انطلاقا مما فعله ويفعله (في الحاضر) وسيقوم بإنجازه في المستقبل. لذلك يجب أن تتجه نظرة المؤرخ إلى المستقبل وليس إلى الماضي. وأبرز شيء ينبغي الاهتمام به باعتباره أثمن شيء في مسيرة الإنسان هو تاريخ التقدم، أي تاريخ التحرر التدريجي للعقل البشري وصراعه ضد القوى التي اضطهدته (وهي قوى الجهل والأحكام المسبقة والاستبداد)، واكتساب الإنسان التدريجي للأنوار، أي لحريته داخل نظام الحق من أجل بناء مستقبل قائم على الحرية والعدالة والمساواة.
– هل تعتقد أن التنمية بدون تنوير استراتيجية عمياء، أدت في المجتمعات العربية إلى نتائج كارثية؟
صحيح أن التنمية الاقتصادية بدون أسس فكرية تنويرية تظل مشوهة، لأنها تقترن بتدبير واستهلاك التقنية دون ربط هذا التدبير بالعقلانية التنظيمية في مختلف المجالات (الاجتماعية والسياسية والفكرية). وهو ما انتبه إليه المفكر الراحل محمد أركون في نص له حول الإسلام والحداثة، عندما أكد على غياب الحداثة كعقلنة متحكمة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل الساحة العربية التي اكتفت باستيراد المخترعات الغربية الاستهلاكية وبإجراء تحديث شكلي أو خارجي لايوافقه أي تغير جذري في موقف العربي والمسلم من الكون والإنسان.
وبذلك ظلت الساحة المذكورة خاضعة عموما لهيمنة المواقف النكوصية المناهضة لكل تنوير فعلي رغم المظاهر التحديثية البراقة القائمة هنا وهناك. والنتيجة هي أننا نعاين إجراءات تحديثية على مستوى الأجهزة الإدارية والسياسية والتربوية والاقتصادية، لكن بمعزل عن التنوير الفكري والعقلي الذي يعتبر مدخلا للوعي بالحداثة وبضرورتها لتحقيق التقدم ومواكبة تحديات العصر.
– من أي مدخل يمكن تدشين أفق عربي للتنوير، هل من الدين أم الفن أم الفلسفة ؟
أعتقد أن المدخل الأساسي للتنوير هو المدخل الفكري، فمن خلاله يمكن أن يتجلى الفعل التنويري في مختلف المجالات، السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. وهذه هي الأطروحة المركزية لفلسفة التنوير التي أقرت بسيادة الإنسان على الطبيعة وعلى المجتمع انطلاقا من العقل، فمن خلاله تتم معالجة قضايا الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. لأن المطلوب هو الوعي بالزمن الحاضر وبكونه منتظما وفق قوانين عقلانية ومعقولة. ونحن نعلم بأن انبثاق العالم الحديث الذي شبهه الفيلسوف الألماني هيجل “بالشروق الرائع للشمس”، اقترن بانتشار العقلنة في كل دوائر الحياة الاجتماعية، أي في الإدارة والسياسة والاقتصاد والقانون. وبدون تنوير عقلي قائم على النقد لن يتم تجاوز التصورات العتيقة والمتسمة بالقداسة. فنحن في حاجة إلى حرية عقلية نقدية تسمح ينزع الطابع السحري والوهمي عن العالم وبمأسسة كافة مناحي الحياة والممارسات الاجتماعية، مما يفسح المجال أمام معايير عقلانية للفعل والسلوك وأمام قيم الحرية والاختيار والاختلاف. وهذا شرط أساسي لخروج مجتمعنا من دائرة التخلف والقصور.